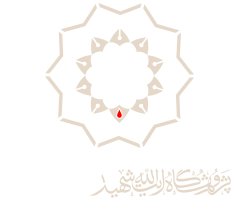على نسبة معيّنة. والنظرية القائلة: بأنّ مردّ اختلاف الأجسام في سرعة سقوطها إلى مقاومة الهواء، لا إلى اختلاف كتلتها، التي ولدت كحدس علمي، ثمّ استطاع العلم أن يوضّح صدقها بالتجارب التي اجريت على الأجسام المتنوّعة في مكان خالٍ من الهواء، فدلّت على أ نّها تشترك جميعاً في درجة معيّنة من السرعة. أقول:
إنّ هذه النظريات وآلاف النظريات الاخرى التي مرّت كلّها بالمرحلة التي أشرنا إليها من التطوّر، باجتيازها درجة الفرضية إلى درجة القانون، لا تعبّر في اجتيازها وتطوّرها هذا عن نموّ في نفس الحقيقة، بل عن الاختلاف في درجة التصديق العلمي بها. فالفكرة هي الفكرة، غير أ نّها نجحت في الامتحان العلمي، وانكشف لذلك أ نّها حقيقة، بعد أن كان مشكوكاً فيها.
ثمّ إنّ هذه النظرية بعد أن تحتلّ موضعها من القوانين العلمية، تأخذ مجالها في التطبيق، وتكسب صفتها كمرجع علمي لتفسير ظواهر الطبيعة التي تبدو لدى المشاهدة أو التجربة، واستكشاف حقائق وأسرار جديدة. ومهما استطاعت أن تستكشف مزيداً من الحقائق المجهولة، ثمّ تؤكّد التجربة بعد ذلك صحّة استكشافها، ازدادت رسوخاً ووضوحاً في الذهنية العلمية. ولذلك عُدّ من الانتصارات الكبرى لقانون الجاذبية العامّة، أن استكشف العلماء كوكب (نبتون) على ضوء قانون الجاذبية ومعادلاته الرياضية، ثمّ أيّدت وجوده المشاهدات العلمية بعدئذٍ. وهذا- أيضاً- ليس إلّالوناً من ألوان شدّة الوثوق العلمي بصحّة النظرية وصوابها.
ثمّ إن حالف التوفيق النظرية في المجال العلمي على طول الخطّ، ثبتت نهائياً. وأمّا إذا بدأت تضيق عن الانطباق على الواقع المدروس علمياً، بعد تدقيق الأجهزة والوسائل، وتعميق الملاحظة والفحص، فتبدأ النظرية عند ذاك مرحلة التعديل والتجديد، وفي هذه المرحلة قد تضطرّ المشاهدات والتجارب الجديدة