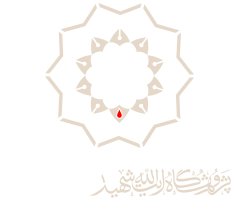الذاتيّة التي تنبع منها المشكلة الاجتماعيّة الكبرى في حياة الإنسان (مشكلة التناقض بين تلك الدوافع والمصالح الحقيقيّة العامّة للمجتمع الإنساني). وهي من ناحية اخرى تُزوّد الإنسان بإمكانيّة حلّ المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التديّن، وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الذي يوفّق بين المصالح العامّة والدوافع الذاتيّة. وبهذا أتمّت الفطرة وظيفتها في هداية الإنسان إلى كماله، فلو بقيت تثير المشكلة ولا تموّن الطبيعة الإنسانيّة بحلّها لكان معنى هذا أنّ الكائن الإنساني يبقى قيد المشكلة، عاجزاً عن حلّها، مسوقاً بحكم فطرته إلى شرورها ومضاعفاتها. وهذا ما قرّره الإسلام بكلّ وضوح في قوله تعالى:
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»[1].
فإنّ هذه الآية الكريمة تقرّر:
أوّلًا: أنّ الدين من شؤون الفطرة الإنسانيّة التي فُطر الناس عليها جميعاً، ولا تبديل لخلق اللَّه.
وثانياً: أنّ هذا الدين الذي فُطرت الإنسانيّة عليه ليس هو إلّاالدين الحنيف، أي دين التوحيد الخالص؛ لأنّ دين التوحيد هو وحده الذي يمكن أن يؤدّي وظيفة الدين الكبرى، ويوحّد البشريّة على مقياس عملي وتنظيم اجتماعي تحفظ فيه المصالح الاجتماعيّة، وأمّا أديان الشرك أو الأرباب المتفرّقة- على حدّ تعبير القرآن- فهي في الحقيقة نتيجة للمشكلة، فلا يمكن أن تكون علاجاً لها؛ لأ نّها كما قال يوسف لصاحبَي السجن: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماء
[1] سورة الروم: 30