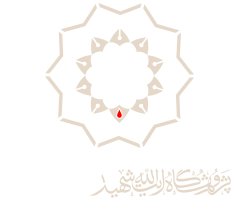المجتمع، وإنّما يحدّدها في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد، وعلى أساس من القِيَم الخُلُقيّة الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن تحقيق تلك القِيَم وإيجاد ذلك المثل، وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة.
وعمليّة التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تتّسع بطبيعة الحال للفئة الثالثة بوصفها جزءاً من المجتمع الإنساني الذي يجب أن توزّع فيه الثروة بشكل يقلّص آلام الحرمان إلى أبعد حدّ ممكن، تحقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع السعيد، وللقِيَم الخُلُقيّة التي يقيم الإسلام العلاقات الاجتماعيّة عليها. ويصبح من الطبيعي عندئذٍ أن تعتبر حاجة هذه الفئة المحرومة سبباً كافياً لحقّها في الحياة، وأداة من أدوات التوزيع: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»[1].
الحاجة في نظر الإسلام والرأسماليّة:
وأمّا الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام تماماً في موقفه من الحاجة، فإنّ الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابيّة للتوزيع، وإنّما هي أداة ذات صفة مناقضة ودور إيجابي معاكس لدورها في المجتمع الإسلامي، فهي كلّما اشتدّت عند الأفراد انخفض نصيبهم من التوزيع، حتّى يؤدّي الانخفاض في نهاية الأمر إلى انسحاب عدد كبير منهم عن مجال العمل والتوزيع. والسبب في ذلك: أنّ انتشار الحاجة وشدّتها يعني وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق الرأسماليّة تزيد عن الكمّية التي يطلبها أرباب الأعمال، ونظراً إلى أنّ الطاقة الإنسانيّة سلعة رأسماليّة تتحكّم في مصيرها قوانين العرض والطلب كما تتحكّم في سائر سلع السوق، فمن
[1] سورة المعارج: 24- 25