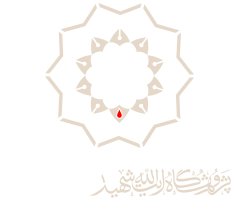سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ»[1]. .. يعني بذلك أ نّها وليدة الدوافع الذاتيّة التي أملت على الناس أديان الشرك طبقاً لمصالحهم الشخصيّة المختلفة؛ لتصرف بذلك ميلهم الطبيعي إلى الدين الحنيف تصريفاً غير طبيعي، وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة لميلهم الديني الأصيل.
وثالثاً: أنّ الدين الحنيف الذي فُطرت الإنسانيّة عليه يتميّز بكونه ديناً قيّماً على الحياة «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»، قادراً على التحكّم فيها وصياغتها في إطاره العامّ. وأمّا الدين الذي لا يتولّى إمامة الحياة وتوجيهها فهو لا يستطيع أن يستجيب استجابة كاملة للحاجة الفطريّة في الإنسان إلى الدين، ولا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسيّة في حياة الإنسان.
***
ونخلص من ذلك إلى عدّة مفاهيم للإسلام عن الدين والحياة:
فالمشكلة الأساسيّة في حياة الإنسان نابعة من الفطرة؛ لأنّها مشكلة الدوافع الذاتيّة في اختلافاتها وتناقضاتها مع المصالح العامّة.
والفطرة في نفس الوقت تموّن الإنسانيّة بالعلاج.
وليس هذا العلاج إلّاالدين الحنيف القيّم؛ لأنّه وحده القادر على التوفيق بين الدوافع الذاتيّة، وتوحيد مصالحها ومقاييسها العمليّة.
فلا بدّ للحياة الاجتماعيّة إذن من دين حنيف قيّم.
ولا بدّ للتنظيم الاجتماعي في مختلف شُعَب الحياة أن يوضع في إطار ذلك الدين القادر على التجاوب مع الفطرة ومعالجة المشكلة الأساسيّة في حياة الإنسان.
***
[1] سورة يوسف: 40