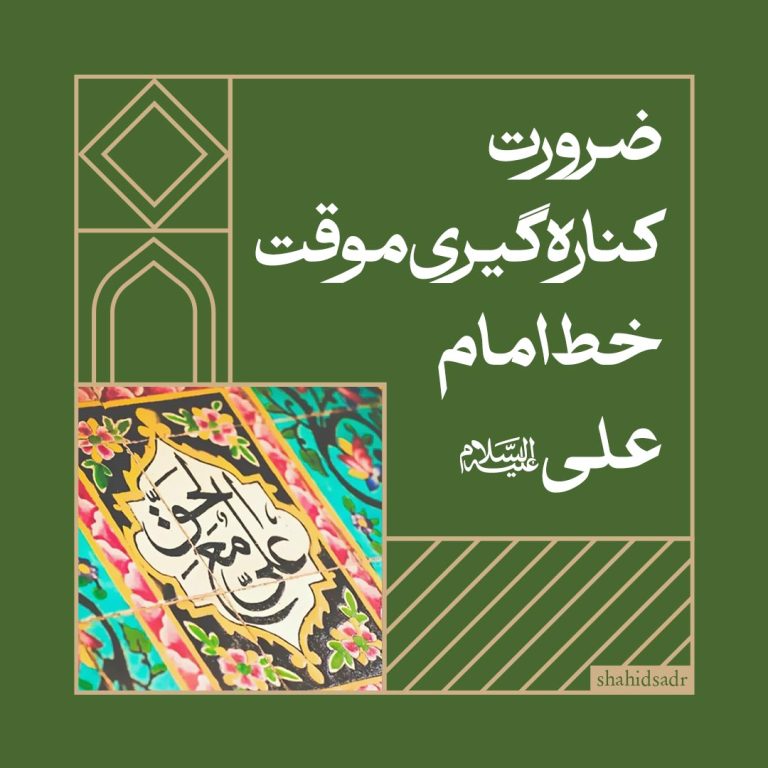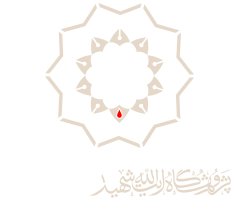وعلى هذا الضوء وضع (كانت) حدّاً فاصلًا بين (الشيء في ذاته) و (الشيء لذاتنا): فالشيء في ذاته هو: الواقع الخارجي دون أيّ إضافة من ذاتنا إليه. وهذا الواقع المجرّد عن الإضافة الذاتية لا يقبل المعرفة؛ لأنّ المعرفة ذاتية وعقلية في صورتها. والشيء لذاتنا هو: المزيج المركّب من الموضوع التجريبي، والصورة الفطرية القبلية التي تتّحد معه في الذهن. ولهذا تكون النسبية مفروضة على كلّ حقيقة تمثّل في إدراكاتنا للأشياء الخارجية، بمعنى: أنّ إدراكنا يدلّنا على حقيقة الشيء لذاتنا، لا على حقيقة الشيء في ذاته.
وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن العلوم الرياضية؛ فإنّ العلوم الرياضية لمّا كان موضوعها موجوداً في النفس بصورة فطرية، لم تقم فيها اثنينية بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا، وعلى عكس ذلك العلوم الطبيعية؛ فإنّها تتناول الظواهر الخارجية التي تقع عليها التجربة، وهي ظواهر موجودة بصورة مستقلّة عنّا، ونحن نعلمها في قوالبنا الفطرية، فلا غرو أن يفصل بين الشيء في ذاته والشيء لنا.
الثالثة- الميتافيزيقا. ويرى (كانت) استحالة التوصّل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظري، وأنّ أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي محاولة فاشلة ليست لها قيمة؛ وذلك أ نّه لا يصحّ في القضايا الميتافيزيقية شيء من الأحكام التركيبية الأوّلية والأحكام التركيبية الثانوية:
أمّا الأحكام التركيبية الأوّلية فهي لمّا كانت أحكاماً مستقلّة عن التجربة، فلا تصحّ إلّاعلى موضوعات مخلوقة للنفس بصورة فطرية وجاهزة في الذهن بلا تجربة، كموضوعي العلوم الرياضية من الزمان والمكان، وليست الأشياء التي تتناولها الميتافيزيقا- وهي اللَّه، والنفس، والعالم- كذلك؛ فإنّ الميتافيزيقا لا تعالج اموراً ذهنية، وإنّما تحاول البحث عن أشياء موضوعية قائمة في نفسها.