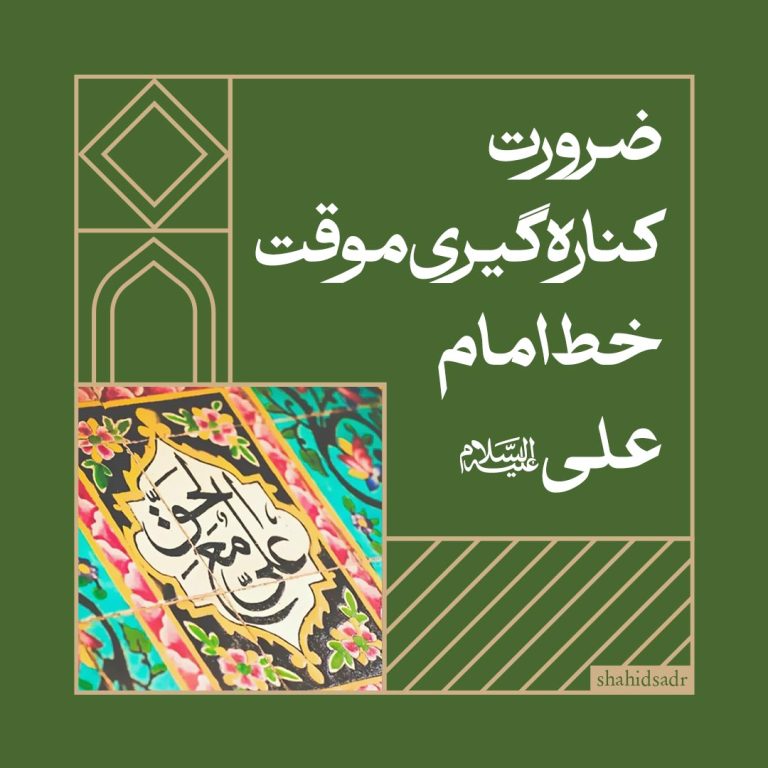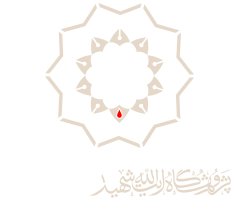والمبادئ الأوّلية بالنار وإحراقها، فكما أنّ إحراق النار فعّالية ذاتية للنار، ومع ذلك لا توجد هذه الفعّالية إلّافي ظلّ شروط، أي: في ظروف ملاقاة النار لجسم يابس، كذلك الأحكام الأوّلية فإنّها فعّاليات ضروريّة وذاتية للنفس في الظروف التي تكتمل عندها التصوّرات اللازمة.
وإذا أردنا أن نتكلّم على مستوىً أرفع قلنا: إنّ المعارف الأوّلية وإن كانت تحصل للإنسان بالتدريج، ولكن هذا التدريج ليس معناه أ نّها حصلت بسبب التجارب الخارجية؛ لأنّنا برهنّا على أنّ التجارب الخارجية لا يمكن أن تكون المصدر الأساسي للمعرفة، بل التدرّج إنّما هو باعتبار الحركة الجوهرية والتطوّر في النفس الإنسانية، فهذا التطوّر والتكامل الجوهري هو الذي يجعلها تزداد كمالًا ووعياً للمعلومات الأوّلية والمبادئ الأساسية، فيتفتّح ما كمن فيها من طاقات وقوىً.
وهكذا يتّضح: أنّ الاعتراض على المذهب العقلي بأ نّه: لماذا لم توجد المعلومات الأوّلية مع الإنسان حين ولادته، يبتني على عدم الاعتراف بالوجود بالقوّة، وباللاشعور الذي تدلّ عليه الذاكرة بكلّ وضوح، وإذن فالنفس الإنسانية بذاتها تنطوي بالقوّة على تلك المعارف الأوّلية، وبالحركة الجوهرية يزداد وجودها شدّة، حتّى تصبح تلك المدركات بالقوّة مدركات بالفعل.
الماركسية والتجربة:
إنّ المذهب التجريبي الذي عرضناه سابقاً يطلق على رأيين في مسألة المعرفة:
أحدهما الرأي القائل: بأنّ المعرفة كلّها تتوفّر في المرحلة الاولى، أي:
مرحلة الإحساسات والتجارب البسيطة.