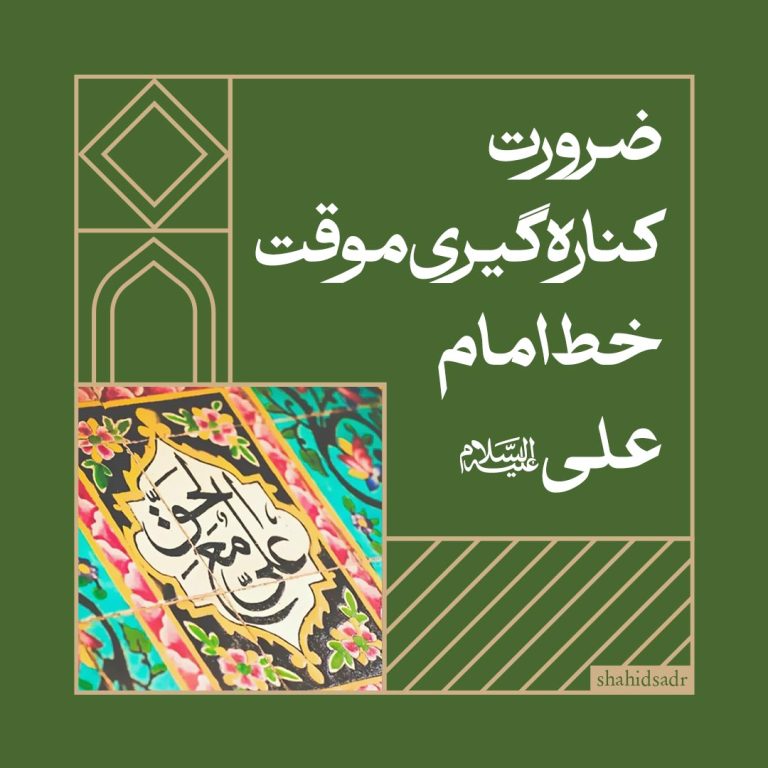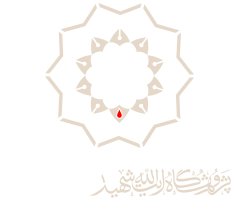ولأجل هذا كنّا نستطيع أن نصف الظروف الواقعية التي نعرف فيها صدق الكلام أو كذبه ما دام هناك فرق في العالم الواقعي بين أن تصدق القضية وبين أن تكذب.
ولكن خذ إليك العبارة الفلسفية التي تقول: (إنّ لكلّ شيء جوهراً غير معطياته الحسّية، فللتفاحة- مثلًا- جوهر هو التفّاحة في ذاتها فوق ما نحسّه منها بالبصر واللمس والذوق) فإنّك لن تجد فرقاً في الواقع الخارجي بين أن تصدق هذه العبارة أو تكذب، بدليل أ نّك إذا تصوّرت التفّاحة في حال وجود جوهر لها غير ما تدركه منها بحواسّك، ثمّ تصوّرتها في حال عدم وجود هذا الجوهر لم ترَ فرقاً في الصورتين؛ لأنّك سوف لن تجد في كلتا الصورتين إلّا المعطيات الحسّية من اللون والرائحة والنعومة. وما دمنا لم نجد في الصورة التي رسمناها لحال الصدق شيئاً يميّزها من الصورة التي رسمناها لحال الكذب، فالعبارة الفلسفية المذكورة كلام بدون معنىً؛ لأنّه لا يفيد خبراً عن العالم.
وكذلك الأمر في كلّ القضايا الفلسفية التي تعالج موضوعات ميتافيزيقية؛ فإنّها ليست كلاماً مفهوماً؛ لعدم توفّر الشرط الأساسي للكلام المفهوم فيها، وهو:
إمكان وصف الظروف التي يعرف فيها صدق القضية أو كذبها، ولذلك لا يصحّ أن توصف القضية الفلسفية بصدق أو كذب؛ لأنّ الصدق والكذب من صفات الكلام المفهوم، والقضية الفلسفية لا معنىً لها لكي تصدق أو تكذب.
ويمكننا تلخيص النعوت التي تضفيها المدرسة الوضعية على القضايا الفلسفية كما يلي:
1- لا يمكن إثبات القضية الفلسفية؛ لأنّها تعالج موضوعات خارجة عن حدود التجربة والخبرة الإنسانية.
2- ولا يمكن أن نصف الظروف التي إن صحّت كانت القضية صادقة وإلّا فهي كاذبة؛ إذ لا فرق في صورة الواقع بين أن تكذب القضية الفلسفية أو تصدق.