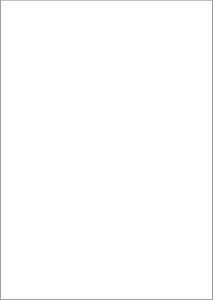بالمعلومات الثانوية.
والعملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة هي العملية التي نطلق عليها اسم الفكر والتفكير. فالتفكير: جهد يبذله العقل في سبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من معارفه السابقة. بمعنى: أنّ الإنسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضية (حدوث المادّة)- مثلًا- ليتأكّد من أ نّها حادثة أو قديمة يكون بين يديه أمران: أحدهما الصفة الخاصّة وهي (الحدوث)، والآخر الشيء الذي يريد أن يتحقّق من اتّصافه بتلك الصفة وهو (المادّة). ولمّا لم تكن القضية من الأوّليات العقلية، فالإنسان سوف يتردّد بطبيعته في إصدار الحكم والإذعان بحدوث المادّة، ويلجأ- حينئذٍ- إلى معارفه السابقة ليجد فيها ما يمكنه أن يركّز عليه حكمه، ويجعله واسطة للتعرّف على حدوث المادّة، وتبدأ بذلك عملية التفكير باستعراض المعلومات السابقة.
ولنفترض أنّ من جملة تلك الحقائق التي كان يعرفها المفكّر سلفاً هي (الحركة الجوهرية) التي تقرِّر أنّ المادّة حركة مستمرّة وتجدّد دائم، فإنّ الذهن سيضع يده على هذه الحقيقة حينما تمرّ أمامه في الاستعراض الفكري، ويجعلها همزة الوصل بين المادّة والحدوث؛ لأنّ المادّة لمّا كانت متجدّدة فهي حادثة حتماً؛ لأنّ التغيّر المستمرّ يعني: الحدوث على طول الخطّ، وتتولّد- عندئذٍ- معرفة جديدة للإنسان، وهي: أنّ المادّة حادثة، لأنّها متحرّكة ومتجدّدة، وكلّ متجدّد حادث.
وهكذا استطاع الذهن أن يربط بين الحدوث والمادّة، وهمزة الربط هي حركة المادّة، فإنّ حركتها هي التي جعلتنا نعتقد بأ نّها حادثة؛ لأنّنا نعلم أنّ كلّ متحرّك هو حادث.
ويؤمن المذهب العقلي لأجل ذلك بقيام علاقة السببية في المعرفة البشرية