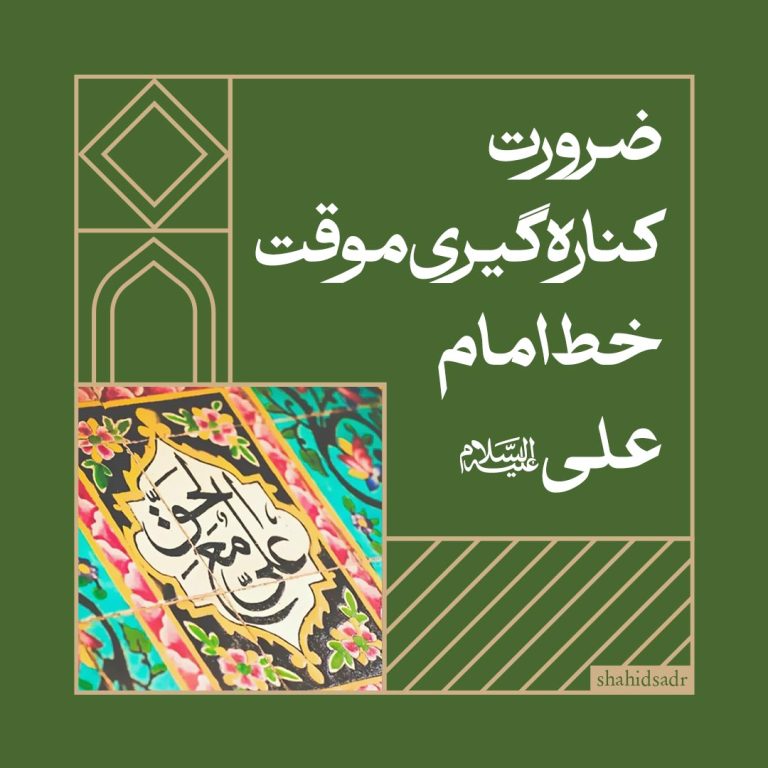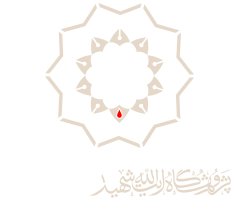الاعتيادي، مع تحويل نصف القيمة الزائدة المنتجة إلى رأسمال، يتحتّم عليه أن يكون متمكّناً من تشغيل ثمانية عمّال.
وأخيراً علّق ماركس على ذلك قائلًا: وفي هذا كما في العلم الطبيعي تتأيّد صحّة القانون الذي اكتشفه هيجل: قانون تحوّل التغيّرات الكمّية- إذ تبلغ حدّاً معيّناً- إلى تغيّرات نوعية[1].
وهذا المثال الماركسي يدلّنا بوضوح على مدى التسامح الذي تبديه الماركسية في (سرد الأمثلة سرداً عاجلًا) على قوانينها المزعومة. ولئن كان التسامح في كلّ مجال خيراً وفضيلة، فهو في المجال العلمي- وخاصّة عندما يراد استكشاف أسرار الكون؛ لإنشاء عالم جديد على ضوء تلك الأسرار والقوانين- تقصير لا يغتفر.
ولا نريد الآن بطبيعة الحال أن نتناول- فعلًا- المسائل الاقتصادية التي يرتكز عليها المثال، ممّا يتّصل بالقيمة الزائدة، ومفهوم الربح الرأسمالي لدى ماركس، وإنّما يهمّنا التطبيق الفلسفي لقانون (القفزة) على رأس المال. فلنقطع النظر عن سائر النواحي، ونتّجه إلى درس هذه الناحية. فإنّ ماركس يذهب إلى أنّ النقد يمرّ بتغيّرات كمّية بسيطة، تحصل بالتدريج، حتّى إذا بلغ ربحه حدّاً معيّناً، حصل الانقلاب النوعي والتحوّل الكيفي بصورة دفعية، وأصبح النقد رأسمالًا.
وهذا الحدّ هو: ضعف معيشة العامل الاعتيادي، بعد تحويل النصف إلى رأسمال من جديد. وما لم يبلغ هذه الدرجة، لا يوجد فيه التغيّر الكيفي الأساسي، ولا يكون رأسمالًا.
فرأس المال- إذن- لفظ يطلقه ماركس على مقدار معيّن من النقود. ولكل
[1] ضد دوهرنك: 210