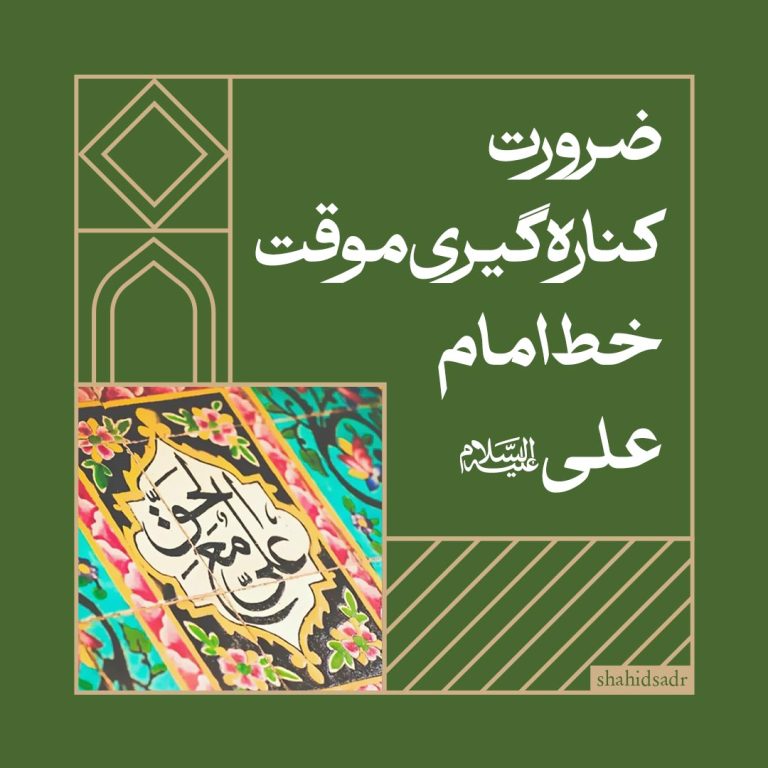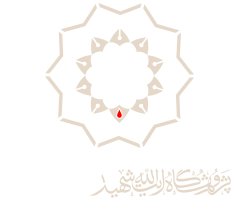الاختلاف الفلسفي الأعمق الذي أشرنا إليه)[1].
ونظرية الإمكان الوجودي هي للفيلسوف الإسلامي الكبير (صدر الدين الشيرازي). وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلّية نفسه، وخرج من تحليله ظافراً بالسرّ، فلم يكلّفه الظفر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها، أكثر من فهم مبدأ العلّية فهماً فلسفياً عميقاً.
والآن نبدأ كما بدأ، فنتناول العلّية بالدرس والتمحيص.
لا شكّ في أنّ العلّية علاقة قائمة بين وجودين: العلّة، والمعلول. فهي لون من ألوان الارتباط بين شيئين. وللارتباط ألوان وضروب شتّى، فالرسّام مرتبط باللوحة التي يرسم عليها، والكاتب مرتبط بالقلم الذي يكتب به، والمطالع مرتبط بالكتاب الذي يقرأ فيه، والأسد مرتبط بسلسلة الحديد التي تطوّق عنقه، وهكذا سائر العلاقات والارتباطات بين الأشياء. ولكن شيئاً واضحاً يبدو بجلاء في كلّ ما قدّمناه من الأمثلة للارتباط، وهو: أنّ لكلّ من الشيئين المرتبطين وجوداً خاصّاً، سابقاً على ارتباطه بالآخر. فاللوحة والرسّام كلاهما موجودان قبل أن توجد عملية الرسم، والكاتب والقلم موجودان قبل أن يرتبط أحدهما بالآخر، والمطالع والكتاب كذلك وجدا بصورة مستقلّة، ثمّ عرض لهما الارتباط.
فالارتباط في جميع هذه الأمثلة علاقة تعرض للشيئين بصورة متأخّرة عن وجودهما، ولذلك فهو شيء ووجودهما شيء آخر. فليست اللوحة في حقيقتها
[1] المنقول عن السيّد المؤلّف رحمه الله أ نّه انتهى في تطوّر فكره الفلسفي إلى الاعتقاد بأنّ الاختلاف المطروح بين القائلين بأصالة الماهيّة والقائلين بأصالة الوجود لا يعدو أن يكون اختلافاً لفظيّاً تورّط فيه كلّ من الطرفين على أثر سوء فهم مراد الطرف الآخر.( لجنة التحقيق)