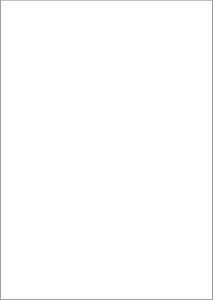والمعلومات العقلية الأوّلية أو الثانوية التي تكتسب بمراعاة الاصول المنطقية، هي حقائق ذات قيمة قاطعة. ولذا أجاز في البرهان- الدليل القاطع في مصطلحه المنطقي- استعمال المحسوسات والمعقولات معاً.
وقامت بعد ذلك محاولة للتوفيق بين الاتّجاهين المتعارضين: بين الاتّجاه الذي يجنح إلى الإنكار القاطع وهو السفسطة، والاتّجاه الذي يؤكّد على الإثبات وهو اتّجاه المنطق الأرسطي. وكانت هذه المحاولة تتمثّل في مذهب الشكّ الذي يعتبر (بيرون) من المبشّرين الأساسيين به.
وتُعرَف عن (بيرون) حججه العشر على ضرورة الشكّ المطلق، فكلّ قضية في نظره تحتمل قولين، ويمكن إيجابها وسلبها بقوّة متعادلة[1].
ولكن مذهب اليقين سيطر أخيراً على الموقف الفلسفي، وتربّع العقل على عرشه الذي أقعده عليه (أرسطو) يحكم ويقرّر مقيّداً بمقاييس المنطق، وخمدت جذوة الشكّ طيلة قرون حتّى حوالي القرن السادس عشر؛ إذ نشطت العلوم الطبيعية، واكتشفت حقائق لم تكن بالحسبان وخاصّة في الهيئة ونظام الكون العامّ. وكانت هذه التطوّرات العلمية بمثابة قوّة الجدل في العصر اليوناني، فبعثت مذاهب الشكّ والإنكار من جديد، واستأنفت نشاطها بأساليب متعدّدة، وقام الصراع بين اليقينيين أنفسهم في حدود اليقين الذي يجب أن يعتمد عليه الإنسان.
وفي هذا الجوّ المشبع بروح الشكّ والتمرّد على سلطان العقل نبغ (ديكارت)، وطلع على العالم بفلسفة يقينية كان لها تأثير كبير في إرجاع التيّار الفلسفي حدّاً ما إلى اليقين.
[1] راجع تاريخ الفلسفة اليونانيّة: 235، يوسف كرم