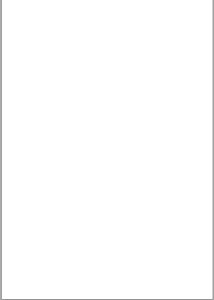المتحقّقة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة … نعم عليه- أي على الصائد- اجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة بل لو لم يصد بها كان عليه الأجر لفوات المنفعة تحت يده»[1].
وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفي السَرَخسي إذ كتب يقول: وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أنّ ما صاد بها من شيء فهو بينهما، فصاد بها سمكاً كثيراً فجميع ذلك للذي صاد … لأنّ الآخذ هو المكتسب دون الآلة، فيكون الكسب له، وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصيّاد[2].
وهذا يعني أنّ الآلة ليس لها حصّة في السلعة المنتجة.
11- وللشيخ الطوسي في الشركة من كتاب المبسوط هذا النصّ الآتي:
«إذا أذن رجلٌ لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيّة أن يكون للآمر دونه فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه: إنّ ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقّاء بنيّة أن يكون بينهم، وإنّ الثمن يكون له- أي للسقّاء- دون شريكه، فها هنا يكون الصيد للصيّاد دون الآمر؛ لأنّه انفرد بالحيازة. وقيل: إنّه يكون للآمر؛ لأنّه اصطاده بنيّته فاعتبرت النيّة، والأوّل أصحّ»[3].
12- ذكر المحقّق الحلّي في الشرائع: أنّ إنساناً «لو دفع دابّةً مثلًا وآخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة، فكان ما يحصل حينئذٍ للسقّاء، وعليه مثل اجرة الدابّة والراوية»[4].
[1] جواهر الكلام 36: 65، 66
[2] المبسوط 22: 34
[3] المبسوط 2: 346
[4] شرائع الإسلام 2: 132- 133 مع اختلاف يسير