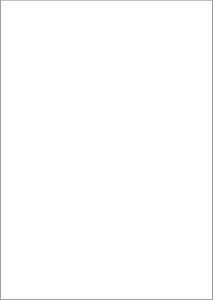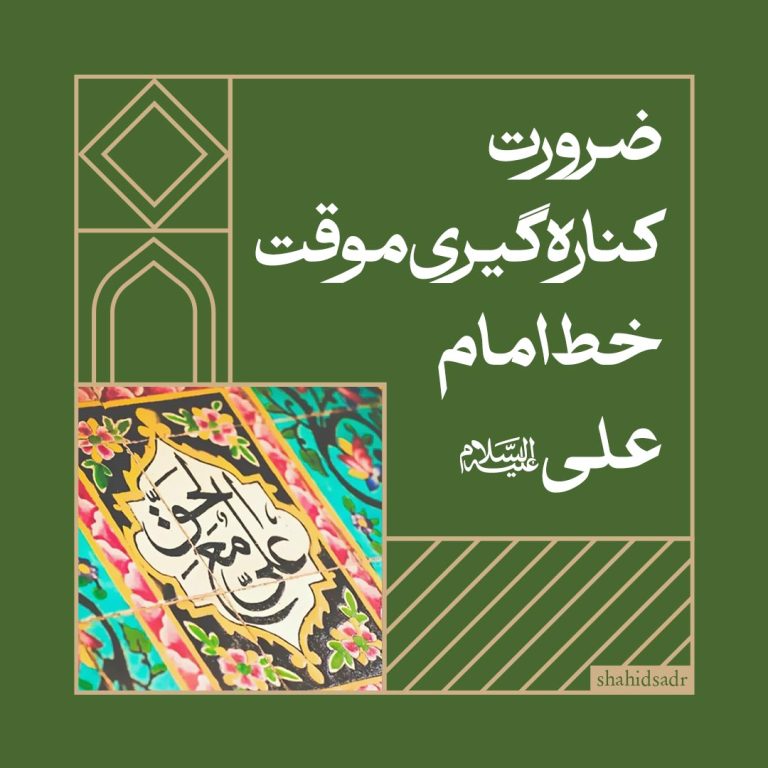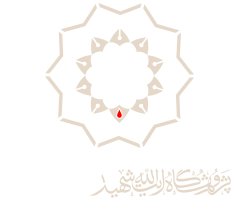عليها فهم جديد للعالم، وتنشأ [بها][1] نظرية جديدة نحوه، تختلف كلّ الاختلاف عن النظرة الكلاسيكية التي اعتادها البشر منذ قُدّر له أن يدرِك ويفكّر.
وليس (هيجل) هو الذي ابتدع اصول الديالكتيك ابتداعاً؛ فإنّ لتلك الاصول جذوراً وأعماقاً في عدّة من الأفكار التي كانت تظهر بين حين وآخر على مسرح العقل البشري، غير أ نّها لم تتبلور على اسلوب منطق كامل واضح في تفسيره ونظرته، محدّد في خططه وقواعده، إلّاعلى يد (هيجل). فقد أنشأ (هيجل) فلسفته المثالية كلّها على أساس هذا الديالكتيك، وجعله تفسيراً كافياً للمجتمع، والتأريخ، والدولة، وكلّ مظاهر الحياة. وتبنّاه بعده (ماركس) فوضع فلسفته المادّية في تصميم ديالكتيكي خالص.
فالجدل الجديد في زعم الديالكتيكيين قانون للفكر والواقع على السواء.
ولذلك فهو طريقة للتفكير، ومبدأ يرتكز عليه الواقع في وجوده وتطوّره.
قال لينين:
«فإذا كان ثمّة تناقضات في أفكار الناس؛ فذلك لأنّ الواقع الذي يعكسه فكرنا يحوي تناقضات. فجدل الأشياء ينتج جدل الأفكار، وليس العكس»[2].
وقال ماركس:
«ليست حركة الفكر إلّاانعكاساً لحركة الواقع، منقولة ومحوّلة في مخ الإنسان»[3].
والمنطق (الهيجلي) بما قام عليه من أساس الديالكتيك والتناقض، يعتبر في النقطة المقابلة للمنطق الكلاسيكي، أو المنطق البشري العامّ تماماً؛ ذلك أن
[1] في الطبعة الاولى: به، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.( لجنة التحقيق)
[2] المادّية والمثالية في الفلسفة: 83
[3] المادّية والمثالية في الفلسفة: 83