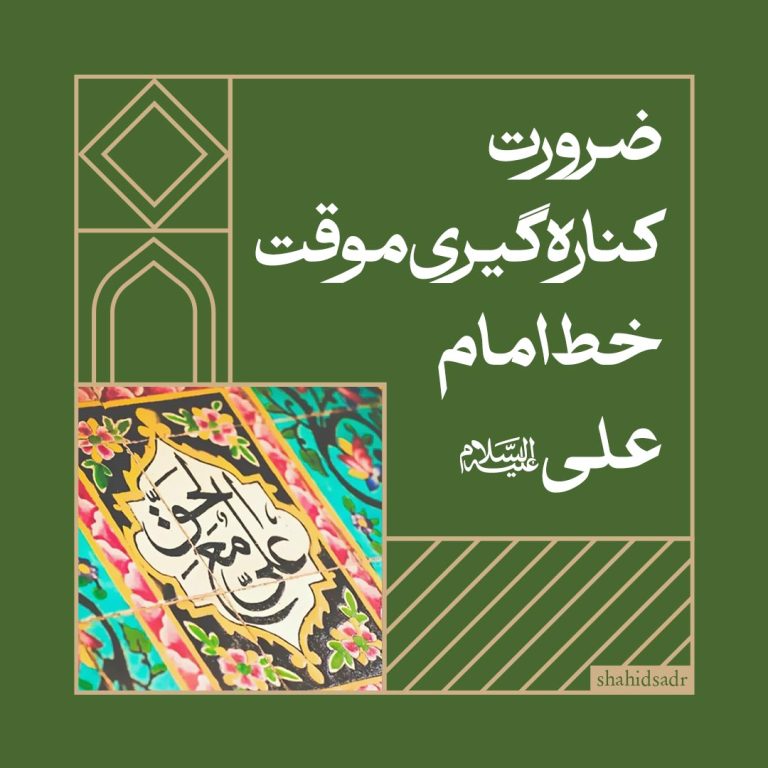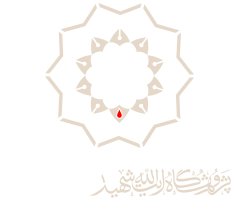أن يكون المبدأ القائل أنّ الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً معرفة عقليّة قبليّة، فنحن وإن كنّا نعلم بأنّ الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً، إلّا أنّ علمنا بذلك ليس علماً عقليّاً قبليّاً، بل هو نتاج من نتاجات الدليل الاستقرائي نفسه، فلا يمكن أن يشكّل الأساس المنطقي للاستقراء، ويقدّم له المبرّر العقلي الكافي.
ولا بدّ لنا الآن- ما دام هذا المبدأ حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من مشكلة الاستقراء- أن نحصل على تصوّر محدّد لهذا المبدأ العقلي المفترض وأبعاده، ثمّ نقيّمه بعد ذلك ونكتشف حقيقته، وهل هو من المبادئ العقليّة القبليّة، أو من القضايا المرتبطة بالاستقراء والتجربة؟
معنى الاتفاق في المبدأ الأرسطي:
وقبل كلّ شيء يجب أن نعرف المعنى الذي يقصده المنطق الأرسطي من كلمة (الاتفاق) في المبدأ الذي وضعه أساساً للاستقراء والذي يقول: إنّ الاتفاق لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً.
إنّ الاتفاق بمعنى (الصدفة)، والصدفة تعتبر نقطة مقابلة للّزوم، فإذا استطعنا أن نفهم معنى اللزوم أمكننا أن نحدّد معنى الصدفة، بوصفه المفهوم المقابل للّزوم والنقيض له.
واللزوم على نحوين: اللزوم المنطقي، واللزوم الواقعي.
واللزوم المنطقي: لون من الارتباط بين قضيّتين أو مجموعتين من القضايا، يجعل أيّ افتراض للانفكاك بينهما يستبطن تناقضاً. كاللزوم المنطقي