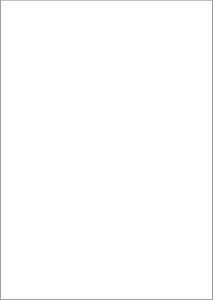يستخدم في إطار هذه المعرفة لاستنتاج قضية من قضايا يقينية تستلزمها اسم «البرهان».
مبادئ الاستدلالات الاخرى في المنطق الأرسطي:
ويجب أن نعرف أيضاً: أنّ المبادئ الأوّلية للاستدلال في رأي المنطق الأرسطي لا تنحصر باليقينيات الستّ؛ لأنّ هذه اليقينيات هي المبادئ الأوّلية للاستدلال البرهاني، أي الاستدلال الذي يحقّق معرفة واجبة القبول. وهذا هو أحد أقسام الاستدلال، وهناك استدلالات اخرى لا تؤدّي إلى معرفة من هذا القبيل، ننطلق في بداياتها الأوّلية من قضايا غير القضايا اليقينية الستّ.
ومن أجل هذا يعتبر المنطق الأرسطي مجموعة القضايا اليقينية الستّ أحد مبادئ الاستدلال، ويضع إلى جانبها القضايا المظنونة، والقضايا المشهورة، والقضايا المسلّمة، والقضايا المقبولة، والقضايا الوهميّة، والقضايا المشبّهة.
فكما توجد قضايا يقينية أوّلية تستنتج كلّ القضايا اليقينية الثانوية منها، كذلك توجد- مثلًا- قضايا مظنونة أوّلية تتدخّل في استنتاج كلّ القضايا المظنونة الثانوية.
فمبادئ الاستدلال الذي يستهدف إيجاد التصديق بالقضية المستدلّة هي:
أوّلًا: اليقينيات، وهي القضايا الستّ المتقدّمة.
وثانياً: المظنونات، وهي قضايا يرجّح العقل صدقها مع تجويز كذبها، كما يقال مثلًا: «فلان يسارّ عدوّي فهو يتكلّم عليَّ» أو «فلان لا عمل له فهو سافل».
وثالثاً: المشهورات، وهي قضايا لا سند للإنسان في التصديق بها إلّا شهرتها وعموم الاعتراف بها، كحسن العدل وقبح الظلم، واستهجان إيذاء الحيوان بدون غرض، فإنّ هذه قضايا لا واقع لها إلّاتطابق الآراء عليها، وهذا هو أساس