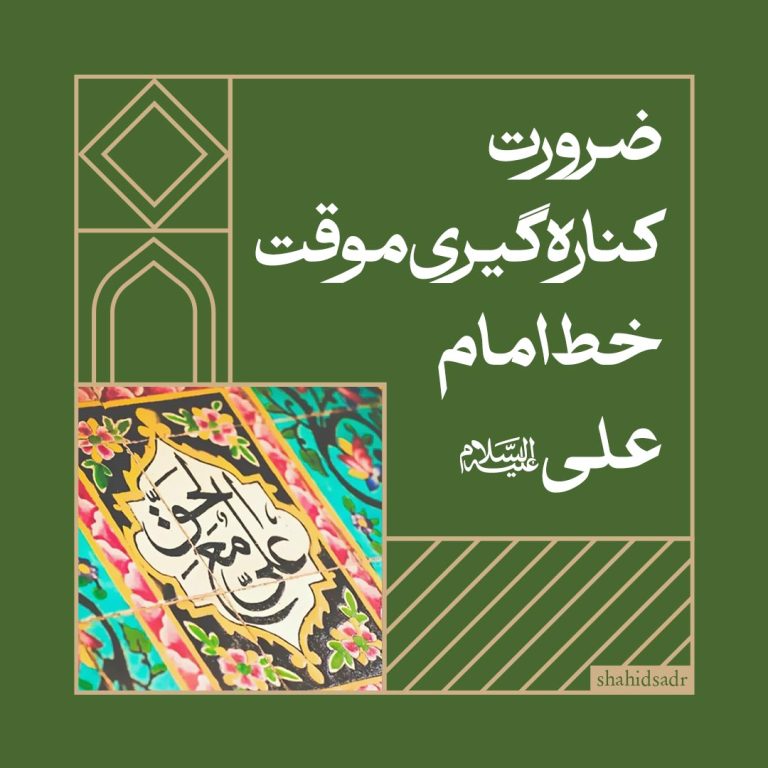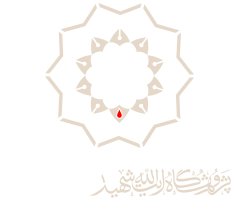القوانين الكونية العامّة. فالتغيّرات الكمّية التدريجية في المجتمع تتحوّل بصورة انقلابية في منعطفات تأريخية كبرى إلى تغيّر نوعي، فيتهدّم الشكل الكيفي القديم للهيكل الاجتماعي العامّ، ويتحوّل إلى شكل جديد.
هكذا يصبح من الضروري- لا من المستحسن فقط- أن تنفجر تناقضات البناء الاجتماعي العام عن مبدأ انقلابي جارف، تُقصى فيه الطبقة المسيطرة سابقاً التي أصبحت ثانوية في عملية التناقض، ويحكم بإبادتها؛ ليفسح مجال السيطرة للنقيض الجديد الذي رشّحته التناقضات الداخلية؛ ليكون الطرف الرئيسي في عملية التناقض.
قال (ماركس وأنجلز):
«ولا يتدنّى الشيوعيون إلى إخفاء آرائهم، ومقاصدهم، ومشاريعهم، بل يعلنون صراحة: أنّ أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلّابهدم كلّ النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوّة»[1].
وقال (لينين):
«إنّ الثورة البروليتارية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة البورجوازي بالعنف»[2].
وما على الماركسية بعد أن وضعت قانون القفزات التطوّرية إلّاأن تفحص عن عدّة أمثلة- فتسردها سرداً عاجلًا، على حدّ تعبير أنجلز- للتدليل بها على القانون المزعوم بعمومه وشموله. وهذا ما قامت به الماركسية تماماً، فقدّمت لنا
[1] البيان الشيوعي: 8
[2] اسس اللينينية: 66