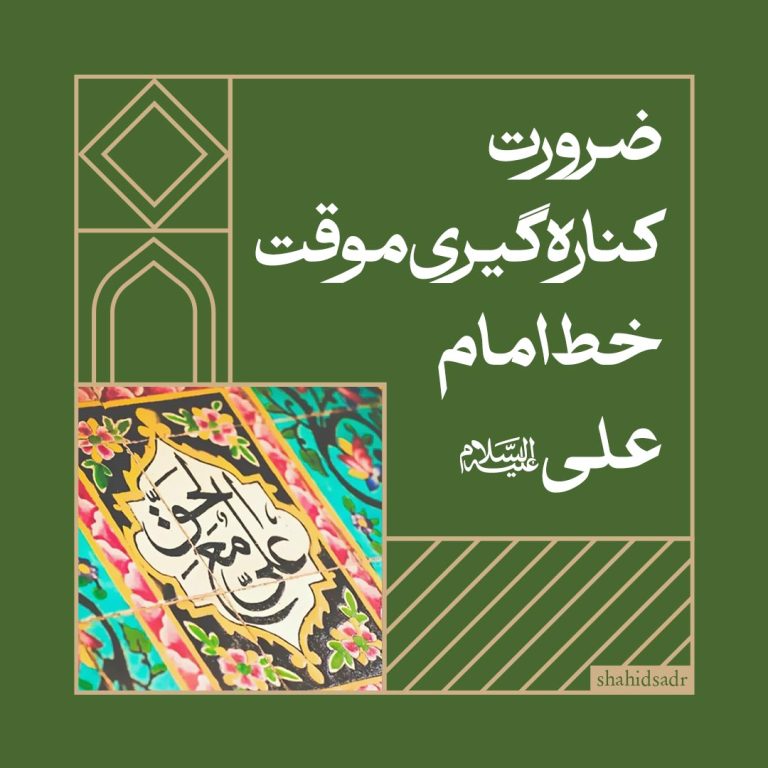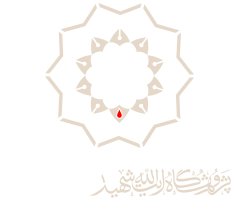ذاته العصيّ على الإدراك الذي أتى به (كانت)»[1].
وقال ماركس:
«إنّ مسألة معرفة ما إذا كان بوسع الفكر الإنساني أن ينتهي إلى حقيقة موضوعية، ليس بمسألة نظرية، بل إنّها مسألة عملية؛ ذلك أ نّه ينبغي للإنسان أن يقيم الدليل في مجال الممارسة على حقيقة فكره»[2].
وواضح من هذه النصوص: أنّ الماركسية تحاول أن تبرهن على الواقع الموضوعي بالتجربة، وتحلّ المشكلة الأساسية الكبرى في الفلسفة- مشكلة المثالية والواقعية- بالأساليب العلمية.
وهذا مظهر واحد من مظاهر عديدة وقع فيها الخلط بين الفلسفة والعلوم؛ فإنّ كثيراً من القضايا الفلسفية حاول بعضٌ دراستها بالأساليب العلمية، كما إنّ عدّة من قضايا العلم درسها بعض المفكّرين دراسة فلسفية، فوقع الخطأ في هذه وتلك.
والمشكلة التي يتصارع حولها المثاليون والواقعيون هي من تلك المشاكل التي لا يمكن اعتبار التجربة المرجع الأعلى فيها، ولا إعطاؤها الصفة العلمية؛ لأنّ المسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي مسألة وجود واقع موضوعي للحسّ التجريبي. فالمثالي يزعم أنّ الأشياء لا توجد إلّافي حسّنا وإدراكاتنا التجريبية، والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقلّ للحسّ والتجربة.
[1] لودفيغ فيورباخ: 54
[2] المصدر نفسه: 112