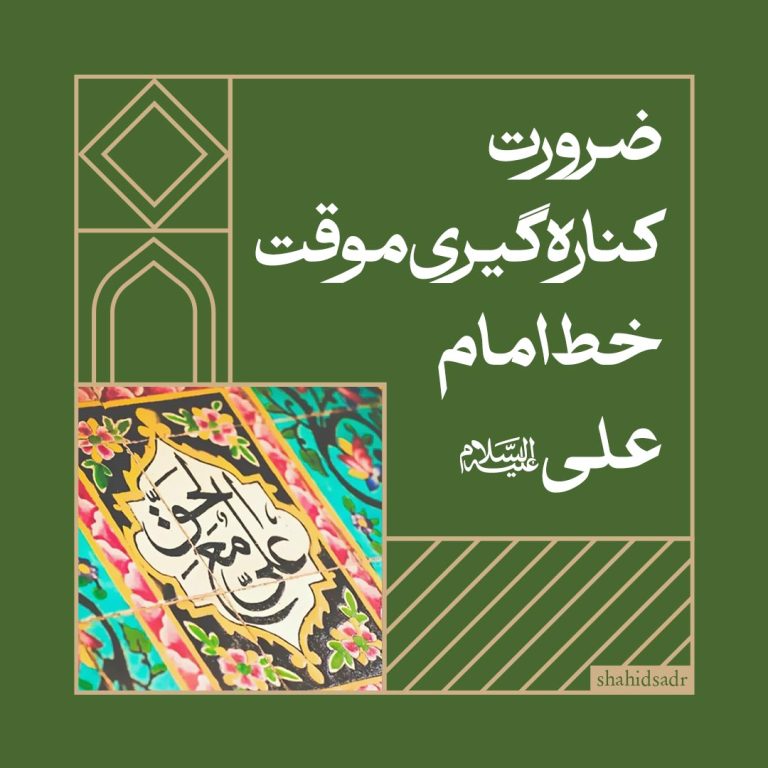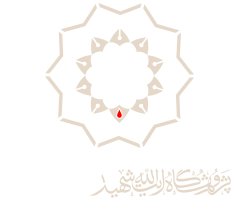رأسمالية كاملة.
أفَتَرى أنّ المشكلة تُحلّ حلًاّ حاسماً إذا رفضنا مبدأ الملكيّة الخاصّة، وأبقينا تلك المفاهيم المادّية عن الحياة، كما حاول اولئك المفكّرون؟!
وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم بالقضاء على الملكية الخاصّة فقط، ويحصل على ضمان لسعادته واستقراره؟! مع أنّ ضمان سعادته واستقراره يتوقّف إلى حدٍّ بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل والتنفيذ، والمفروض في هؤلاء المسؤولين أ نّهم يعتنقون نفس المفاهيم المادّية الخالصة عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية، وإنّما الفرق: أنّ هذه المفاهيم أفرغوها في قوالب فلسفية جديدة، ومن الفرض المعقول الذى يتّفق في كثير من الأحايين، أن تقف المصلحة الخاصّة في وجه مصلحة المجموع، وأن يكون الفرد بين خسارة وألم يتحمّلهما لحساب الآخرين، وبين ربح ولذّة يتمتّع بهما على حسابهم، فماذا تقدّر للُامّة وحقوقها وللمذهب وأهدافه من ضمان في مثل هذه اللحظات الخطيرة التي تمرّ على الحاكمين؟! والمصلحة الذاتية لا تتمثّل فقط في الملكية الفردية، ليقضى على هذا الفرض الذي افترضناه بإلغاء مبدأ الملكية الخاصّة، بل هي تتمثّل في أساليب، وتتلوّن بألوان شتّى. ودليل ذلك ما أخذ يكشف عنه زعماء الشيوعية اليوم من خيانات الحاكمين السابقين، والتوائهم على ما يتبنّون من أهداف.
إنّ الثروة تسيطر عليها الفئة الرأسمالية في ظلّ الاقتصاد المطلق والحرّيات الفردية، وتتصرّف فيها بعقليّتها المادّية تُسلَّم- عند تأميم الدولة لجميع الثروات، وإلغاء الملكية الخاصّة- إلى نفس جهاز الدولة المكوّن من جماعة تسيطر عليهم نفس المفاهيم المادّية عن الحياة، والتي تفرض عليهم تقديم المصالح الشخصية بحكم غريزة حبّ الذات، وهي تأبى أن يتنازل الإنسان عن لذّة ومصلحة