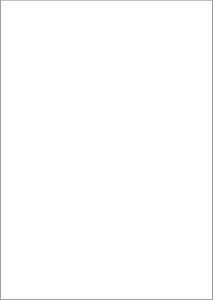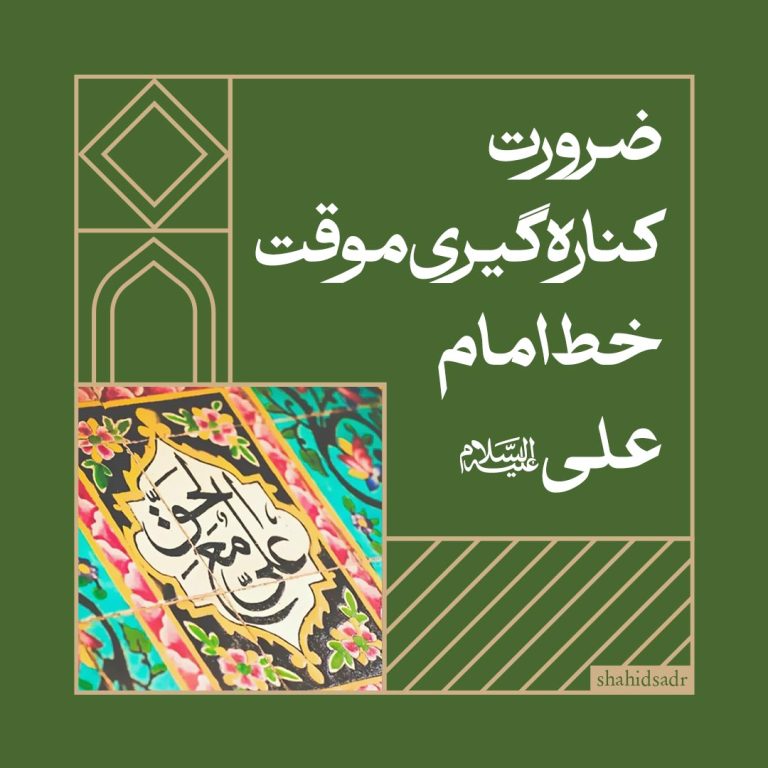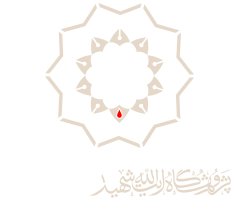لإقامة علم طبيعي، لا مبرّر له إلّاقوانين العلّية بصورة عامّة، وقانون التناسب منها بصورة خاصّة، القائل: إنّ كلّ مجموعة متّفقة في حقيقتها، يجب أن تتّفق- أيضاً- في العلل والآثار، فلو لم تكن في الكون علل وآثار، وكانت الأشياء تجري على حسب الاتّفاق البحت، لما أمكن للعالم الطبيعي القول: إنّ ما صحّ في مختبره الخاصّ، يصحّ على كلّ جزء من الطبيعة على الإطلاق.
ولنأخذ لذلك مثالًا بسيطاً، مثال العالم الطبيعي الذي أثبت بالتجربة أنّ الأجسام تتمدّد حال حرارتها، فإنّه لم يحط بتجاربه جميع الأجسام التي يحتويها الكون طبعاً، وإنّما أجرى تجاربه على عدّة أجسام متنوّعة، كعجلات العربة الخشبية التي توضع عليها إطارات حديدية أصغر منها، حال سخونتها، فتنكمش الإطارات إذا بردت وتشتدّ على الخشب، ولنفرض أ نّه كرّر التجربة عدّة مرّات على أجسام اخرى، فلن ينجو في نهاية المطاف التجريبي عن مواجهة هذا السؤال: ما دمتَ لم تستقصِ جميع الجزئيات، فكيف يمكنك أن تؤمن بأنّ إطارات جديدة اخرى غير التي جرّبتها، تتمدّد هي الاخرى- أيضاً- بالحرارة.
والجواب الوحيد على هذا السؤال هو: مبدأ العلّية وقوانينها. فالعقل حيث إنّه لا يقبل الصدفة والاتّفاق، وإنّما يفسّر الكون بالعلّية وقوانينها من الحتمية والتناسب، يجد في التجارب المحدودة الكفاية للإيمان بالنظرية العامة القائلة بتمدّد الأجسام بالحرارة؛ لأنّ هذا التمدّد الذي كشفت عنه التجربة لم يكن صدفة، وإنّما كان حصيلة الحرارة ومعلولًا لها، وحيث أنّ قانون التناسب في العلّية ينصّ على أنّ المجموعة الواحدة من الطبيعة تتّفق في أسبابها ونتائجها وعللها وآثارها، فلا غرو أن تحصل كلّ المبرّرات- حينئذٍ- للتأكيد على شمول ظاهرة التمدّد لسائر الأجسام.
وهكذا نعرف أنّ وضع النظرية العامّة لم يكن ميسوراً دون الانطلاق من