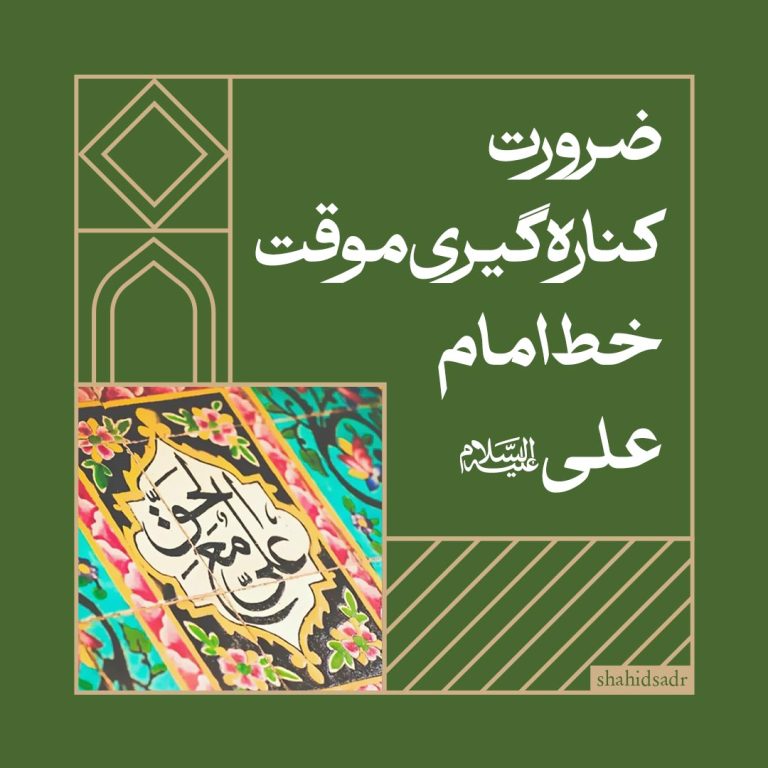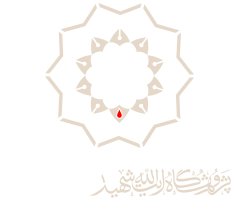علمية، فأقامها على أساس الفعل المنعكس الشرطي. ولكي نفهم ذلك جيّداً يجب أن نقول كلمة عن الفعل المنعكس الشرطي الذي اكتشفه (بافلوف) إذ حاول مرّة أن يجمع لعاب الكلب من إحدى الغدد اللعابية، فأعدّ جهازاً لذلك، وأعطى الحيوان طعاماً لإثارة مجرى اللعاب، فلاحظ أنّ اللعاب بدأ يسيل من كلب متمرّن قبل أن يوضع الطعام في فمه بالفعل؛ لمجرّد رؤية الطبق الذي فيه الطعام، أو الإحساس باقتراب الخادم الذي تعوّد إحضاره.
ومن الواضح: أنّ رؤية الشخص أو خطواته لا يمكن اعتبارها منبّهاً طبيعياً لهذه الاستجابة، كما ينبّهها وضع الطعام في الفم، بل لا بدّ أن تكون هذه الأشياء قد ارتبطت بالاستجابة الطبيعية في مجرى التجربة الطويل حتّى استخدمت كعلامة مبدئية على المنبّه الفعلي.
وعلى هذا يكون إفراز اللعاب عند وضع الطعام في الفم فعلًا منعكساً طبيعياً، يثيره منبّه طبيعي. وأمّا إفراز اللعاب عند اقتراب الخادم أو رؤيته، فهو فعل منعكس شرطي، اثير بسبب منبّه مشروط، يستعمل كعلامة على المنبّه الطبيعي، ولولا إشراطه بالمنبّه الطبيعي، لما وجدت استجابة بسببه.
وبسبب عمليات إشراط كهذا وجد أوّل نظام إشاري لدى الكائن الحي، تلعب فيه المنبّهات المشروطة دوراً في الإشارة إلى المنبّه الطبيعي، واستثارة الاستجابة التي يستحقّها. وبعد ذلك وجد النظام الإشاري الثاني الذي عوّض فيه عن المنبّهات الشرطية في النظام الأوّل، بإشارات ثانوية إلى تلك المنبّهات الشرطية التي اشرطت هذه الإشارات الثانوية بها في تجارب متكرّرة، وأصبح من الممكن الحصول على الاستجابة، أو الفعل المنعكس بالإشارة الثانوية بسبب إشراطها بالإشارة الأوّلية، كما أتاح النظام الإشاري الأوّل الحصول عليها بالإشارة الأوّلية بسبب إشراطها بالمنبّه الطبيعي، وتعتبر اللغة هي الإشارات