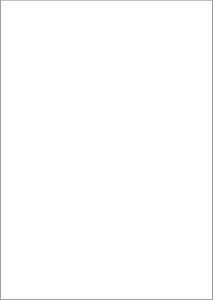وهكذا نجد أنّ أرسطو في هذا النصّ وثق بالاستقراء الكامل، واتخذ منه الأساس الأوّل لكلّ الأقيسة والبراهين؛ لأنّ كلّ هذه البراهين تستمدّ من المقدّمات الأوّليّة، وهذه المقدّمات تثبت بالاستقراء، لا بالقياس.
ولم يحتفظ الاستقراء الكامل بعد ذلك في المنطق الأرسطي بمركزه الرئيس كأساس للمقدّمات الأوّليّة للقياس، غير أ نّه احتفظ بوصفه دليلًا منطقيّاً مؤكّداً.
فابن سينا[1] لا يعتبر الاستقراء وسيلة للبرهنة على المقدّمات الأوّليّة للقياس التي لا وسط بين محمولها وموضوعها، بل يقرّر أنّ كلّ مقدّمة أوّليّة من هذا القبيل لا يمكن أن تثبت إلّاعلى أساس وضوحها الذاتي، لا على أساس القياس ولا الاستقراء[2]. ولكنّه يعترف إلى جانب ذلك بأنّ الاستقراء الكامل دليل منطقي مؤكّد.
نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل:
وتعليقنا على موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل يتلخّص في
______________________________
– يعتبر الحدّ الأصغر هو زيد وخالد وبكر، والحدّ الأكبر: صفة أ نّه يأكل، والحدّ الأوسط هو الإنسان، والاستقراء يتولّى مهمّة إثبات الحدّ الأكبر للأوسط عن طريق الحدّ الأصغر أي إثبات صفة أ نّه يأكل للإنسان بواسطة زيد وخالد وبكر. (المؤلّف قدس سره)
[1] جاء في ترجمته: أبو علي حسين بن عبد اللَّه بن حسن بن عليّ بن سينا( 363- 428 ه ق): فيلسوف وطبيب وعالم من كبار فلاسفة الإسلام وأطبّائهم، عُرف بالشيخ الرئيس، ولد في« أفشنة» قرب« بخارى» وتوفّي في« همدان» ودُفن فيها، تعمّق في درس فلسفة« أرسطو» وتأثّر بالأفلاطونيّة الحديثة، من جملة مؤلّفاته:« القانون»،« الشفاء»،« النجاة»،« الإشارات والتنبيهات»،« الحدود»( لجنة التحقيق)
[2] البرهان لابن سينا: 44- 45