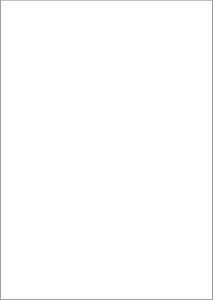1- حركة التطوّر
قال ستالين:
«إنّ الديالكتيك- خلافاً للميتافيزية- لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود، حالة ركود واستقرار، بل يعتبرها حالة حركة وتغيّر دائمين، حالة تجدّد وتطوّر لا ينقطعان، ففيها دائماً شيء يولد ويتطوّر وشيء ينحلّ ويضمحلّ. ولهذا تريد الطريقة الديالكتيكية أن لا يكتفى بالنظر إلى الحوادث من حيث علاقات بعضها ببعض، ومن حيث تكييف بعضها لبعض بصورة متقابلة، بل أن ينظر إليها- أيضاً- من حيث حركتها، من حيث تغيّرها وتطوّرها، من حيث ظهورها واختفائها»[1].
وقال أنجلز:
«ينبغي لنا ألّا ننظر إلى العالم وكأ نّه مركّب من أشياء ناجزة، بل ينبغي أن ننظر إليه وكأ نّه مركّب في أدمغتنا. إنّ هذا المرور ينمّ عن تغيّر لا ينقطع من الصيرورة والانحلال، حيث يشرق نهار النمو المتقدّم في النهاية رغم جميع الصدف الظاهرة والعودات الموقتة إلى الوراء»[2].
[1] المادّية الديالكتيكية والمادّية التأريخية: 16
[2] هذه هي الديالكتيكية: 97- 98