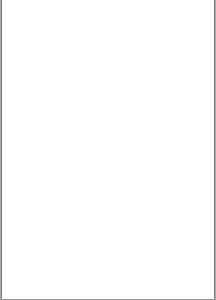وأضاف ستالين إلى ما تقدّم:
«هذا هو الوضع فيما يتعلّق بالنظام في الحزب أثناء فترة الكفاح التي تسبق تحقيق الدكتاتوريّة، ويجب- بل حتّى إلى درجة أعظم- أن يقال الشيء ذاته عن النظام في الحزب بعد أن يكون قد تمّ تحقيق الدكتاتوريّة».
فالتجربة الاشتراكيّة إذن تتميّز بصورة خاصّة عن سائر التجارب الثوريّة بأ نّها مضطرّة- كما يرى أقطابها- إلى الاستمرار في النهج الثوري، والاسلوب المطلق في الحكم داخل نطاق الحزب وخارجه، من أجل خلق الإنسان الاشتراكي الجديد البريء من أمراض المجتمعات الطبقيّة وميولها الاستغلاليّة التي عاشتها الإنسانيّة آلاف السنين.
وهكذا يصبح من الضروري أن يباشر الثوريّون القادة ومن يدور في فلكهم الحزبي السلطة بشكل غير محدود؛ ليتأتّى لهم تحقيق المعجزة وصنع الإنسان الجديد.
وحين نصل إلى هذه المرحلة من تسلسل التجربة الاشتراكيّة نجد أنّ هؤلاء القادة في الجهاز الحزبي والسياسي وأنصارهم يتمتّعون بإمكانات لم تتمتّع بها أكثر الطبقات على مرّ التاريخ، ولا يفقدون من خصائص الطبقة شيئاً، فهم قد كسبوا سلطة مطلقة على جميع الممتلكات ووسائل الإنتاج المؤمّمة في البلاد، ومركزاً سياسيّاً يتيح لهم الانتفاع بتلك الممتلكات، والتصرّف بها طبقاً لمصالحهم الخاصّة، وإيماناً راسخاً بأنّ سيطرتهم المطلقة تكفل السعادة والرخاء لجميع الناس، كما كانت تؤمن بذلك الفئات السابقة التي مارست الحكم في العهود الإقطاعيّة والرأسماليّة.
والفرق الوحيد بين طبقة هؤلاء الثوريّين الحاكمين وسائر الطبقات التي