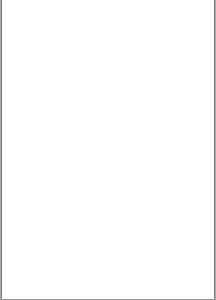ويستثمرها لصالح القضيّة الإنسانيّة الكبرى. فقد ورد في تاريخ تلك التجربة الذهبيّة: أنّ جماعة من غير ذوي اليسار والثروة جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قائلين: «يا رسول اللَّه، ذهب الأغنياء بالاجور، يصلّون كما نصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون بفضول أموالهم. فأجاب النبيّ قائلًا: أوَ ليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدّقون به؟! إنّ لكم بكلّ تسبيحة صدقة، وبكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة»[1]. فهؤلاء المسلمون الذين احتجّوا بين يدي الرسول صلى الله عليه و آله على واقعهم لم يكونوا يريدون الثروة بوصفها أداةً من أدوات المنعة والقوّة أو ضماناً لإشباع الرغبات الشخصيّة، وإنّما عزّ عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس المعنويّة بألوان البرّ والإحسان وبالمساهمة في المصالح العامّة على الصعيد الاجتماعي، وهذا يعكس مفهوم الثروة وطبيعة الإنسان المسلم في ظلّ تجربة إسلاميّة كاملة للحياة.
وجاء في وصف الإجارات والتجارات في المجتمع الإسلامي ما حدّث به الشاطبي، إذ كتب يقول:
«تجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلّا بأقلّ ما يكون من الربح أو الاجرة، حتّى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا له. ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنّهم وكلاء للناس لا لأنفسهم …، بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم- وإن جازت- كالغشّ لغيرهم»[2].
[1] مستدرك الوسائل 7: 263، الباب 49 من أبواب الصدقة، الحديث 10، مع اختلاف يسير
[2] الموافقات في اصول الشريعة 2: 134، المسألة الرابعة، مبحث حظوظ المكلّف