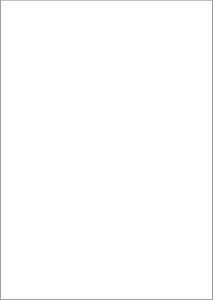والإجابة بالتقدير الأوّل تلخّص الفلسفة الواقعية أو المفهوم الواقعي للعالم، والإجابة بالتقدير الثاني هي التي تقدّم المفهوم المثالي للعالم.
وفي المسألة الثانية يوضع السؤال على ضوء الفلسفة الواقعية هكذا: إذا كنّا نؤمن بواقع موضوعي للعالم، فهل نقف في الواقعية على حدود المادّة المحسوسة، فتكون هي السبب العامّ لجميع ظواهر الوجود والكون بما فيها من ظواهر الشعور والإدراك؟ أو نتخطّاها إلى سبب أعمق، إلى سبب أبدي ولانهائي بصفته المبدأ الأساسي لما ندركه من العالم بكلا مجاليه: الروحي والمادّي معاً؟
وبذلك يوجد في الحقل الفلسفي للواقعية مفهومان: يعتبر أحدهما، أنّ المادّة هي القاعدة الأساسية للوجود، وهو: المفهوم الواقعي المادّي. ويتخطّى الآخر المادّة إلى سبب فوق الروح والطبيعة معاً، وهو: المفهوم الواقعي الإلهي.
فبين يدينا- إذن- مفاهيم ثلاثة للعالم: المفهوم المثالي، والمفهوم الواقعي المادّي، والمفهوم الواقعي الإلهي. وقد يعبّر عن المثالية بالروحية نظراً إلى اعتبار الروح، أو الأنا، أو الشعور، الأساس الأوّل للوجود.
تصحيح أخطاء:
وعلى هذا الضوء يجب أن نصحّح عدّة أخطاء وقع فيها بعض الكتّاب المحدَثين:
الأوّل- محاولة اعتبار الصراع بين الإلهية والمادّية مظهراً من مظاهر التعارض بين المثالية والواقعية، فلم يفصلوا بين المسألتين اللتين قدّمناهما، وزعموا أنّ المفهوم الفلسفي للعالم أحد أمرين: إمّا المفهوم المثالي، وإمّا المفهوم المادّي. فتفسير العالم لا يمكن أن يقبل سوى وجهين اثنين، فإذا فسّرت العالم تفسيراً تصوّرياً خالصاً، وآمنت بأنّ التصوّر أو الأنا هو الينبوع الأساسي، فأنت