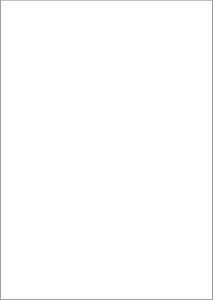الذي يستتبع وجوده وجود (ب) استتباعاً ضرورياً، يكون عدمه مستتبعاً لعدم ذلك الشيء استتباعاً ضرورياً أيضاً. فالسببيّة العدمية عند التجريبيين مجرّد اقتران مطّرد بين عدمين صدفة، وعند العقليين علاقة ضرورة بين عدم مفهوم وعدم مفهوم آخر.
والسببيّة العدمية بالمفهوم العقلي تعني: استحالة الصدفة المطلقة، أي أنّ وجود الشيء مع عدم وجود سببه (أي مع عدم وجود ما يكون مستتبعاً لوجوده استتباعاً ضرورياً) مستحيل؛ لأنّ عدم السبب سبب لعدم الشيء، فلا يمكن أن يكون العدم الأوّل ثابتاً دون الثاني.
فاستحالة الصدفة المطلقة متضمّنة في السببيّة العدميّة بالمفهوم العقلي، وأمّا السببيّة الوجوديّة بالمفهوم العقلي فلا تتضمّن استحالة الصدفة المطلقة؛ لأنّ مجرّد أنّ (أ) يرتبط به (ب) ارتباطاً يجعل وجود (ب) ضرورياً عند وجود (أ) لا ينفي إمكان وجود (ب) بدون سبب.
كما نعرف في هذا الضوء أنّ السببيّة الوجوديّة بالمفهوم التجريبي تناقض السببيّة العدميّة بالمفهوم العقلي؛ لأنّها تفترض أنّ الأشياء التي يقترن بها (ب) أو يتعقّبها دائماً قد اقترن بها (ب) أو تعقّبها على سبيل الصدفة دون أيّ استتباع ضروري، وهذا يعني إمكان الصدفة المطلقة، بينما تتضمّن السببيّة العدميّة بالمفهوم العقلي استحالة الصدفة المطلقة.
ونستخلص من ذلك ما يلي:
أوّلًا: أنّ السببيّة الوجوديّة بالمفهوم العقلي لا تنفي إمكان الصدفة المطلقة.
ثانياً: إنّ السببيّة الوجوديّة بالمفهوم التجريبي تساوي الصدفة المطلقة المتمثّلة في اقتران وجود شيء بوجود شيء آخر دون أيّ ضرورة.
ثالثاً: إنّ السببيّة العدميّة بالمفهوم العقلي تساوي استحالة الصدفة المطلقة.