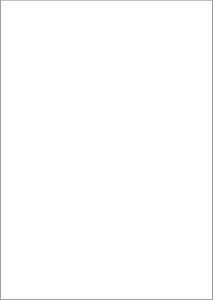السببية يختلف عن الموقف الذي ينطلق منه التطبيق الآخر.
ففي التطبيق الأوّل نفترض:
أوّلًا: أ نّه لا يوجد أيّ مبرّر قبلي لرفض علاقة السببيّة بين (أ) و (ب) بالمفهوم العقلي للسببيّة.
وثانياً: أ نّا نعلم مسبقاً باستحالة الصدفة المطلقة.
وفي التطبيق الثاني نفترض:
أوّلًا: أ نّه لا يوجد أيّ مبرّر قبلي لرفض علاقة السببية بين (أ) و (ب) بالمفهوم العقلي للسببية، كما في التطبيق الأوّل.
وثانياً: الشكّ المسبق في استحالة الصدفة المطلقة، أي نحتمل أنّ (ب) يمكن أن توجد بدون سبب، كما نحتمل- في مقابل ذلك- أنّ وجودها بدون سبب مستحيل.
وفي التطبيق الثالث نفترض:
أوّلًا: أ نّه لا يوجد أي مبرّر قبلي لرفض علاقة السببيّة بين (أ) و (ب) بالمفهوم العقلي للسببيّة، كما في التطبيقين السابقين.
وثانياً: العلم المسبق بإمكان الصدفة المطلقة ل (ب)، أي إمكان وجود (ب) بدون سبب.
وفي التطبيق الرابع نفترض: وجود مبرّر قبلي لرفض علاقة السببيّة بالمفهوم العقلي بين (أ) و (ب)، فلا يوجد أيّ احتمال قبل الاستقراء للسببيّة العقلية، وإنّما يحتمل قبلياً السببية بالمفهوم التجريبي بين (أ) و (ب) الذي يعني التتابع المطّرد بين (أ) و (ب).
ولكي نوضّح هذه المواقف الأربعة القبلية التي تختلف التطبيقات على أساسها، لا بدّ أن نميّز بصورة دقيقة بين السببيّة بمفهومها العقلي والسببية بالمفهوم