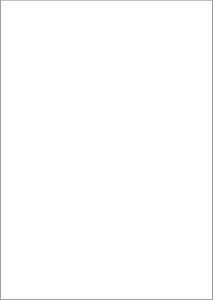إنّ هذه الطريقة تتطلّب افتراض علم إجمالي على نحو يكون عدد كبير من أعضائه وأطرافه مستبطناً أو مستلزماً للقضية الاستقرائية، فتصبح القضية الاستقرائية محوراً لعدد من القيم الاحتمالية بقدر ذلك العدد من الأعضاء المستبطن أو المستلزم للقضية الاستقرائية. ولا بدّ أن يكون العلم الإجمالي المفترض مرناً بشكل يزداد فيه عدد الأعضاء التي تتضمّن إثبات القضيّة الاستقرائية، وينمو هذا العدد باستمرار تبعاً لازدياد عدد التجارب أو الملاحظات في عملية الاستقراء، وبهذا يصبح نموّ القيمة الاحتمالية للقضية الاستقرائية مطّرداً مع نموّ الاستقراء وامتداده.