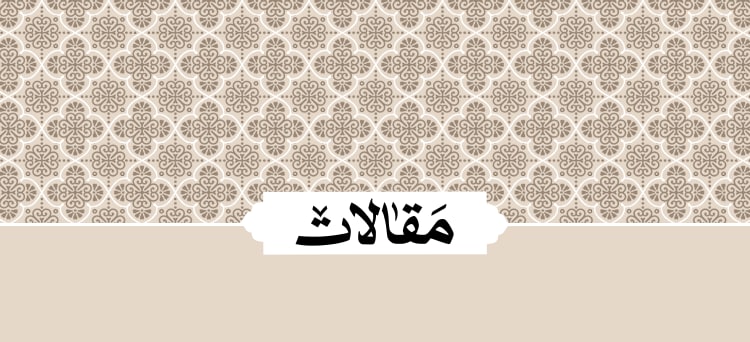عندما يدرس الإمام الشّهيد رضوان الله عليه، المشاريع التجديدية فإنه يقدم رؤية موضوعية شمولية في تقييم التجربة ـ موضوع الدّراسة، وذلك لعاملين أساسيين:
الأوّل: ما تميز به الشّهيد الصّدر من قدرة عالية في كل المجالات الّتي تناولها بالبحث والدّراسة، وهذه سمة طبعت حياته العلمية بالكامل رغم قصر عمره المبارك. فهو باحث من طراز خاص، إذ إنه لا ينطلق في دراسته من محاولات تجزيئية تنحصر في جو الدّراسة، بل إنه قدس سره يجعل الدّراسة ـ كمنهج عام عنده ـ خاضعة لرؤية شمولية عامة يندرج موضوع الدّراسة ضمن سياقاتها الكلية. وعلى هذا فإنّ رؤيته للمشاريع التجديدية تستند إلى العمق الشّمولي الّذي تحتاجه مثل هذه الدّراسات عادة.
الثاني: إنّ الشّهيد الصّدر هو نفسه مجدد وصاحب حركة تجديدية مؤثرة في واقعه الثقافي والإجتماعي والسياسي، الأمر الّذي يجعل من تقييماته للتجارب التجديدية على قدر كبير من الأهمية، لأنها منطلقة من عقلية تجديدية حقيقية ومن نظرة ترصد الماضي والحاضر والمستقبل بهموم التجديد.
وسنحاول هنا أن ندرس تجربة الشّيخ الطوسي كنموذج للتجديد كما تناولها الشّهيد الصّدر رضي الله عنه.
رؤية الشّهيد الصّدر لتجربة الشيخ الطوسي:
يرى الشّهيد الصّدر إنّ مساهمة الشّيخ الطوسي في علم الاصول لم تكن مجرد استمرار للخط، بل كانت تطوراً جديداً ضمن التطور الشامل في التفكير الفقهي والعلمي الذي حققه. وقد تمثل ذلك في مجال الاصول بكتابه (العدة) وفي مجال الفقه بكتابه (المبسوط).
ومن خلال هذا الإنجاز يعتبر الشهيد الصدر إنّ الشيخ الطوسي حد فاصل بين عصرين يطلق عليهما العصر التمهيدي والعصر العلمي الكامل، (فقد وضع هذا الشّيخ الرائد حداً للعصر التمهيدي وبدأ عصر العلم الّذي أصبح الفقه والاصول فيه علماً له دقته وصناعته وذهنيته العلمية الخاصة)[1].
ثم يتناول الشّهيد الصّدر دراسة هذه التجربة التجديدية في ضوء موقعها في الترتيب الزّمني للحركة العلمية، فيعتبر إنّ البحث الفقهي الّذي سبق الشّيخ الطوسي كان يقتصر في الغالب على إستعراض المعطيات المباشرة للأحاديث والنصوص أي إصول المسائل، ويرى في كتاب المبسوط (محاولة ناجحة عظيمة في مقاييس التطور العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضّيق المحدود في إصول المسائل إلى نطاق واسع يمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق القواعد العامة ويتتبع أحكام مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشرة للنصوص)[2].
ويؤكد الإمام الشّهيد على أهمية الترابط في مشروع التجديد الفكري مع حركة الزّمن وذلك بقوله: (إنّ التطور الّذي أنجزه الشّيخ (الطوسي) في الفكر الفقهي كان له بذوره الّتي وضعها قبله أستاذاه السيد المرتضى والشّيخ المفيد وقبلهما ابن أبي عقيل وإبن الجنيد…. وكان لتلك البذور أهميتها من الناحية العلمية حتّى نقل عن أبي جعفر بن معد الموسوي وهو متأخر عن الشّيخ الطوسي إنه وقف على كتاب ابن الجنيد الفقهي واسمه (التهذيب) فذكر إنه لم ير لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أرق معنى منه، وقد استوفى فيه الفروع والاصول وذكر الخلاف في المسائل واستدل بطريقة الإمامية وطريق مخالفيهم. فهذه الشّهادة تدل على قيمة البذور الّتي نمت حتّى آتت أكلها على يد الطوسي)[3].
ويلخص الشّهيد الصّدر رؤيته لتجربة الطوسي التجديدية في بعدها الزّمني بقوله: (ما مضى المجدد محمد بن الحسن الطوسي ـ قدس سره ـ حتّى قفز بالبحوث الإصولية وبحوث التطبيق الفقهي قفزة كبيرة وخلّف تراثاً ضخماً في الاصول يتمثل في كتاب (العُدة) وتراثاً ضخماً في التطبيق الفقهي يتمثل في كتاب (المبسوط). ولكن هذا التراث الضّخم توقف عن النمو بعد وفاة الشّيخ المجدد طيلة قرن كامل في المجالين الإصولي والفقهي على السواء).
وهذه الحقيقة بالرغم من تأكيد جملة من علمائنا لها تدعو إلى التساؤل والإستغراب، لأن الحركة الثورية الّتي قام بها الشّيخ في دنيا الفقه والاصول والمنجزات العظيمة الّتي حققها في هذه المجالات كان المفروض والمترقب أن تكون قوة دافعة للعلم وإن تفتح لمن يخلف الشّيخ من العلماء آفاقاً رحيبة للإبداع والتجديد ومواصلة السير في الطريق الّذي بدأه الشّيخ، فكيف لم تأخذ أفكار الشّيخ وتجديداته مفعولها الطبيعي في الدّفع والإغراء بمواصلة السير)[4].
ويقدم الإمام الصّدر تفسيره لهذه الظاهرة الغريبة، من خلال دراسته للظروف الزّمانية، حيث يرى إنّ هجرة الطوسي إلى النجف الأشرف فصلته عن حوزته المبدعة في بغداد، وإنه ركّز على التفاعل مع أفكاره العملاقة، فكان لابد من مرور فترة زمنية حتّى تصل إلى مستوى استيعاب أفكاره والتفاعل معها حيث كتب يقول:
(فهجرته إلى النجف وإن هيأته للقيام بدوره العلمي العظيم لما أتاحت له من تفرغ ولكنها فصلته عن حوزته الأساسية، ولهذا لم يتسرب الإبداع الفقهي العلمي من الشّيخ إلى تلك الحوزة الّتي كان ينتج ويبدع بعيداً عنها، وفرق كبير بين المبدع الّذي يمارس إبداعه العلمي داخل نطاق الحوزة ويتفاعل معها باستمرار وتواكب الحوزة إبداعه بوعي وتفتح، وبين المبدع الّذي يمارس إبداعه خارج نطاقها وبعيداً عنها.
ولهذا كان لابد ـ لكي يتحقق ذلك التفاعل الفكري الخلاق ـ إن يشتد ساعد الحوزة الفتية الّتي نشأت حول الشّيخ في النجف حتّى تصل إلى ذلك المستوى من التفاعل من الناحية العلمية، فسادت فترة ركود ظاهري بانتظار بلوغ الحوزة الفتية ذلك المستوى، وكلّف ذلك العلم أن ينتظر قرابة مائة عام ليتحقق ذلك ولتحمل الحوزة الفتية أعباء الوراثة العلمية للشيخ حتّى تتفاعل مع آرائه وتتسرب بعد ذلك بتفكيرها المبدع الخلاق إلى الحلة)[5].
ونستطيع أن نفهم من رؤية الشّهيد الصّدر في تفسيره هذا، إنّ الشّيخ الطوسي سبق حركة الزّمن في مشروعه التجديدي العملاق، وتقدم على واقعه بمسافة زمنية طويلة، ويمكن أن نتصور حجم هذا الإنجاز بشكله الحيّ عند التأمل في المراحل الّتي تلت مرحلة الطوسي والّتي تحولت فيها النجف إلى المعقل الأوّل للفكر الشّيعي بمنجزاته العلمية الرائدة..
ويقلل الشهيد الصدر من أهمية التفسير السائد لظاهرة الجمود العلمي الذي أعقب الشيخ الطوسي والقائل بأن قداسة الشيخ الطوسي منعت الاخرين من العلماء من مناقشة آرائه. فيقدم سبباً آخر في تفسير هذه الظاهرة يسير في سياق الأول من حيث ارتباطه بعامل الزمن، وهو ان الفكر السّني في تلك الفترة قد تحجم في دائرة التقليد وأغلق باب الإجتهاد رسمياً، وبذلك انكمش الفكر الإصولي السّني ومني بالعقم ـ علي حد قول السيد الشّهيد ـ الأمر الّذي جعل التفكير العلمي لعلماء الشّيعة يفقد أحد محفزاته المحركة.
ويؤكد الشهيد الصّدر إنّ الحركة التجديدية الّتي أحدثها الشّيخ الطوسي والّتي عاشت توقفاً نسبياً بعده، عادت من جديد للتفاعل بالمستوى الّذي يتناسب مع أفكاره. وذلك على يد الفقيه المبدع محمد بن أحمد إبن إدريس (ت 598) الّذي انطلق في حركته التجديدية من تقدير دقيق للظروف الفكرية الّتي يعيشها الواقع العام والّتي اتسمت بالجمود، فقرر أن يعيد الحياة فيها من جديد، وتمكن بالفعل من إحداث نقلة نوعية في الواقع الّذي عاصره، على إنّ من المهم أن نتذكر إنّ هذه النقلة عندما حدثت فإنها أدركت حينذاك مستوى الشّيخ الطوسي، وكأنّه كان لا يزال حيّاً إلى تلك الفترة الزّمنية.
ويعود السيد الشّهيد إلى تفسير ظاهرة الإنطلاقة الجديدة للفكر الشّيعي في تجربة إبن إدريس، مستنداً على حركة الزّمن حيث يقول إنّ (الحوزة العلمية الّتي خلّفها الشّيخ الطوسي سرى فيها روح التقليد لأنها كانت حوزة فتية، فلم تستطع أن تتفاعل بسرعة مع تجديدات الشّيخ العظيمة، وكان لابد لها أن تنتظر مدة من الزّمن حتّى تستوعب تلك الأفكار وترتفع إلى مستوى التفاعل معها والتأثير فيها، فروح التقليد فيها كانت مؤقتة بطبيعتها)[6].
هذه باختصار رؤية الشّهيد الصّدر لتجربة الشّيخ الطوسي التجديدية والّتي يؤكد فيها رضوان الله عليه على أهمية عامل الزّمن في مشاريع التجديد الّتي ظهرت في تاريخ الفكر الإسلامي واستطاعت أن تفرض وجودها واستمراريتها مع حركة الزّمن، وقد اخترنا نموذج الشّيخ الطوسي في دراسة الشّهيد الصّدر باعتبار إنّ تجربته تمثل سبقاً لحركة الزّمن.
التجديد وحركة الزّمن في فكر الشّهيد الصّدر
يرى الشّهيد الصّدر إنّ المشروع التجديدي يتنامى من خلال عامل الزّمن، حيث تكون كل مرحلة مقدمة للمرحلة التالية. وذلك في المجال الواحد من مجالات التجديد، ففي التجديد الفكري وبالتحديد التجديد الإصولي، يحدد الشّهيد الصّدر العصور الثلاثة التالية:
أولاً: العصر التمهيدي، ويعتبر قدس سره إنّ هذا العصر بدأ بإبن أبي عقيل وإبن الجنيد، وفيه وضعت البذور الأساسية لعلم الاصول.
ثانياً: عصر العلم، وهو العصر الّذي بدأ بالشيخ المجدد الطوسي فكان رائده ورمزه الأكبر. وفي هذا العصر تحددت معالم الفكر الإصولي على أساس البذور الأولى. وكان من رجال هذا العصر إبن إدريس والمحقق الحلّي والعلامة الحلّي والشّهيد الأوّل.
ثالثاً: عصر الكمال العلمي، وبدأ هذا العصر على يد المجدد الوحيد البهبهاني أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وفيه واصل رجال هذه المدرسة التجديدية مشروع البهبهاني التجديدي على امتداد فترة زمنية قاربت النصف قرن.
ويرى الشّهيد الصّدر إنّ هذا التقسيم الزّمني العام، تتفرع عنه تقسيمات زمنية فرعية حيث يقول: (ولا يمنع تقسيمنا هذا لتاريخ العلم إلى عصور ثلاثة، إمكانية تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إلى مراحل من النمو، ولكل مرحلة رائدها وموجهها، وعلى هذا الأساس نعتبر الشّيخ الأنصاري قدّس سره المتوفى (1281) رائداً لأرقى مرحلة من مراحل العصر الثالث وهي المرحلة الّتي يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من مائة سنة حتّى اليوم)[7].
وهكذا نرى إنّ الشّهيد الصّدر قدّس سره يؤكد على التجديد من خلال عامل الزّمن وفق ترابط دقيق في العلاقة بينهما، نستطيع أن نلخصها بالمرتكزين التاليين:
الأوّل: إنَ الحركة التجديدية إنما تنبثق نتيجة اتجاه عوامل موضوعية تفرضها طبيعة الظروف العامة في مرحلة زمنية محددة، فقد يبرز اتجاه تجديدي يسبق الزّمن كما هو الحال في تجربة الشّيخ الطوسي، وقد يبرز اتجاه تجديدي يواكب الزّمن ويمنع التخلّف عنه كما في تجربة الوحيد البهبهاني.
الثاني: إنّ الفترة الزّمنية لطول العصر العلمي إنما تتحدد في ضوء مهمة الحركة التجديدية وخصائصها المميزة مما يجعل إمكانية تقسيمه إلى مراحل زمنية متعددة كما في العصر الثالث لتطور علم الاصول.
يرى الشّهيد الصّدر إنّ المشروع التجديدي يتنامى من خلال عامل الزّمن، حيث تكون كل مرحلة مقدمة للمرحلة التالية. وذلك في المجال الواحد من مجالات التجديد، ففي التجديد الفكري وبالتحديد التجديد الإصولي، يحدد الشّهيد الصّدر العصور الثلاثة التالية:
أولاً: العصر التمهيدي، ويعتبر قدس سره إنّ هذا العصر بدأ بإبن أبي عقيل وإبن الجنيد، وفيه وضعت البذور الأساسية لعلم الاصول.
ثانياً: عصر العلم، وهو العصر الّذي بدأ بالشيخ المجدد الطوسي فكان رائده ورمزه الأكبر. وفي هذا العصر تحددت معالم الفكر الإصولي على أساس البذور الأولى. وكان من رجال هذا العصر إبن إدريس والمحقق الحلّي والعلامة الحلّي والشّهيد الأوّل.
ثالثاً: عصر الكمال العلمي، وبدأ هذا العصر على يد المجدد الوحيد البهبهاني أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وفيه واصل رجال هذه المدرسة التجديدية مشروع البهبهاني التجديدي على امتداد فترة زمنية قاربت النصف قرن.
ويرى الشّهيد الصّدر إنّ هذا التقسيم الزّمني العام، تتفرع عنه تقسيمات زمنية فرعية حيث يقول: (ولا يمنع تقسيمنا هذا لتاريخ العلم إلى عصور ثلاثة، إمكانية تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إلى مراحل من النمو، ولكل مرحلة رائدها وموجهها، وعلى هذا الأساس نعتبر الشّيخ الأنصاري قدّس سره المتوفى (1281) رائداً لأرقى مرحلة من مراحل العصر الثالث وهي المرحلة الّتي يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من مائة سنة حتّى اليوم)[8].
وهكذا نرى إنّ الشّهيد الصّدر قدّس سره يؤكد على التجديد من خلال عامل الزّمن وفق ترابط دقيق في العلاقة بينهما، نستطيع أن نلخصها بالمرتكزين التاليين:
الأوّل: إنَ الحركة التجديدية إنما تنبثق نتيجة اتجاه عوامل موضوعية تفرضها طبيعة الظروف العامة في مرحلة زمنية محددة، فقد يبرز اتجاه تجديدي يسبق الزّمن كما هو الحال في تجربة الشّيخ الطوسي، وقد يبرز اتجاه تجديدي يواكب الزّمن ويمنع التخلّف عنه كما في تجربة الوحيد البهبهاني.
الثاني: إنّ الفترة الزّمنية لطول العصر العلمي إنما تتحدد في ضوء مهمة الحركة التجديدية وخصائصها المميزة مما يجعل إمكانية تقسيمه إلى مراحل زمنية متعددة كما في العصر الثالث لتطور علم الاصول.
[1] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 56 ـ 57.
[2] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول: ص 60.
[3] المصدر السابق، ص 62 ـ 63.
[4] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 62 ـ 63.
[5] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 66
[6] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 70.
[7] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 89.
[8] الصّدر، المعالم الجديدة للاصول، ص 89