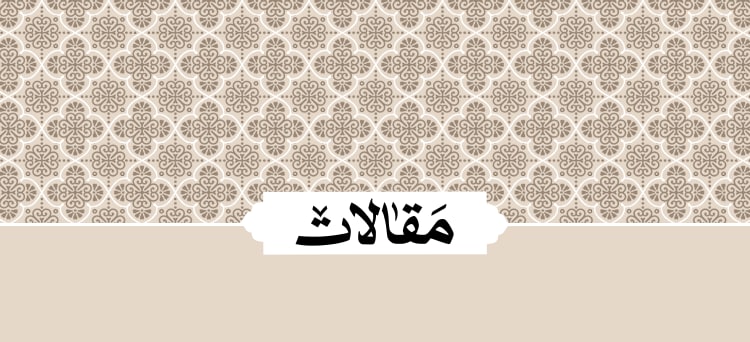لا يخفى على أحد خطورةُ الدور الذي لعبته المرجعية الدينية الشيعية على مرّ العصور في الحفاظ على عنصر ثبات الأمة على مبادئها وهي تخوض غمار الحياة و تجاربَها المرّة. وقد حدّثنا التاريخ عن العديد من النوادر الذين تألّق نجمهم في سمائه وهم يخطّون بفكرهم الحيّ وسلوكهم الصادق أروعَ لوحات الذوبانِ في المبدأ والإخلاصِ للعقيدة. ومن أسطع وأجلى الأرقام التي تطالعنا في قرننا المنصرم شخصيةُ الفقيد الرباني آية الوعي والعلم والعمل الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّه)[1].
وسنكون بريئين من تهمة المبالغة إذا قلنا بندرة المجالات التي لم تطلها إبداعاتُ وتجديداتُ هذا الراحل الغريب على الصعيدين الحوزيّ[2] والعالمي. إلا أننا سنحاول في هذه المقالة إن شاء الله تعالى الاكتفاءَ بالوقوف – ولو استشرافاً- على معالم ما رآه وسلكه (قدّه) إلى آخر يوم في حياته في ما يتعلّق بموضوع المرجعيّة الدينيّة و”جوانبِ التجديد” فيها وقراءتها بـ”نظرة فاحصة” شيئاً ما – وإن كانت أوّلية- بعد أن كان قد أراد لها التحرّرَ من إطارها الضيّق لتبلغ مرحلةَ “النموذجيّة”. و لم نملك و نحن نستطلع معالم هذه “المرجعية النموذجية” التي عاجلتها يد المنون ، إلا التعجّب مما ذهب إليه بعض علمائنا المعاصرين في دعواه عدول السيد الشهيد (قدّه) عن طرحه نظرياً وعملياً واقترابه من نمط مرجعية السلف[3]...حيث أعملنا “حساب الاحتمالات” في القرائن المتوفرة كلّها ولم يحالفنا الحظّ في التوفّر على مبرّر منطقي لهذه الدعوى بل أفضى هذا الحساب في مرحلة “التوالد الذاتي” (الذووي) إلى يقين بالبطلان. أما عدم خروج نظرياته (قدّه) إلى عالم الفعلية بشكل كامل فلوجود المانع لا انتفاءِ المقتضي.
طابع البحث:
بعد أن أضفنا إلى مصادرنا النظرية (من قبيل “أطروحة المرجعية الموضوعية أو الصالحة”[4] من “المباحث” و”المحنة” و”الإسلام يقود الحياة” وغيرها) مصدراً عملياً متمثلاً بسيرته الذاتية، كان الحديث عن معالم المرجعيّة عند الشهيد الصدر (قدّه) مبنياً على رؤاه النظرية من ناحية وسلوكه العملي من ناحية أخرى. وقد دمجنا بينهما في معظم الأحيان فخرج البحث مرصّعاً بشواهد حيّة أضفت إليه نفحاتٍ طفيفةً من روح ذلك العظيم.
المرجعية و مراحلها في الحوزة العلميّة:
قسّم (قدّه) في محنته الأولى (1389) المراحل التي مرّت بها الحوزة العلمية إلى أربع مراحل: مرحلة الاتصال الفردي، مرحلة الجهاز المرجعي، مرحلة التمركز والاستقطاب ومرحلة القيادة.
أما فيما يتعلّق بمفهوم “المرجعية” ، فأبرز ما يطالعنا في هذا المجال ويسمح حجم المقالة بذكره هو توسعته (قدّه) لهذا المفهوم متحرّراً من تأطيره بالمجال الضيّق للإفتاء ليطال كافة أبعاد الحياة، وعدمُ تفكيكه بين المرجعية وواقع الحياة المعاش، وكأنه – أي الواقع- مأخوذ في مفهومها لأنها في الحقيقة ليست إلا مرجعيّة للواقع نفسه وبكافة أبعاده وظروفه. ونشير على نحو الاختصار إلى أبرز أهداف المرجعية التي يراها (قدّه) في “أطروحته” وهي:
1- نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين.
2- إيجاد تيّار فكريّ واسع في الأمة يشتمل على المفاهيم الإسلامية الواعية من قبيل المفهوم الأساسي الذي يؤكّد بأنّ الإسلام نظام كامل لشتى جوانب الحياة.
3- إشباع الحياة الفكريّة الإسلاميّة للعمل الإسلامي.
4- القيمومة على العمل الإسلامي والإشراف على ما يعطيه العاملون في سبيل الإسلام.
5- إعطاء مراكز العالِمية من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القيادية للأمة بتبني مصالحها والاهتمام بقضايا الناس..
مشكلات تعصف بالحوزة:
كان واضحاً لديه (قدّه) وجود العديد من المشكلات التي عصفت بالكيان الحوزي وعملت على تفتيته وتضعيفه، فراح يمعن النظر في طبيعتها لتحديد مناشئها ومواطن الخلل التي أدت إلى ظهورها. و قد تناول (قدّه) في محنته الثانية عواملَ الأرضيّة النفسيّة التي عاشتها الحوزة و التي كانت ولا تزال تساهم في خلق المشكلات وتكوين المحن. إلا أنّنا سوف نعمّم البحث مضيفين إلى ما ذكر العديد من المشكلات ، منطلقين تارةً من تحديده (قدّه) لمفهوم المرجعيّة وأخرى من مجمل ما كتبه وقاله وسلكه في هذا المجال، وثالثة مستكشفين بعض المشكلات على نحو “الإنّية” انطلاقاً من بعض العلاجات التي كان (قدّه) قد وضعها. وسنحاول قدر الإمكان أن نردفها بالحلول الناجعة التي ارتآها (قدّه).
1- المشكلة الأولى: عدم الشعور التفصيلي بالله تعالى: يرى السيد الشهيد (قدّه) أنه عادةً ما يكون دافع الطالب لترك الوطن والدخول في الحوزة هو الشعور التفصيلي بالارتباط بالله تعالى لـ”يتعلّم على يد ورثة الأنبياء ثم يواصل خط الأنبياء”، لكن سرعان ما تضعف تدريجياً جذوة شعوره بالاتصال بالله تعالى ليعاني بعد فترة من فراغ في ضميره ووجدانه ، ثمّ لينقلب ذلك الشعور إلى شعور مبهم.
ويرجع السيد الشهيد (قدّه) ذلك إلى أن الطالب في الحوزة يعيش حياة مدرسيّة خالصة ، تفتقد إلى مؤهلات تنمية الضمير والوجدان نظرياً وعملياً. أما نظرياً فلأنّ مطالب الفقه والأصول (ونضيف إليها المواد المدرسيّة كلّها حتى دروس العرفان والأخلاق على تقدير وجودها) تملأ عقل الإنسان لا ضميره ووجدانه. وأما عملياً فلأنّه لا يعيش تجربة الاتصال بالله تعالى بل كثيراً ما يعيش المبعّدات عن الله تعالى، حتى إذا أصبح مهيّئاً من الناحية العلمية لتجسيد الشعور التفصيلي بالله تعالى، يكون بحسب الواقع قد انقلب عنده حتى ذاك الشعور المبهم ليصبح شعوراً سلبياً في علاقته مع الله تعالى.
2– المشكلة الثانية: فقدان أخلاقية التضحية من أجل المصلحة العامة: يرى السيد الشهيد (قدّه) في “محنته” أنّنا مدينون للإسلام بوجودنا وكلّ ما نملك ، فعلينا أن نصبر على المحن كي لا يتفتّت. ويرى (قدّه) أنّ أبرز العوامل التي تؤدي إلى هدر طاقات الحوزة (بنسبة 80% بحسب تعبيره) واستفراغها في معارك داخلية ضمن إطار يحكم عليه بالفناء يوماً بعد يوم، هو تحكّم عقليّة النـزعة الفردية والخاصة بأفراد الحوزة، وعدم تعاملهم مع هذا الكيان على أساس المصلحة العامة.
ويرى (قدّه) أنّ جو الحوزة نفسَه يساعد على تفعيل مثل هذه العقليّة وإنمائها في اتجاهها السلبيّ، لأنّ جوّ الحوزة ابتداءً هو جوٌّ غير منظم لا بدّ فيه لكل إنسان من أن يبني نفسه بنفسه..
3- المشكلة الثالثة: “النـزعة الاستصحابية” و”فقدان أساليب العمل”: بعد أن يؤكّد السيد الشهيد (قدّه) على أنّ الصيغة النظرية للإسلام صيغة ثابتة فوق التغيّر والتجدّد، بل إنها هي التي تحكم عوامل التغيّر والتجدّد كلَّها، يرى أننا تعاملنا مع الواقع بذهنيّة أصوليّة محضة، حيث طبّقنا على أساليب العمل ما درسناه في مبحث “الاستصحاب” من أصول الفقه.
ويرى (قدّه) أنّ التعامل بهذه النـزعة الاستصحابية جعلنا غير صالحين لمواصلة مسؤوليّتنا، لأنّ مؤدّى هذا التعامل هو التعامل مع أمّة ميْتة انتهت بظروفها وملابساتها، علاوة على أنّ التأثير الفعلي على الأمة الحيّة سيكون تأثيراً سلبياً..
ويؤكد (قدّه) على أنّ موضوع عملنا هو الإنسان الموجود في عالم الخارج الذي يتطوّر وتتغيّر ظروفه وملابساته، فعلينا أن نكيّف أساليب العمل انسجاماً مع ظروفه.
ويركّز (قدّه) على هذه المسألة مظهراً جدّية تامّةً، مرتفعاً بها ليجعلها من أولويّات طالب الحوزة قائلاً بأنّ علينا أن نفكّر بأساليب العمل وفق ظروف الإنسان الخارجيّ تماماً كما نفكّر في مباحث “الترتّب” و”اجتماع الأمر والنهي” في باب أصول الفقه. وما ذلك إلا لأنّنا لا نتعلّم كي نجمّد العلم في رؤوسنا ولسنا عالمين لنعلم، بل لنعمل.
لكنّ سيدنا الشهيد (قدّه) يقرّ بصعوبة طرحه هذا، ويعترف بأنّ الإجابة عن مسألة أصوليّة أسهل لدينا من الإجابة عن هذه الأسئلة، وما ذلك إلا لأنّنا من ناحية تمرّسنا في الأصول و لم نولِ أهمية لما يتعلّق بالعالم الخارجي، ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المهمّة مهمّة دقيقة ومرتبطة بخبرة الإنسان وتجاربه.
و يعود (قدّه) إلى أداة نقد الذات، منتفضاً على واقع الخمول السائد في أوساطنا، ويتعرض (قدّه) منذ 30 سنة إلى ما نعاني منه اليوم بشكل واضح، وهو ظاهرة إفلاس الحوزة اجتماعياً وظاهرة الحقد والعداء التي يظهرها الناس تجاهها. والسيد الشهيد (قدّه)، وإن كان لا يلقي بكامل المسؤولية على عاتق الحوزة، إلا أنه يصرّح بأنّها جريمة الحوزة قبل أن تكون جريمةَ الناس، لأنّ الحوزة لم تتعامل مع الناس الخارجيين، وإنما تعاملت مع أجدادهم. ومن الواضح أنّ الشريعة ربطت مصير العالَم بمصير العالِم لا العكس.
4- المشكلة الرابعة: الطفرة بين المرجعية والطلبة: لا شكّ باتجاه العلاقة بين طلبة العلوم الدينية والمرجع نحو الفتور فالجفاء في حال اقتصار دور الأخير على إعطاء درسه الفقهي و الأصولي وممارسته لبعض ما لا يخرج غالباً عن حد “الروتينيّة”.
و مهما اتّسمت نظرة الطالب إلى المرجع بالإيجابية ، فإنّه لن يعدو كونه إنساناً ذا مشاعر و أحاسيس ، يترقّب من أيّ طرف آخر أن يبدي له اهتماماً بالقدر الكافي معزّزاً له شعوره بدوره في الحياة كمؤدٍّ لدور الأنبياء. و قد أولى السيد الشهيد (قدّه) هذا الجانب اهتماماً بالغاً لإدراكه الآثار السلبية التي يخلفها الفراغ المرتقب..
وكان (قدّه) يرى لزوم الصعود بالحوزة إلى مرحلة تؤهّلها لإدارة العالم كلّه بعد أن لم يكن من الممكن لأيّ كيان آخر تولّي مهمّة إصلاح هذا العالم. غير أنّ وضع الحوزة آنذاك – وكذلك اليوم – لم يكن يخولّها ذلك، إذ “بدت المؤسسة الدينية في النجف متخشبة جبانة إلى حدّ أنها كانت تجهض كلّ محاولة ولو بسيطة وسطحية لتحديث بعض الجوانب أو المظاهر في حياة المؤسسة المذكورة”[5].
وهنا يلوح للسيد الشهيد (قدّه) دورٌ في الأفق و هو في مقتبل عقده الثالث، فيشمّر عن ساعد العمل مؤسّساً من الصفر ، لاعتقاده بـ”ضرورة الفكر أولاً” لأنّه الضامن الوحيد للديمومة والاستمرار. وقد دفع (قدّه) ثمن تصدّيه هذا باهظاً ، متجشّماً بالغَ العناء متحمّلاً الكثير من الأذى من الداخل والخارج على حدّ سواء، غير أنّه مضى متابعاً مطمئنّاً صابراً في الله ولله، يزيده اندفاعاً صدى ما كان يلقاه فكره في مختلف أرجاء المعمورة[6]، إلى أن شاء الله تعالى أن يريحه من غربته المرّة مختتماً حياته المفعمة بالعطاء شهيداً..
ونعود أدراجنا للوقوف على أبرز الحلول التي يمكن تلمسها من رؤاه وسلوكه:
1- التربية والتواصل العاطفي: يرى السيد الشهيد (قدّه) أنّ العلاقة بين المرجع وطلبة العلوم أعمق من أن تتأطّر بالحياة المدرسية الخالصة، لأنهم جميعاً أعضاء منظومة عقائديّة واحدة وتجمعهم مع “تنوّع أدوارهم وحدة الهدف”.
وتأسيساً عليه نجد أنه كان متميّزاً إلى ما يقرب من حدّ التفرّد في علاقته مع الطلاب، حتى قد تخرج هذه العلاقة في الدائرة الخاصة لطلابه عن حدّ الاعتياد. فهو بالدرجة الأولى أبوهم الذي يتابع دروسهم باستمرار، ويتفقّد نشاطاتِهم العلميةَ، ولا يغيب عن باله السؤالُ عن أحوالهم وإن حالت بينهم نوائب الدهر.. وكان يوكل إليهم مسؤولية التصدّي لبعض الأفكار ليشعرهم بدورهم الرساليّ، فيكتب ما يراه صالحاً للردّ لينشر باسمهم.. ولم يقتصر دوره على ذلك، بل خاض في مشكلاتهم كلّها، الخاصة منها وغيرها..
2- تلبية حاجاتهم المعيشيّة: أمّا على الصعيد الطلابي عموماً، فلم يكن (قدّه) يتعامل معهم بأقل من طلابه المقربين إلا بحكم ما يمليه عليه القرب بطبيعته.
وكان (قدّه) يرى ضرورة تفرّغ الطلاب للدرس والتحصيل إلى جانب مواكبتهم لأوضاع المجتمع، فسعى بجهود جبّارة إلى تأمين ما يلزمهم لذلك، وكانت أولى الخطوات محاولة تأمين طعام جاهز يصل إلى المدرسة [لكنه توقف[7]] وغسّالة كهربائية، وكانت هذه الأعمال تعتبر غريبة في وقتها..
أما في ما يتعلّق بمورد تسليم الحقوق أو الرواتب، فإنّ حضور مشهدِ يوم القيامة في قلوب الطلبة ووجدانهم ووقوف الناس في الصفوف متراصّين يومَ الحساب وإن كان أمراً راجحاً في نفسه، إلا أنّ استحضاره في هذا المورد مطلعَ كلّ شهر أمرٌ مرجوح حتماً. ولا يعتقد الكاتب أنّ السيد الشهيد (قدّه) لو قدّرت له حياة أطول كان سيتّبع نظام الصفوف المرصوصة، فهو تعطيلٌ لنعمة البنوك وهدرٌ لوقت الطالب وإساءةٌ لسمعة الحوزة إدارياً وإزكاءٌ لبعض الخلافات..
3- تنظيم أوضاع الدراسة: “يكفي للدلالة على عدم واقعية النظام الدراسي القائم فعلاً أنه نظام لا يفشل فيه طالب ولا يرسب فيه طالب، وأنّ جميع المنتسبين إليه يتخرّجون علماء”[8]..وبحسب تعبير السيد الشهيد (قدّه) فإنّ “جرّ الوجوديّة إلى التعليم النجفي يفتقر إلى معرفة الجار والمجرور”[9].
و علاجاً لهذه المشكلة رأى (قدّه) في “الأطروحة” إنشاء ” لجنة أو لجان لتسيير الوضع الدراسي في الحوزة العلمية، وهي تمارس تنظيم دراسة ما قبل (الخارج) والإشراف على دراسات الخارج، وتحدد المواد الدراسية، وتضع الكتب الدراسية، وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزوية (الحوزيّة) بالمستوى الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق أهداف المرجعية الصالحة وتستحصل معلومات عن الإنتسابات الجغرافية للطلبة وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية العدد”.
وقد عمد (قدّه) إلى تنظيم هذه الأوضاع “عن طريق استقراء للعلماء والأساتذة مع التعرّف على قدراتهم وعددهم، وهذا يوفّر للمرجع الإشرافَ على الدراسة – على الأقلّ – وتنظيمَها فيلجأ الطلاب إلى الهيئة التي أوكلت إليها [مهمة] القيام بعملية الاستقراء هذه لتعيّن لهم الأستاذ المناسب وترشدَهم إليه، كما أنها تعينهم على اختيار المناهج الدراسية التي تعود بمزيد من الفائدة عليهم”[10].
وأمر (قدّه) “بعض تلامذته بتدريس أي مادة علميّة حتى لو كانت أقلّ بكثير من مستواهم العلمي بل كان يهتمّ شخصياً بمراجعة بعض الطلبة له بخصوص تحصيل أساتذة لهم”[11].
كما وأعلن (قدّه) عن:”وضع زيادة في الراتب بنسبة خمسين بالمائة و(ربط) الزيادة بامتحان يتكرّر وتوضع له سجلات ويلاحظ في كل امتحان السعي المستمرّ بين الامتحانين ويزوّد الطالب بشهادة النجاح في الامتحان وسيكون هذا بتطويره مدخلاً لإصلاح الأوضاع الدراسيّة في الحوزة وحفظ الرتب فيها..”[12].
4- إيجاد المراكز العلمية: كان (قدّه) يعمل على تربية جيل متميّز من الطلاب يمكن الاعتماد عليهم في نشر الإسلام عالمياً. يقول في رسالة خطية:”.وإني منذ مدة أفكر في أن من المهمّ جداً تربيةَ جملة والتركيز عليهم ليكون بعضهم من الأساتذة المحققين في الداخل وبعضهم من المبلغين على مستوى العصر في أرجاء العالم..”.
ورأى (قدّه) في “أطروحته إنشاء” لجنة للإنتاج العلمي، (و) وظائفها إيجاد دوائر علمية لممارسة البحوث ومتابعة سيرها والإشراف على الإنتاج الحوزوي (الحوزيّ) الصالح وتشجيعه ومتابعة الفكر العالمي بما يتصل بالإسلام والتوافر على إصدار شيء كمجلة أو غيرها والتفكير في جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة أو التعاون معها إذا كانت في الخارج”.
5- تدوين المتون الدراسية: لعلّ من أجلى مظاهر اهتماماته (قدّه) بالطلاب تصدّيَه لتدوين الكتب الدراسيّة.
وكان (قدّه) يقول بأنه لا بدّ في مثل هذه الأمور من التعامل بعقلية اجتماعية لا رياضية، وأنه لا يمكننا في مقام الاقتناع بتغيير كتابٍ دراسيٍ إقامةُ برهان لزوم اجتماع النقيضين لو لم يدرّس الكتابُ الجديد ، لأنّ هذا الأمر يتعلّق بالحسّ الاجتماعي.
وكان (قدّه) قد أمدّ قديماً “كلية أصول الدين” بمحاضرات في “علوم القرآن” (1964) والحلقة الأولى من “دروس تمهيدية في علم الأصول” أي “المعالم الجديدة للأصول” (1965) الذي تبلور فيما بعد ليخرج باسم “دروس في علم الأصول” أو “الحلقات” (1977) للحلول مكان الكتب الدراسية المتداولة والتي سجّل عليها (قدّه) في “مقدّمة الحلقات” العديدَ من الملاحظات أهمّها ما يتعلّق بالأسلوب والمنهج.
وبعد انتشار “الحلقات” عقد (قدّه) النية على تدوين كتاب دراسي في “الفقه” على وزان “الحلقات” حيث يكتب في رسالة خطية:
“.الأمر الذي جعلني أفكر – على الخط الطويل – في كتابة مشروع مماثل لما يدرّس من الفقه في السطوح أيضاً”
وباشر (قدّه) بتدوين كتاب دراسي حديثٍ في أصول الدين يكتب فيه:
“..وأرجو أن أتوفّق إذا ساعد حالي وأعانت صحتي إلى كتابة كتاب دراسي في أصول الدين فيه المقدمة المعهودة للطبعة الثانية من الفتاوى الواضحة بقدر كبير من أبحاث فلسفتنا [1959] بجزء معتد به من نظريتنا في الأسس المنطقية للإستقراء، لكي يكون كتاباً دراسياً حديثاً في أصول الدين إن شاء الله تعالى”.
وقد حوى هذا الكتاب ذخائر المطالب على ما يبدو حيث يكتب فيه (قدّه) :
” لأني أشعر بأنّ ما تجمّع لديّ من المطالب في ذلك الحقل إذا لم أوفق إلى تسجيله فعلاً فقد لا يسجّل بعد ذلك إطلاقاً.”.
وكان (قدّه) ينوي تداولَه كمتن دراسي في الحوزة مواكبةً منها للمسيرة الفكرية المعاصرة، إلا أنّ السلطة صادرته عند اعتقاله (قدّه).
وينقل عنه أحد طلابه أنه كان يتحسّر على هجر الطلاب لكتاب “الأسس المنطقية للإستقراء” (1972) ويضيف بأنه (قدّه) كان يرغب في أن يتحوّلوا من دراسة “حاشية الملا عبدالله” [مثالاً] إلى دراسة “الأسس” وتحقيقه و مناقشته.
كما وجرى الحديث في رسالة له مع أحد طلابه المقرّبين حول كتاب في الأخلاق يقول فيه:
“.وأما بالنسبة إلى كتاب الأخلاق فأنا أرى أن الحد الأدنى من التعبير السليم إذا كان متوفراً فيه وأن الجانب العلمي للأخلاق إذا كان متضمناً فيه فهو كافٍ ليكون كتاباً دراسياً أو شبه دراسي أو مرجعاً للطلبة أنفسِهم، فإن طلاب الحوزة أنفسَهم بحاجة إلى أخلاق علمية لا وعظية فقط تعمّق تصوراتهم وتعمق (تغني) فكرهم من هذه الناحية..”.
وإذا ارتفعنا إلى مستويات أعلى وجدنا أنّه كان يرى ضرورةَ تنظيم تطوّر علم “أصول الفقه”، متخوّفاً من ظاهرة طغيانه على علم الفقه. وعلى الرغم من أنّ له (قدّه) اليدَ الكبرى في توسعة الكثير من مجالات هذا العلم، إلا أنّه قد يندرج ضمن خطواته الحكيمة في إصلاح الحوزة حيث يجب أولاً إثباتُ التفوّق العلمي التقليدي ليكون غطاءً نفسياً للتجديد. ولعلّه (قدّه) كان ينوي تهذيبَ هذا العلم و إرجاعَه إلى نصابه “منطقاً لعلم الفقه” وذلك على ضوء ما أسّس له في “الحلقات”. والفهم القاصر لمنهجه (قدّه) في الإصلاح قد يسمح لنا – بعد الاستئذان من المعنيّين – باستقراب عزمه على تدريس “الخارج” على ضوء الحلقات في الدورة الأصولية الثالثة[13].
كما ويمكن أن نفهم من مقدّمته (قدّه) على “بحوث العروة” (1971) عدمَ رضاه عن المنهج التقليديّ المتّبع في إلقاء دروس الخارج الفقهيّة منتظراً توفّر “الظروف الموضوعية” لتطوير المنهج ولغة البحث…
ولـ”كم أعطى لهذه الحوزة من روحه! وكم سايرها وداراها لكي يهيئ الظرف المناسب لأداء رسالته” فقد “كانت سياسة الصدر المستنيرِ المجدّدِ أن يساير ويداري النهج التقليدي المسيطر على حوزة النجف الأشرف العلمية، متربصاً الفرصة لكي يثوِّرَ الفقه الإسلامي في مجالاته الفسيحة الأخرى. لكنها كانت الخسارة، فقد اختطفته يد المنون، وهو في ذروة نضجه، ولم تمهله الأقدار لكي يضع حجر الأساس لمشروعه الأساسي في ميدان الدرس الفقهي عامة، هذا الطموح الذي تتطلع إليه الأجيال”[14]…
6- إمداد الحوزات: كان (قدّه) يرى ضرورة نشوء حوزات خارج النجف الأشرف تمثّل الحوزة الأمّ وتعدّ لها الكوادر. وراح يمدّ الحوزات الفتيّة التي تمّ إنشاؤها في مختلف المناطق بالمساعدات والكتب الدراسية اللازمة وغيرها..[15]
7- التواصل مع العلماء: لم يكن فراغ العلماء من دراستهم في النجف تعني له (قدّه) انقطاع علاقتهم مع الحوزة الأم، لأن العلاقة مع الحوزة ذات جذور روحيّة تمتدّ بامتداد الهدف والخط الإسلامي الذي يجمعهما. فالعلماء ممثلون عن الحوزة الأم في المجتمع هدفاً وسلوكاً..
ومن هنا رأى (قدّه) في “أطروحته” إنشاء “لجنة أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء المناطق المرتبطة وضبط أسمائهم وأماكنهم ووكالاتهم وتتبع سيرهم وسلوكهم واتصالاتهم والاطلاع على النقائص والحاجات والفراغات وكتابة تقرير إجمالي في وقت رتيب أو عند طلب المرجع”.
5- المشكلة الخامسة: الطفرة بين المرجعية والأمة: والفراغ الحاصل بين المرجعية والأمّة أشدّ جلاءً من سابقه، بل قد يكون من النادر أن يعرف المقلِّد من شؤون مقلَّده غير اسم رسالته العمليّة أو صورةٍ تم إهداؤها إليه. والتواصل بهذا المقدار لا يفي بتفعيل العلاقة المفترضة بين المرجع والأمّة للوصول إلى الغاية المنشودة. ومن المناسب هنا الحديث عن:
6- المشكلة السادسة: الانعزال عن قضايا المجتمع: المرجع إنسان من لحم ودم ومشاعر تلعب الظروف التي ينشأ ويترعرع فيها دوراً خطيراً في صياغة شخصيته ورسم معالمها وتطلعاتها، وفي تحديد وجهة تعامله مع الواقع. وقد يكون من المبالغة في التعبّد والتقديس تجاهل هذا العامل والإصرار على نفيه.
بعد هذا نقول: مما يزلزل أرضيّة العلاقة بين المرجع والأمّة انعزاله عن قضايا عصره، لأنّ المرجع كما أسلفنا مرجعٌ للواقع بكلّ ظروفه المتقلّبة وملابساته المتغيّرة. وإذا لم يواكب قضايا عصره في مختلف الصعد، فسيصبح بالتدريج مرجعاً للأمّة الميْتة، ما يضطر ابنتها الحيّة إلى اللجوء إلى طرف أجنبيّ تستلهم منه حلول مشكلاتها، وهو ما صرنا نلمسه في عقر دار الحوزة العلمية.
نحن و الواقع: ونحن في هذا لا نرمي إلى تجاهل ما قدمته الأيادي المعطاء لعلمائنا الأبرار، فإنّ معظم من يمكن إبرازه من السلف كنموذج للتدليل على مواكبة المرجعية لعصرها كان بالفعل كذلك إذا ما أضفناه إلى واقعه آنذاك.
إلا أنّ “المواكبة” كما لا يخفى نسبة متقومة بطرفين “بهما امتيازها”، والحال أنّ أحدهما دائم التطور وهو “الواقع”..وعليه فلا ريب بأنّ من تصدّى للماركسية أيام مجدها مواكبٌ لعصره، خلافاً لمرجعية اليوم التي لن تعدّ كذلك حتى تتصدى – بالمباشرة أو الإيعاز- للموضوعات الفكرية الحيّة والمستجدّة والتي لا تعدّ ولا تحصى ومفهوم الواقع الذي يدّعى مواكبتنا له مفهومٌ مشكّك على كل حال، فهو بالنسبة إلى بعضنا قد لا يتعدّى المسجد، فإذا ارتاده كان مواكباً للواقع. وهو الحوزةُ بالنسبة إلى ثانٍ، فإذا اطلع على ما مجرياتها كان كذلك..وهكذا.. وفريق قد لا يعترف بواقع أضيق من أرض الله تعالى بتمامها، وهذا لا يكون مواكباً للواقع في تغيراته إلا بمتابعة شؤون الأرض بمختلف ألوانها ومجالاتها..ويقف على رأس هؤلاء سيدُنا القائلُ بـ”نظرية الواقع الأعمّ” (قدّه)..
نعم، لا شكّ بأن الشخصيات المؤهلة لذلك نادراً ما يجود بها الزمن..
خطوط عامة للحل:
ورد في “المباحث” أن السيد الشهيد (قدّه) كان قد أنشأ “في بيته ضمن العشرة الأخيرة من سني عمره المبارك، مجلسا أسبوعيّا كان يضمّ عينة طلاّبه، وكان يتداول معهم البحث في مختلف الأمور الاجتماعية والقضايا الأساسية، وكانت تطرح في هذه الجلسات الكثير من مشاكل المسلمين في شتى أرجاء العالم، وكان يبرز لمن يحضر هذه الجلسات مدى تبنّي (الأستاذ) الشّهيد لتلبية حاجات المسلمين في كل مكان من البلاد الإسلامية وغيرها، وتفكيرِه الدائب في كل ما ينفع الإسلام والمسلمين، وتخطيطِه الحكيم للحوزات العلمية، ولملأ الشواغر العلمائية في كل بلد يوجد فيه تجمّع إسلامي، ولإرشاد العاملين ضدّ الكفر والطّاغوت في جميع البلدان، وتنشيط الحيويّة في المسلمين جميعاً، وما إلى ذلك”.
هذا ويمكننا – حلاً للمشكلتين معاً – استلهام عدة حلول من رؤاه (قدّه) وسلوكه:
1- التعامل بعقلية اجتماعية لا رياضية: من أهمّ ما ينصح به (قدّه) في مقام العلاج هو أنّنا إذا عزمنا على الدخول في المجتمع لنتعامل مع أمّة اليوم، فعلينا أن نتحرّر من العقليّة الأصولية والرياضيّة التي نتعامل بها داخل الحوزة مع مباحث “الترتّب”، ولننـزل إلى المجتمع بعقليّة مرنة واجتماعية قائمة على أساس الحدس الاجتماعي المتكوّن من الخبرة والتجربة والاطلاع على ظروف العالم وملابساته.
2- “التكيّف مع لغة الأمة”: بعد الفراغ من كون اللغة وسيلةً من وسائل التواصل بين المرجعية والأمّة، كان لا بدّ للمرجعية في مقام التخاطب مع الأمة في “الرسالة العملية” من اعتماد لغتها، بعد أن كانت الرسالة العملية هي “الواجهة النظرية للمرجعية أمام الأمة”[16] وكان من غير الممكن عملياً إلزامُ الأمّة باعتماد اللغة الخاصّة للدائرة الحوزيّة، لكونه نحواً من أنحاء “التكليف بما لا يطاق”.
و”اللغة المستعملة تاريخياً في الرسائل العملية كانت تتفق مع ظروف الأمة السابقة إذ كان قرّاء الرسالة العملية مقصورين غالباً على علماء البلدان وطلبة العلوم المتفقهين لأن الكثرة الكاثرة من أبناء الأمة لم تكن متعلمة، وأما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة قادراً على أن يقرأ ويفهم ما يقرأ إذا كتب بلغة عصره وفقاً لأساليب التعبير الحديث فكان لابد للمجتهد المرجع أن يضع رسالته العملية للمقلدين وفقاً لذلك”[17].
وقد نظر السيد الشهيد (قدّه) في مبرّرات إبقاء الرسالة العملية على ما هي عليه، حيث يواجه المكلّف تعقيداً لفظياً ممزوجاً أحياناً بخلل في التعبير العربي السليم، وغموضاً في تشخيص الاحتياطات قد يعجز عنه فطاحل العلماء، وتفنّناً في التعبير لمجرد الإشارة إلى نكات في مجال الاستنباط مع خلوّه من أي مدلول عملي للمكلّف إضافة إلى تشويشه عليه، وتنقّلاً غامضاً ومربكاً بين الجواز وعدمه وأولوية الترك وعدمها وقرب الوجه وبعده.. وإذا بالمكلّف قد أصيب بدوار أليم..
فلم يصمد أمام سيّد “التزاحم الحفظي” (قدّه) الحريصِ على سلامة مقلّديه – في مقام تزاحم الملاكات وتقديم الأهمّ على المهمّ منها – أيٌّ من هذه المبررات، وذلك بعد تحديده للغرض من وراء طرح الرسالة العمليّة، وهو تعريف الأمة على أحكامها الشرعيّة والحرص على تطبيقها لها لا إرهاقها في تحصيلها. ولما كان تحديد أسلوب الرسالة العمليّة مرتبطاً بتحديد أساليب العمل الاجتماعي، فقد رأى (قدّه) اعتماد أسلوب جديد لم تعهده الأوساط من قبل، محاولاً فيه تفادي المشكلات التي تعاني منها الرسائل العملية التقليديّة.
وكانت الخطوة الأولى “موجز أحكام الحج” (1395هـ) حيث سجّل (قدّه) في المقدّمة عدة ملاحظات في غاية اللطافة تجدر مراجعتها..
أما في الخطوة الثانية، فلم يكتف (قدّه) بكتابة رسالته النموذجية على أساس نظري بحت، بل عمد قبل ذلك – وبعد استعفاء الشيخ محمد جواد مغنية (ره) – إلى عرض بعض النماذج التجريبيّة على مختلف الشرائح الاجتماعية، وكان له تركيز خاص على طلاب الصفوف المتوسّطة..
وبعد أن تحدّدت معالم “الرسالة العملية النموذجية”، يتحرّك القلم الشريف الذي طالما خاطب صاحب الكفاية والعراقي والأصفهاني (قدّهم) في تعقيداتهم، والذي طالما هابته أخطر التيارات الفكرية، نازلاً بإعجاز ووقار من عرشه الفكري العالي ليخاطب عامة الناس وبمستوياتهم الفكرية المختلفة.. وولدت “الفتاوى الواضحة” (1396هـ) التي جسّد فيها سيدنا الشهيد (قدّه) “جانباً من جوانب التجديد في المرجعية”[18]..مقدّماً لها في الطبعة الثانية بـ”موجز في أصول الدين” لشدّ المكلّف إلى “الفقه وأحكامه شداً مبتنياً على الوعي التام”. ثم اختتمها بـ”نظرة عامة في العبادات” ليرى المكلّف بعد مروره على العبادات “ما يبيّن له مضمون العبادة وحاجاته الثابتة إليها”.
ونفذت الطبعة الأولى منها في أقلّ من شهر وطبعت بعد ذلك حوالي ستّ مرات خلال ثلاث سنوات، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على ” مدى عمق تمسّك الأمّة بعقيدتها ورسوخ صلتها بمرجعيّتها القادرة على التفاهم والتخاطب معها”. ومن الملفت للنظر رجوع شرائح من أهل السنّة إلى السيد الشهيد (قدّه) في الفتوى بعد نشر “الفتاوى الواضحة”، فطبعت في مصر، ونفذت بالسرعة نفسها التي نفذت فيها في العراق. “وبعد استشهاده، توقف المشروع الذي لم يصدر عنه سوى جزء واحد ما يتعلق بالعبادات”.
أما دعوى المدّعي كونَ تبسيط لغة الرسالة العملية إلغاءً لمهمة العلماء فمدفوعةٌ لأنّ من ضيق الرؤى والأفق جعلَ فكّ رموز الرسالة العملية واجهةً تحكي عن مهمةِ العلماء ودورِهم خاصةً في عصر التسابق الزمني. ثمّ فليوازَن بين ملاكِ طرح رسالة عمليّة مبسّطة تستفيد منها الأمة قاطبة، وملاكِ إبقاء الرسالة العملية على تعقيدها وحصرِ فهمها – على تقدير حصوله دائماً – ضمن الدائرة الحوزيّة الخاصة إرجاعاً للناس إلى العلماء.. فلعلّه يكون واضحاً لزومُ تقديم ملاك الطرح على ملاك العدم، تقديماً للأهمّ على المهمّ..
أما إذا كان الهدف حكّ أدمغة العلماء وتنمية قدراتهم الذهنية، فلتؤلّف لهم “رسالة نظرية” خاصة تتجاوز في صعوبتها اللفظية “كفاية” الشيخ الآخوند (قدّه)..
ويكفيك أنّه “لو اقتضى التضادُّ توقّفَ وجودِ الشيء على عدم ضدّه توقّفَ الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقّف عدم الضدّ على وجود الشيء توقّفَ عدم الشيء على مانعه، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح.” [19].
3- إنشاء مجالس تبليغية: يقترح (قدّه) على الطلاب تأسيس مجالس تبليغيّة تضمّ خمسة من أبناء المدينة بدل تبذير الوقت في السباحة وإنشاد الشعر، وينتهي (قدّه) إلى أنه لو قام ألفٌ من الطلاب بذلك لتشكّلت قاعدة شعبية تشعر بأنّ وجود الحوزة مصدر خير لها، وبأنّ الحوزة تفكّر بالناس وتهتّم لهم.
4- وسائل الإعلام: لم تغب عن السيد الشهيد (قدّه) أهمية الوسائل الإعلامية المختلفة في تأدية رسالة المرجعية، فكان (قدّه) يتدخّل شخصياً في قضايا نشر الكتب وترجمتها حتى كيفية الطباعة وحجم الحروف لكي تتيّسر الاستفادة منها لأكبر شريحة اجتماعيّة ممكنة. وتعاظمت لديه هذه المسألة – وهو لا يزال في السبعينات – ففكّر في أن تكون “دروس التفسير الموضوعي” منفذاً له إلى الأمة، فجعل يومين من أيام مجلس درسه مجلساً لعامة الناس، وأمر بتسجيل الأشرطة وتمّ نشرها في الأرجاء لأنّ سماع الأمة لصوت المرجعية يقوّي من جذوة العلاقة بين الجهتين[20].
ثم تتحوّل المعادلات.. فالصدر (قدّه) في السبعينات حين وضع مخطّطه الشامل لغزو العالم وعبّأ جيشه الفكريّ وكوادره العاملة، كان يبحث عن وسائل إعلاميّة تفي بغرضه. أمّا اليوم فوسائل الإعلام المتكدّسة تبحث عن مرجع كالصدر ينقذها من براثن المفسدين في الأرض..
ويشار هنا إلى أنّه من الطبيعي وبمقتضى “طبيعة الأشياء” أن يكون الردّ على أيّ فعل بحجم ذلك الفعل. فلا يكفي مثلاً في مقام الردّ على شبهات “الكاتب” والتي بثّت من “الجزيرة” أن يكون الردّ ضمن مدرسة علمية في “قم المقدسة”، لأن صوت “الجزيرة” يطرق آذان الملايين من سكان الأرض، بينما لا يتعدّى صوت “قم” وللأسف الشديد آذان بعضٍ من طلابها..
ومن باب أنّ الشيء بالشيء يذكر، يقول الشيخ محمد جواد مغنية (ره) في “صفحات الفراغ”: “لو كنت المرجع الأعلى في النجف لأنشأت محطة للتلفزيون ومحطة للإذاعة وداراً للنشر ومطبعة على أحدث طراز..نعم محطة للتلفزيون والإذاعة في قلب النجف تؤدّيان رسالة النجف بأحدث الأساليب وأنجحها وتمهّدان السبيل لبلوغ ما تريده النجف من نشر الدين والإسلام”.
5- التواجد الاجتماعي والوكلاء: كما إنّ من جوانب التواصل المذكور إمداد الأمّة بوكلاء عن المرجعية يمثّلونها علماً وسلوكاً صادقاً وأنموذجاً عملياً يحتذى به. ولا ينبغي بوجه قصر دورهم على مهمة قبض الحقوق الشرعية وإبراز إجازات الحقوق والرواية!!
وكان (قدّه) يستهدف “إيجاد امتداد أفقي حقيقي للمرجعيّة يجعل منها محورا قويّا تنصب فيه قوى كل ممثلي المرجعية و المنتسبين إليها في العالم، لأن المرجعية حينما تتبنّى أهدافا كبيرة وتمارس عملا تغييرا واعيا في الأمة لا بد أن تستقطب أكبر قدر ممكن من النفوذ لتستعين به في ذلك وتفرض بالتدريج وبشكل وآخر السير في طريق تلك الأهداف على كل ممثليها في العالم”.
وقد رأى في “أطروحته” إنشاء لجنتين:
الأولى: ” لجنة الاتصالات وهي تسعى لإيجاد صلات مع المرجعية في المناطق الّتي لم تتصل مع المركز، ويدخل في مسئوليتها إحصاء المناطق ودراسة إمكانات الاتصال بها وإيجاد سفرة تفقديّة إمّا على مستوى تمثيل المرجع أو على مستوى آخر وترشيح المناطق التي أصبحت مستعدة لتقبّل العالم وتولي متابعة السير بعد ذلك ويدخل في صلاحيتها الاتصال في الحدود الصحيحة مع المفكرين والعلماء في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وتزويدهم بالكتب والاستفادة من المناسبات كفرصة الحج”.
الثانية: “لجنة رعاية العمل الإسلامي والتعرّف على مصاديقه في العالم الإسلامي وتكوين فكرة عن كل مصداق وبذل النصح والمعونة عند الحاجة”.
6- التصدي لحل مشكلات الأمة: ومن جوانب التواصل بين المرجعيّة والأمّة، التصدّي الدائمُ لعلاج مشكلاتها ووضعِ الحلول لها. ولو صحّ الفصل، قيل على نحو الاختصار: إنّ من مهام المرجعيّة سياسيّاً وتنفيذاً لدورها “الشهادي” رعاية شؤون المسلمين قبل تشكّل المجتمع الإسلامي، والنظر في حاجاتهم المنكوبين منهم خاصّةً، والعمل على تحريرهم من براثن المستعمرين. وينبغي بعد تشكّل المجتمع الإسلامي على يديها إدارتُها له وتنظيمُ أموره والرقيُّ به تحقيقاً للهدف الإلهي. كما إنّ من مهامها فكريّاً مواكبةَ مسيرة الفكر المعاصر لتشخيص الشبهات والردّ عليها بالطرق العلمية الموزونة، بل الانتقال من حالة الدفاع التي تضع الإسلام دائماً في موقع الضعف، إلى حالة الهجومِ والدعوةِ التي تظهر الإسلام في صورته الحقيقيّة قائداً للأمّة إلى خيرها المكتوب لها[21].
ومن المناسب في هذه الظروف أن يكون للمرجع جهازٌ علميٌّ ضخمٌ يضمّ نخبة المتخصّصين كلٌّ في مجاله الخاصّ، لأنّ الجامعيّة الفكريّة في المرجع نادرة التحقّق عادةً..
أما السيد الشهيد (قدّه) فيعتقد بأنّه “ليس لحياة أيّ إنسان قيمة إلاّ بقدر ما يعطي لأمّته من وجوده وحياته و فكره”.وقد كان (قدّه) مثالاً نادراً لمن أفنى شمعة وجوده من أجل أن تبصر أمته:
أ- فكرياً: أما من جهة الاطّلاع والشموليّة فقد كان السيّد الشهيد (قدّه) مثالاً رائعاً لـ”الفقيه المثقف”، وكان يقول :”إنّ ما تعارفت عليه الحوزة من الاقتصار على الفقه والأصول غير صحيح، ويجب عليكم أن تتثقّفوا بمختلف الدراسات الإسلامية”. وقد طالت اهتمامُه مختلفَ الحقول المعرفيّة ابتداءً من الفقه الذي كان “كالعجينة في يده” وأصول الفقه الذي تبلورت نظرياته فيه وهو دون سن العشرين، مروراً بالفلسفة التي أبدع فيها باكراً وابتكر فيها منهجاً معرفياً جديداً، والاقتصاد الذي كان أوّل من طرق بابه في الساحة الإسلامية، والاجتماع (غير أنّ “مجتمعنا لم يسمح بإخراج مجتمعنا”)، والرياضيّات التي هضم أعقد مسائلها لوحده، والتاريخ الذي سبر غوره بقديمه وحديثه، وصولاً إلى القصص البوليسيّةً[22] ومجلات الأطفال[23]…
ومن جهة التصدّي الفكري تراه (قدّه) من شبابه يرفِد جسر العلاقة بين الحوزة والأمّة بما يرسّخ في ذهنها بأنّ لديها من يذبّ الخطر عنها. فترى الأمة كلّها قد دانت لفضل الصدر بعد إصداره لـ”فلسفتنا” و”اقتصادنا” تصديّاً للمدّ الأحمر الذي غطّت سحبه آفاق البلاد.. ولم ينسَ الصدرُ الحكيمُ أن يضيف جهوده إلى الأمّة ليشعرها بأنّ لها وجوداً يرعاه علماؤها، فأبى أن يتصاغر مستخدماً “ياء” المفرد لأنّه “ضمير المتكلمين جميعاً”، ولهذا قال “فلسفتنا” .. “اقتصادنا”.. “رسالتنا” و”مجتمعنا”.. وقناعة الساحة السنيّة به (قدّه) ألجأت وزارة الأوقاف الكويتية إليه للتنظير لفكرة تأسيس بنك إسلامي.. ولا ينبغي أن يغيب عنّا “المدرسة الإسلامية”، وتصدّيه لبيان “المحنة” أبان خطر التهجير.. إلى حين تصدّيه لكتابة “الإسلام يقود الحياة” أبان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران..
ومما ينبغي التنبيه إليه أنّ السيد الشهيد (قدّه) في الوقت الذي كان يعتقد فيه بـ”ضرورة الفكر أولاً”، قإنّه كان يوازي بين المدى النظري للأمة وبين مداها العملي. فقد كان (قدّه) “يستطيع نسف الفلسفة الأفلاطونية، بل كان قد بدأ بذلك على مستوى الأحاديث والأبحاث الخاصّة بينه وبين بعض طلابه، ولم يبرز ذلك على شكل كتاب لأن قسماً من الناس يؤمنون بالله من خلال هذا الطريق فلم يجد ضرورة أو حاجة تستلزم الخوض في هذا الموضوع”[24]. وعندما سئل عن “كتابة بعض الأبحاث الفلسفية (ف) أجاب بأن الإسلام اليوم لا يحتاج إلى أفكار، إنما يحتاج إلى قائد، وكان ذلك قبل انتصار الإسلام في إيران”[25].
لكن عندما تنضج العقول للغوص العلمي النظري وتتهيّأ الظروف للسير بإزائه عملياً، ينتقل الصدر (قدّه) بجيوشه الفكريّة من مرحلة الدفاع والتصدّي الآني إلى مرحلة الهجوم والقيادة. فبعد فراغه من سياسته الدفاعية في الخمسينات والستينات، ينتقل في السبعينات إلى تنفيذ مخطّطه الهجومي الضخم، ممهّداً لغزو الفكر الغربي “الرومي” بـ”ثمرة عمره” “الأسس المنطقية للاستقراء” الذي ملأ فيه “فراغاً في الفكر البشري دام ألفي عام” والذي أوضح خلاله “تهافت نظرية البرهان الأرسطية، كما عالج بنبوغ أخطاء التفكير الغربي في تفسيره لنظرية الاحتمال. وقدم بالتالي نظرية متكاملة في تفسير حساب الاحتمال أقام على أساسها بناء متكاملاً لفهم جديد لنظرية المعرفة البشرية بكامل تفاصيلها. فثار على أرسطو في بيئة تقدس نظرية القياس الارسطية، وهضم قمة الانتاج الغربي واقفاً على نقاط الضعف في تفكير أساتذة المنطق الحديث أمثال راسل ، وكينـز، وأعطى للبشرية طرزاً جديداً من التفكير”[26].
وقد كان الأسس نواة “دراسة حديثة تفصيلية عن الفلسفة الإسلامية المعمقة مقارناً مع أدق وأحدث نظريات الفكر الفلسفي القديم والمعاصر كان قد شرع في تحريرها في ضوء منطق الاستقراء” كان قد بدأها ببحث دقيق ورائع حول “كيفية تحليل الذهن البشري”، وكان (قدّه) قد عقد العزم على أن يغزو بها العالم فكرياً بعد أن كان “يتحفّظ على كثير من آراء السلف، ورغم تحفظه العام تسرّبت على لسانه الكريم أسرار تطلقها كلمات موجزة، أصغى إليها بعض المقربين من طلابه، تنبئ بتحوّل كبير سيطرأ على نظرية الوجود وأبحاث الميتافيزيقيا، وقد كان السيد الشهيد في خيفة وتردّد وهو على أعتاب طرح هذا التحوّل. ولعلّ العقل لم يبلغ الرشد الكافي لقبول تلك الأفكار فقدّر ربّ العقل لتلك الأفكار أن تلحق في عالمه، وبقيت نفوس مخلصة تتوق إليها، عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً”[27]…
وتتمّ مصادرة هذه الدراسة المقارنة القيّمة .. ويُهجَر كذلك كتاب “الأسس”..وللمرّة الثانية يتوقّف إنفاذ جيش “أسامة”، وكأنّ الأقدار شاءت أن تبقى “الروم” منه في راحة.. ويلقى نبيّ “أسامة” ربّه، و”أسامة” في “جرف المدينة” إلى يومنا هذا ينتظر من ينفض الغبار عنه..
أما اليوم فإنّ ظهور الكثير من الآراء التجديديّة والشاذة غالباً، لا يرجع بالضرورة إلى خبث أصحابها ولؤمهم على الدين كما يحلو لبعض أوساطنا الحوزيّة أن تصوّره، إذ قد يكونون مخلصين في ما يذهبون إليه.. غاية الأمر أنّ خلوّ الساحة نسبياً ممن يشبع حاجاتها الفكريّةَ من أبناء الحوزة يؤدي إلى ظهور الشبهات..
ب- سياسياً:نقول إجمالاً: إنّ شهادته (قدّه) وإن كانت تكفي دلالة على اهتماماته السياسية، إلا أنه لا بأس بالتذكير بأنّه كان –قديماً- يتابع من لبنان ما ألمّ بالنجف الأشرف حتى استطاع تحريك قضيّة النجف على صعيد العالم العربي[28]. وكان في أوائل الستينات يتابع تحرّكات الإمام الخميني (قدّه)[29]، ولم يغب عن اهتماماته كلّ من الساحة الفلسطينية[30] والمصرية[31] واللبنانية[32] ، وكذلك الأفغانية[33]. وكم أثلج قلبَه الكبيرَ انتصارُ الثورة الإسلامية في إيران[34].. فانصرف إلى سدّ حاجاتها الفكريّة في “الإسلام يقود الحياة” لانشغال المسؤولين الإيرانيين بتركيز دعائم السلطة الجديدة. و تواصل مع الإيرانيين العرب درءاً للفتن و داعياً إياهم للانضواء تحت لواء الإمام الخميني (قدّه)..
7- عالمية الطرح: وفي إطار مشروعه العالمي، نجد أن السيد الشهيد (قدّه) كان يعمل على غزو البحار[35]. وقد قام (قدّه) ضمن هذه الرؤية بالعديد من الخطوات لتعزيز هذا التطلع ، منها:
أ- النـزعة الاجتماعية العالميّة في الفقه: كان السيد الشهيد (قدّه) يعتقد بأنّ “استنباط كثير من الأحكام الشرعيّة لا بدّ وأن يقوم على أساس النـزعة الاجتماعية والعالميّة في فهم الأحكام من أدلّتها، لا على أساس النـزعة الفرديّة الضيّقة، وأنّ كثيراً من أدلّة الأحكام الشرعيّة لو نظرنا إليها وفق النـزعة الاجتماعيّة العالميّة اختلف فهمنا لها عمّا إذا نظرنا إليها وفق النـزعة الفرديّة الضيّقة”[36].
ويرى (قدّه) أنّ “الفقيه بسبب ترسّخ الجانب الفردي من تطبيق النظريّة الإسلاميّة للحياة في ذهنه واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله عَكَسَ موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة فاتخذت طابعاً فردياً وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد وكأنّ الشريعة ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل له الفقيه فحسب وهو الجانب الفردي من تطبيق النظريّة الإسلامية”[37].ولعلّ السيد الشهيد (قدّه) من أبرز المنادين بما يسمّى حالياً بـ”فقه النظريّة”.
ب- غزو شرائح الأمة: نكتفي بالقول بأنّ سيدنا الشهيد (قدّه) يرى بأنّ على المرجعيّة أن تنـزل من برجها العالي لمخاطبة الأمة ومشاركتِها مشكلاتها والالتحامِ بها وقيادتِها نحو غايتها.
وبعد التذكير بما أسلفناه حول “التكيّف مع لغة الأمة”، نكتفي هنا بالإشارة إلى ما ورد في إحدى رسائله (قدّه) من تكليفه بعض تلامذته “الأكفّاء للتوفّر على تصنيف مجموع روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام إلى أقسام وفعلاً بوشر بالقسم الأول وهو ما نطلق عليه اسم “صحيح أهل البيت” ويشتمل على روايات يتوفّر فيها أولاً صحة السند على جميع المباني الرجاليّة والأصوليّة المتعارفة؛ ثانياً عدم شذوذ المتن وعدم كونه مخالفاً للمشهور المتبنّى من علماء الإماميّة؛ ثالثاً عدم وجود أيّ تحفظّات تجاه المتن نابعة من الحساسيّة والذوق الإسلامي أو من وجود بعض المحاذير الإعلاميّة. وهذا القسم سوف يكون غذاءً روحيّاً صافياً وعطاءً تربويّاً متقناً ويمكن تقديمه إلى الأمّة كثقافة مربيّة مضمونة الصحّة إلى حدٍّ كبير وكواجهة فكريّة لمدرسة أهل البيت وطهارتها ونقائها..”.
ج- غزو الدوائر المتعلّمة: يؤمن السيد الشهيد (قدّه) بأنّ الحوزة مهما حاولت غزو المجتمع، فستبقى بعض الأوساط والدوائر الخاصة بمنأى عن متناولها. غير أنّ هذا لم يحدّ من طموحات هذا العالم البصير، فارتأى إيجاد علماء في الفقه والأصول والمفاهيم الإسلاميّة في سائر أصناف الناس، ليكون كلٌّ من هؤلاء مصدر إشعاع في صنفه، فليكن في الحوزة أطباء علماء ومهندسون علماء ..
وكان يرمي (قدّه) من ذلك الإسراع في تربية علماء يملكون ثقافة عصرية إلى جانب ثقافتهم الحوزويّة (الحوزيّة)، والارتفاع بالمستوى الاجتماعي للحوزة العلميّة لأنّ وجود عناصر ذات مستوى رفيع في نظر المجتمع كالأطباء والمهندسين، سوف يغيّر من نظرة أولئك الذين يحملون انطباعاً سلبياً عن الحوزة [38].
د- غزو الساحة السنية: إن عالميّة الطرح قد تعني للكثيرين التنازل عن المبدأ والعقيدة، ولكنّها عنده (قدّه) مستفادة من عالمية الدين الإسلامي نفسِه، ولا تعدو كونها صفة لعملية الدعوة والتبليغ. وكان (قدّه) قد قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، غير أنّه لم يسلم من الانتقاد والاتهام التعسّفيّين..حتى قد يحاوَل لاحقاً إثبات اتجاهه (قدّه) نحو التسنّن..
ويكفي في مقام دفع هذا التوهّم – الناجم في أفضل محامله عن عدم دراية بحقيقة هدفه ومشروعه (قدّه) – ذكرُ ما يصرّح به نفسُه بعد انتشار “الفتاوى الواضحة” حيث يكتب:
“..وقد تحقّقت بدايات بعض الآمال التي أسعى إلى تحقيقها فإنّي كنت أفكّر أنّ المرجعيّة النائبة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا استطاعت أن تقدّم أحكام الشريعة في إطار فقه أهل البيت إلى العالم بلغة العصر ومنهجة العصر وبروح مخلصة فسوف تستطيع أن تقنع عدداً كثيراً من أبناء السنّة بالتقليد للمجتهد الإمامي باعتباره اجتهاداً حياً واضحاً على مستوى العصر وبذلك يكون نائب الإمام الصادق مرجعاً للمسلمين عموماً كما كان الإمام كذلك ويكون هذا التقليد مرحلة للانتقال إلى التشيّع الكامل وهذا ما تحققت بعض بوادره لأنّ بعض المدرسّين المثقّفين من السنّة في بغداد راجعوني طالبين تحويل تقليدهم من أبي حنيفة إلى الفتاوى الواضحة وعلى هذا الأساس فقد قرّرنا طبع الفتاوى الواضحة في القاهرة إن شاء الله تعالى..”[39].
ومن آثار رؤاه هذه تبريكُه افتتاحَ جناح لكتب الإماميّة في دار الكتب المصريّة والذي سيكون “نافذة لأفكارنا وفقهنا وثقافتنا المكنوزة..”[40]..
وقد استطاع السيد الشهيد (قدّه) بمنطقه الهادئ ونقاشه الموضوعي البعيدِ كلّ البعد عن الأسلوب المنفّر السائد حالياً في ما يسمّى تجوّزاً بـ”مجال البحث العلمي”، الحضورَ بشكل بارز في الأوساط السنيّة[41]..بل حتى الإسرائيليّة[42]!!
هـ- غزو الكوادر العالمية: كان السيد الشهيد (قدّه) مصرّاً على إعطاء الحوزة العلمية صبغة “العالميّة”، وقد وجد أنّ التواصل مع الكوادر الفكريّة ذات الشهرة العالميّة يعزّز هذه الصبغة في نظر هؤلاء، ومن الطبيعي أن يؤدّي ذلك إلى عدم إمكانية تهميش الحوزة العلمية والنظرِ إليها بـ”دونية”. فتراه (قدّه) يتواصل بشكل مستمرّ مع كبار رجالات الفكر العالميّين من قبيل “روجيه غارودي” و”زكي نجيب محمود”[43] وغيرِهما. وسينجلي لديك بوضوح كيف تغيّرت نظرة هذه الطبقة إلى الحوزة بعد أن رأوا أنّ فيها من يفكّر ويتصدّى، إذا قرأت ما جرى مع الدكتور الفنجري وعصمت سيف الدولة وغيرهما..[44]
8- المساهمة في تشخيص الموضوعات: نقول إجمالاً: إنّ تشخيص الموضوعات وإن كان بيد المكلف نفسه وخارجاً عن مهام المرجعيّة نظرياً، إلا أنّ هذا قد لا يصلح عذراً لترك المكلَّف يصارع مشكلاته وحيداً. فبدل أن يكون الإفتاء في بعض الموارد تقليديّاً على نحو “إن كان فيه دهن خنـزير فيحرم وإلا فلا” فحسب، فلا بأس بأن تردف الفتوى بعبارة “وقد أرسلنا مندوبنا للتحقّق من المسألة وتبيّن كذا” نظير ما قام به (قدّه) من إرسال مندوبه للتحري حول جبنة “كرافت”..
7- المشكلة السابعة: المشكلة المالية: لقد لعبت الأموال المقدّمة إلى المرجعيّة – من حقوق شرعيّة وغيرها- دوراً إيجابياً بارزاً على مرّ الأزمنة في تلبية الحاجات المختلفة للأمة الإسلامية من قبيل مساعدة الطبقات المعوزة والنهوض بالخدمات الاجتماعية ومدّ كوادر الجهاد وغير ذلك ممّا يضيق المقام عن ذكره.
وبعد الشهادة بالتحسّن الكبير الذي طرأ مؤخراً على تحديد أولويات الصرف، يبقى الإلماع إلى ما قد يلاحظ على بعض آليات الصرف؛ وذلك بعد الإشارة إلى أمرين:
أ– إنّ النظر إلى قضية صرف الأموال في أية مؤسسة تعتمد في تحركها الاجتماعي على العنصر المالي – ضمن ما تعتمد عليه من عناصر- تارةً يتّسم بـ”المورديّة الجزئية” وأخرى بـ”الموضوعية الكلية”.
ب- افترض في المقام تفادي النظر إلى المسألة المالية في البساط الشيعي عموماً والحوزيّ خصوصاً نظرةً تجزيئية.
بعد هذا نقول: إنّ ما قد يلاحظ في هذا المجال هو إمكانية الحدِّ من موارد الصرف وصبِّ الإمكانات في مراكز قوى ليفضيَ إلى خدمات أكبر وصدى أوسع، وذلك باستبدال الآليات الموضوعية للصرف بالآليات التجزيئية[45].
وقد كان بالإمكان تناول المٍسألة المالية في الحوزة من مظاهرها المتعددة، من استثمار رؤوس الأموال وتحديث آليات القبض والصرف – على الطلبة وغيرهم-؛ إلا أننا نقتصر في هذه المقالة على الإشارة إلى المورد الذي تتلاقح فيه جملة من المفاهيم “المطاطيّة” ليتفتّق عنها نحوُ هدرٍ معتبر في الأموال الشيعية والحكم على قسمٍ منها بالضياع في جملة من القنوات التي قد لا تتعدى أحياناً الأطر الشخصية. ولعلّ من مناشئ هذا الوضع، تحكّمَ النـزعة التجزيئية في طريقة التفكير عموماً، ليس فيما يتعلّق بالمسألة المالية فحسب، بل بكلّ ما يمتّ إلى مسائل الإدارة بصلة.. ومن هنا فإننا نسلّط الضوء على الأسلوب المعهود في منح المرجعية الوكالات والإجازات.. ونحاول أن ننظر إليه من مجهر السيد الشهيد (قدّه)..
يرى السيد الشهيد (قدّه) أنّ من آثار العلاقة السائدة بين المرجعية ووكلائها انقلاب علاقتهما إلى “سنخ علاقة عامل المضاربة بصاحب رأس المال”[46]) حيث تجتمع كما قلنا جملة من “النسب” و”المفاهيم المطاطيّة” التي من شأنها أن تتكيّف بسهولة مع الواقع النفسي للوكيل، والذي قد يحدو به إلى توسعتها أحياناً..
فـ “الربع” و”الثلث” و”النصف” وإن كانت في نفسها مفاهيم محددةً، إلا أنها مطاطيّةٌ بلحاظ “مدخولها” و”متعلّقها” الذي تارةً يكون ديناراً وأخرى ألفاً وثالثة مليوناً..
كما لا يقلّ مطاطيّةً عن هذه النسب مفهومُ “الشأنيّة” الذي يطالعنا بين الحين والآخر، والذي يسهل على بعض النفوس توسعته لمنازعة قارون في ماله وثروته، وكسرى في إيوانه.. ومن الواضح أنّ هذه الآليات تسبح كلّها في سماء ملبّدة بسحب النـزعة التجزيئية في التعاطي مع المسائل الإدارية.
وفي مقام وضع حلّ للمشكلة المالية عموماً – والتي تركنا إجمالاً الحديث عنها – اقترح (قدّه) في “أطروحته” إنشاء لجنة مالية “تعنى بتسجيل المال وضبط موارده وإيجاد وكلاء ماليين و السعي في تنمية الموارد الطبيعية لبيت المال وتسديد المصارف اللازمة للجهاز مع التسجيل والضبط”.
أما فيما يتعلّق بمحلّ الكلام – أي مسألة الإجازات والوكالات -، فقد اقترح (قدّه) استبدال صيغة جديدة بالطريقة التقليديّة[47]) – بتغطية مصاريف الوكيل من الحقوق وعطايا الناس-، وذلك بتغطيتها عن طريقين:
1– الأول: راتب شهريّ مقطوع يكفل له قدراً معقولاً من حاجاته الضروريّة.
2- الثاني: عطاء مرن وغير محدّد وقد لا يعطى أحياناً، والمؤثّر فيه عدة أمور مذكورة في “الأطروحة”. هذا ويتمّ تحويل الحقوق كاملةً إلى المرجعية، ديناراً كانت أم مليوناً مع استحقاق الوكيل لراتبه الشهري على أيّ حال…
ونكتفي بهذا المقدار من الحديث مع كونه متعدّدَ الجوانب نظرياً، متظافرَ الشواهد ومرَّها واقعاً..
هذا وقد لا تبرز الحاجة إلى الاستدلال على ضعف هيكلية هذا النحو السائد من التعاطي مع المسألة المالية، بعد أن كان كافياً إلقاءُ نظرة سريعة إلى الواقع الخارجي المليئ بالفوضى المالية.. وما قد يدّعى من عدم إمكان إصلاح الوضع القائم واعتماد آليات موضوعية يفتقد إلى مبرّر منطقي، وذلك بعد أن كان إمكانه مشهوداً في أجهزة أخرى لا تقلّ ضخامة عن الجهاز المرجعي. ولعلّ غاية ما يمكن التمسّك به لتفسيره ظاهرةً هو العامل النفسي المترسّخ في نفوسنا وعقلياتنا، والقاضي بالتعبّد على إطلاقه أزماناً وأحوالاً..
8- المشكلة الثامنة: “الحواشي”: إنّ من الطبيعي جداً أن يحتاج الإنسان – أيّ إنسان – في مقام احتكاكه وتعاطيه الاجتماعي إلى يدٍ تعينه على إنجاز أعماله ومهامه مهما صغرت. فكيف الحال بمن أملى عليه واجبه الديني التصدّي للأخذ بيد الناس، حيث تتسع المساحات التي ينبغي أن يملأها بما ينسجم مع الهدف والغاية الكامنة من وراء تصدّيه. ومن هنا نشأ إلى جانب المرجعية الدينية في مقام تصدّيها ما صار يعرف فيما بعد بـ”الحاشية” التي راحت تعنى بمساعدة المرجعية –إجرائياً- في تحقيقها لأهدافها السامية. وقبل اتساع رقعة العمل المرجعي، كان التشكّل العفوي للحاشية إلى جانب المرجعية كافياً بلحاظ ضيق رقعة العمل. أما بعد اتّساع هذه الرقعة، فقد طرأ الكثير من المستلزمات التي راح يمليها الواقع الخارجي، لكن دون أن يطرأ على روح الحاشية ما يرتفع بها طردياً لموازاة عملية الاتساع. ونعكف هنا إلى التعرّض إجمالاً لوجهة نظر السيد الشهيد (قدّه) في مختلف جوانب الموضوع:
1- عفوية الحاشية وافتقادها للتخصّص: إنّ “حاشية المرجعيّة” كما يراها السيد الشهيد (قدّه) في “أطروحته” وبحسب الغالب، عبارةٌ عن “جهاز عفويّ مرتجل يتكوّن من أشخاص جمعتهم الصدف والظروف الطبيعية لتغطية الحاجات الآنيّة بذهنيّة تجزيئيّة وبدون أهداف محدّدة واضحة”. وغالباً ما ينتج عن هذه العفويّة تشكّلُ مجموعة من الأشخاص إلى جانب المرجع تعوزها الخبرة والتخصصيّة لإدارة شؤون المرجعيّة، فيسري هذا العجز إلى تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها والتي تترقّب الأمّة تحقّقَها. وينجم عن عدم وضوح رؤى الحاشية مسبقاً جملةٌ من المشكلات التي تؤدّي تدريجيّاً إلى ضياع الآمال المعقودة على “مرجعيّة الأمّة”.
وفي مقام علاجه لهذه المشكلة، اقترح (قدّه) في “الأطروحة” “إيجاد جهاز عملي تخطيطي وتنفيذي للمرجعية يقوم على أساس الكفاءة والتخصّص وتقسيم العمل واستيعاب كل مجالات العمل المرجعي الرشيد في ضوء الأهداف المحددة.ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلاً عن الحاشية”. ويضمّ هذا الجهاز الجديد مجموعة من اللجان مرّ الحديث عنها في “الحلقة الأولى”.
2- الاعتماد المطلق على الحاشية: في ما يتعلق بالمسائل الاجتماعية التي يتحدّد على ضوئها مسير الأمم ومصيرها، لا بدّ من التثبّت من فكرة كفاية المعذّرية الأصوليّة أمام المولى تعالى، وكفايةِ ثقة المرجع بحاشيته لتبرير إطلاق العنان لها – في الجملة – في تنفيذها لمهام المرجعية، خاصةً إذا كان منشأ هذه الثقة “أصالة صحة عمل المسلم”.. والزلل الذي قد يحصل في الحاشية – لا سمح الله تعالى – سيؤدّي إلى التضحية بالأهداف الحقيقيّة للمرجعيّة برأسها، وإن بقي الهيكل على حاله شكلاً.وهذا بروحه يرجع إلى ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة من تحكيم العقلية الأصولية في القضايا الاجتماعية.
ونشير هنا إلى ما يقوله السيد الطهراني (قدّه) من أنه “لم يعد متصوراً له (أي للعالِم) إمكان التخطّي عن هذه الحلقة (كذا في الترجمة) المحاصرة بأي وجه من الوجوه، فينقطع اتصاله مع عامة الناس، وينحصر ما يعرفه عن الناس بما يقوله الخواص فقط، فيتحوّل ذلك الوالي والحاكم إلى ما يشبه الخاتم بيد أولئك الخواص… وينحصر – في النتيجة- طريق تطبيق فقاهة ورأي ذلك الفقيه وسرايتهما إلى الخارج عبر بوابة أفكار الجماعة المحيطة به”[48].
نعم، لا شكّ بأنّ هناك مقداراً مبرّراً بالنظرة الأولية للأمور، تتحكم بنشوئه وظهوره طبيعة العمل الإداري الذي يقتضي التعددية رؤىً وسلوكاً..ونحن نجد أنّ المعصوم (عليه السلام) كان يبتلى بذلك أيضاً. لكنّ الملاحظة المذكورة تعود لتطفو إذا ما تخطّينا الأمر إلى مرحلة متقدّمة أي مرحلة “ما بعد الخلل” حيث الكلام في عدم الرقابة الجديّة – غالباً- والمتابعة الحثيثة والمطالبة الصارمة..
ونقطة التمايز إجمالاً أنّ الحركة بين المرجع وحاشيته نزولية بلحاظ وصعودية بلحاظ آخر: فهي نزولية بمعنى أنّ على الحاشية أن تعمل وفق توجيهات المرجعية التي يفترض أن تتوفّر مسبقاً على هيكلية واضحة المعالم في تعاطيها الاجتماعي غيره، لا العكس. وهي صعوديّة فيما يتعلّق بالمعطيات التي ينبغي توفرّها لدى المرجع، إلا أن حصر المرجع لقنواته المعلوماتية بحاشيته خلل لا بدّ من تفاديه.
وعلى الرغم من نجاح السيد الشهيد (قدّه) في الجملة في تربية جيل واعٍ ومتميّز من طلابه ممّن نهل من بحره (قدّه) الأهداف الحقيقيّة للمرجعية، إلا أنّ هذا لم يكن ليعني له الوقوف عند مبدأ “الوثاقة”. والمتتبّع لهذه المسألة في سيرة السيد الشهيد (قدّه) يرى بشكل واضح وعجيب معاً كيف كان (قدّه) يتابع تفصيلياً صغريات القضايا الموكولة إليهم فضلاً عن كبرياتها. فقد كان (قدّه) يعتمد على معاونيه مع احتفاظه بقنواته الخاصة البعيدة عنهم، والمأخوذة من القراءة والمتابعة الشخصيتين.
ومن الأمثلة اللطيفة لمتابعاته صغريات الأعمال، تدخله لتحديد حجم خط وصفحات أحد كتبه كما يظهر من إحدى رسائله الخطية، بل إنّ السيد الشهيد (قدّه) كان يتواجد شخصياً في المطبعة لدى طبع بعض كتبه كما يظهر من مذكرات بعض تلامذته..
3- الطابع العائلي للحاشية: بعد افتقاد الحاشية للتخصّص والكفاءة غالباً واعتماد المرجعية – غالباً- على مبدأ “الوثاقة” فحسب، كان من الطبيعي أن تتشكّل إلى جانب المرجعية حاشية ذات طابع عائلي ورحمي، وذلك لثقة المرجعية بأرحامها على أفضل تقدير، أو جرياً مع الأمور على طبعها وقرب الأرحام من المرجعية على تقدير آخر..
وبحسب تعبير السيد الطهراني (قدّه) فإنّه “كثيراً ما يكون بعض الأشخاص المتصلين بالوالي هم من أبنائه والمنتسبين إليه، ممّن لا يحتمل صدور المخالفة منهم أصلاً، ويخال أعمالهم كأعماله في الصحة والاتقان، أو هم من كتّابه. أو من المسؤولين عن صندوق ماله ممّن يطمئن إليهم تماماً. لذا، تراه لا يقتنع بكلام الآخرين فيما لو ذكروا له عيوبهم، ولا يتقبّل عدم استقامة ذلك الشخص الفلاني الذي يعرفه منذ أكثر من ثلاثين سنة مثلاً”[49].
وقد تنبّه السيد الشهيد (قدّه) إلى خطورة هذه الظاهرة التي تؤدي شيئاً فشيئاً إلى سلب سمة الموضوعيّة عن المرجعيّة، وصبَّ سلوكه في الاتجاه المعاكس الذي ينـزّه موقعها عن مطلق ما يحتمل توجيهه إليها من هذا القبيل.
فها هو يمنع السيد محمد الصدر (ره) عن تكرار الصلاة جماعة في الناس حال غيابه لأنه “تعارف لدى قسم من أئمة الجماعة الاستعانةُ في غيابهم بنائب عنهم يختار من أقربائهم أو أصحابهم لا لنكتة موضوعية..بينما لا بدّ من كسر هذه العادة وحصرِ إمامة الجماعة في إطار موضوعي صحيح..”[50] وقال (قدّه) يومها بعد مدحه للسيد محمد (قدّه) :”إن هذا المكان ليس ملكاً لعائلة .. وإذا متّ فليختر الناس لإمامتهم من يشاؤون”[51]. أمّا على صعيد المرجعيّة فملاحظة العناصر الفاعلة معه (قدّه) تكفي للخروج بفكرة نبذ الرحمية والعائلية. والكلام في الرحميّة يجري في القوميّة أيضاً، لكنّنا نعرض عنه لضيق المقام عن ذكره..
4- انغلاق الحاشية: إنّ المهام الخطيرة التي تنتظر المرجعيةَ تملي عليها اختيارَ حاشية نموذجيّة من ذوي العقول الواعية الذين عاشوا هموم العالم وقضاياه الفكريّةَ وغيرَها، وذلك كي لا يتحدّد دورهم – وبالتالي دور المرجعيّة – داخل بعض الأزقة والأروقة والمساجد. ومهما كانت شخصيّة المرجع استثنائيّة، إلا أنّ ابتلاءها بحاشية من هذا القبيل سيفضي إلى حرمان الأمّة – لا سمح الله تعالى- من بركات وجودها ومن المغانم المأمول تحقّقها على يديها..
وقد سعى السيد الشهيد (قدّه) في هذا الإطار إلى تنشئة مجموعة من الطلاب ممّن تتوفّر فيهم كافة الصفات والمؤهّلات، ويحملون الهموم والأهداف الحقيقيّة للمرجعيّة من أجل تشكيل “جهاز عمليّ تخطيطيّ وتنفيذيّ” يحلّ مكان “الحاشية” التقليديّة.
ومن الشواهد على نموذجية جهازه بهذا اللحاظ، انتدابه (قدّه) أحد طلابه – المرحوم الشيخ يوسف الفقيه – “لمناقشة كتاب الأسس المنطقية للاستقراء مع وزارة الثقافة المصرية ممثلةً بالفيلسوف زكي نجيب محمود ليصبح مقرَّراً في جامعة عين شمس والجامعات المصرية لأنّه أول كتاب أثبت وجود الله (تعالى) بالاستقراء”[52].
وكذلك إيفاده السيد محمود الهاشمي (حفظه الله) “للمشاركة في مؤتمر لحلّ المشاكل الشرعية المصرفية التي واجهها البنك الإسلامي للتنمية في السعودية 1977”[53].وليس ذا بغريب، إذ من الطبيعي أن تسري النموذجية من المرجع إلى جهازه.
5- المرجعية على نحو المعنى الإسمي[54]: وممّا قد ينجم عن ضبابية رؤى الحاشية، التعامل مع المرجعيّة على نحو المعنى الاسميّ ونسيان الأهداف الحقيقيّة التي تشكّلت المرجعيّة من أجل تحقيقها. وكان من الطبيعيّ أن ينبثق عن هذه المسألة عدّة أمور:
أ- الجمود عند الألقاب: وهو وإن كان أمراً غير ذي بال بالنسبة إلى ما يأتي، إلا أنّ للإشارة إليه وجهاً. وبحسب تحليل أحد العلماء، فإنّ الظروف والأوضاع السياسيّة أبان مرجعيّة السيد محسن الحكيم (قدّه) أملت على مجموعة العاملين معه – ومنهم السيد الشهيد (قدّه) – استخدامَ بعض الألقاب التي كان من شأنها لفُّ الناس حول مرجعيته (قدّه) في مواجهة نظام عبدالكريم قاسم[55].
ونكتفي هنا بالقول بأنه (قدّه) قد حاول تغيير هذه الظاهرة ضمن ما كان يستهدفه من “تغيير الواقع بقوله وفعله”[56] ، خاصةً عندما يكون مصدر هذه الألقاب “حاشية المرجعية” نفسها. ومن هنا أفهم (قدّه) مقربّيه وطلابه بضرورة التخلّص من هذه الظاهرة ولو جزئياً، فلم يجد ضرورة لطبع عبارة “سماحة آية الله العظمى” على غلاف “الفتاوى الواضحة”[57]، وأمر بنـزع غلاف كتاب اقتصادنا الذي طبعت عليه إحدى دور النشر البيروتية صورته ونبذة عن حياته[58] ، كما وحضّ على الاختصار في الألقاب “مهما أمكن” لأن “الوجود الحقيقي لا يحتاج إلى ألقاب”[59]..نعم، ما ندعيه من تمايز السيد الشهيد (قدّه) عن غيره، إقدامه العملي على هذه الإجراءات.
ب- إلغاء مرجعية الآخرين: وفي هذا الاتجاه نصطدم بأثر سلبي آخر من آثار التعامل الاسمي مع المرجعية يفوق أخواته فتكاً وتدميراً. فقد تغفل حاشيةٌ أحياناً عن الهدف الحقيقي لمرجعيّتها نتيجة عدم وضوح الهدف الحقيقي لديها، فتتسم نظرتها إلى المرجعيات الأخرى بشيء من السلبية التي تتفاوت شدةً وضعفاً.وهذه الظاهرة وإن كان يشتدّ تجلّيها -حين تتجلّى- في وسط الحاشية عادةً، إلا أنّه في الواقع نحوٌ من أنحاء التجلي في الفرد الأكمل، لأنّ هذه الظاهرة تطالعنا في الوسط الحوزي نسبياً، والذي جرى ديدن بعض شرائحه على ذلك وللأسف الشديد.
وها هو التاريخ يفتح دفتيه والألم يعتصره لكي يسمعَنا آهات السيدِ العلامة الطباطبائي (قدّه) ويحدّثَنا عن معاناة السيد الإمام الخميني (قدّه) ولوعات الشيخ المظفر (قدّه) وزفرات الشيخ المطهري (قدّه) وأنّات قلب السيد الشهيد (قدّه).
السيد الشهيد (قدّه) مظلوماً[60]): والسيد الشهيد (قدّه) – الذي هو محور بحثنا – ممّن كان فريسةً لهذه الظاهرة الفتّاكة، والتي لاحقته من مجتمعه الحوزيّ “بغية تحطيمه” من أيام كتابته في “الأضواء”، حتى اشتدّت عليه بعد تصدّيه.
وقد اتّسم تعامله (قدّه) تجاه ما ألمّ به بالصمت والتحمّل، ولم يصلنا شيء من قبله حول هذا الموضوع إلا من خلال بعض الرسائل الخطية التي كان قد أرسلها إلى بعض مقربّيه، والتي تخلو – مع عكسها لبعض الواقع المرّ على نحو الإخبار- من أيّ نحو من أنحاء التبرّم الهجومي ومحاولة الأخذ بالثأر، حيث “لا بدّ من التحمّل على أيّ حال” – على حدّ تعبيره (قدّه)-.. والذي يظهر أنّ السيّد (قدّه) كان شديد الحذر في تعامله مع أبناء نوعه – على حدّ تعبيره ويقصد أبناء الحوزة-، وكان يتجنّب الخوض في ما يوجب استفزازهم (أي نتيجةً و أثراً) إلا ّ لمصلحة أهمّ..
وقد صارح (قدّه) الشيخ محمد جواد مغنية (ره) -بعد إلحاح الأخير إثر تعطيله (قدّه) لدرسه- قائلاً:”إنّ الأوساط الحوزوية (الحوزيّة) أصبحت لا تتقبلني ولا تحبّ أن أستمرّ في التدريس، وإذن لا داعي لأصرّ على استمراري في الدرس”، وقال إنّ “هناك معاداة كثيرة ومحاربة كثيرة من أبناء نوعنا عليّ وعلى طلابي في شتى الأنحاء الحوزويّة”، وقد أعطى بعض النماذج..وقال”هكذا يحاربوني ويحذّرون الطلاب مني، لذا إذا كنت مغضوباً عليه من قبل الأوساط الحوزويّة ومن أبناء نوعنا إلى هذه الدرجة فلا داعي لاستمراري في الدرس، فليأخذوا راحتهم في انتخاب (اختيار) من يريدون من الأساتذة الآخرين.” [61]
ومع أنّ ما وصلنا نزرٌ يسير ممّا ألمّ بهذا القلب المعذّب، غير أنّنا نجده -فيما وصلنا- يصف نفسه قائلاً:”إنّ مَثَلي مثلُ الشجرة جذرها منخور [مشيراً إلى ما يتعرض له] وأغصانها وارفة الظلال مثمرة [مشيراً إلى ما حقّقه]”.
يكتب (قدّه) سنة 1960:”لقد كان بعدك أنباء وهنبثة وكلام وضجيج وحملات متعددة جندت كلها ضدّ صاحبك [يعني نفسه] وبغية تحطيمه..”.
ويقول :”لقد بلغت من العمر ما بلغه أبي وأخي فلم لا يعاجلني الموت ويريحني”.
ويكتب:”ولولا رضا الله سبحانه وتعالى لتمنّيت أن ألتحق بالأحبة الذين سبقوني إلى الرفيق الأعلى واستراحوا من همّ الدنيا وغمّها..”
وكذلك :”..ويخيّل لي أنّ من الشاقّ أو الغريب أن يتكلّف الإنسان من أجل أن يزيد في حياته التي قدّر له أن يعيشها في خضم المحن والآلام، وقد كان الموت يبدو لي دائماً أيها العزيز خلال هذه الفترة شيئاً مريحاً ومحبباً..”
ويكتب:”إنّ العذاب الذي قدّر لحياتي أن تمتزج به والتمزّق الذي قدّر لقلبي أن يعيشه سوف يمدّني بقدرة أكبر على التضحية بتلك الحياة الممزّقة المتوهّجة بالألم، وهكذا كلّ إنسان يعيش حياة الألم يكون أقدر على التسامي والتضحية لأنه يضحّي بحياة زاخرة بالمنغّصات، والحمد لله ربّ العالمين وإنا لله وإنّا إليه راجعون”[62].
ويكتب:”صحتي جيّدة وإن كانت الظروف النفسيّة متعبة خصوصاً مع المضاعفات التي ينتجها المغرضون عن قصد والأصدقاء ومدّعو الصداقة لا عن قصد أو عن نصف قصد على السواء، وكان من نتيجة هذه المضاعفات ما لا يحمد عقباه من الإشاعات والافتراءات التي تلصق بأبي مرام [يعني نفسه]..”
ويقول :”أما الأوضاع في النجف فلا تسألوا عنها بل قيسوا الحاضر بالماضي فإنّ أبحاث النجف معطّلة بعد القضيّة الأخيرة – وإن كانت مباحثتنا مستمرّة ولكنّا نقلناها إلى السرداب- وسوق السبّ والشتم عامرة إلى آخر الأمور المؤذية والمشوّشة من جميع الجهات”.
ويقول:”فلو كنت تعلم ما نواجهه هنا من مزعجات وإيذاءات من أشخاص كثيرين مما لا يمكنني أن أستعرضه لهان عليك ما ذكرت فهو ليس – علم الله- إلا شيئاً يسيراً من المزعجات التي نواجهها والتي جعلتني في بعض لحظات الضعف التي تنتاب كلّ إنسان – عدا من عصمه الله- أودّ أن أهاجر من النجف إلى قرية من القرى، ولكن لا بدّ من التحمل على أي حال..”.
وقد استعر عليه الوضع حتى قيل فيه ما لا يليق، ثم طالت الإيذاءات كلّ من تلبّس بعنوان التتلمذ لديه (قدّه) حتى اضطرّ إلى تعطيل درسه ونقله إلى السرداب حفاظاً على طلابه بعد اعتذاره بعجزه وشيخوخته وهو ابن الأربعين [63].. ولا يقف الأمر عند هذه الحدود، فيتّهم أعندُ وأكفأُ خصم عرفته الماركسية والرأسمالية معاً بالعمالة لأمريكا[64] أو الاتجاهِ نحو التسنّن، وينعته بعض أبناء الحوزة الذين قضى من أجلهم بـ”الضحالة العلمية” وكتبَه بـ”الكتب الأدبية” أو “الجرائد” وذلك توهيناً لا لنكتة موضوعية، بينما يُحني مناوئوه الغربيّون رؤوسَهم إجلالاً لنبوغه وموضوعيته ويعتمدون كتبه مصادر أساسية في أصرحتهم العلمية كالسربون مثلاً[65].. وعندما اتُهم بأنه يريد إذلال العمامة وإخضاعها إلى ماله، يحوّل درسه إلى مجلس وعظي يشرح فيه باكياً حقيقة ما يقوم به من أجل رفع شأن العمامة..
وعلى كل حال، فإنّ القلب الذي فاق في وسعه أرض الله تعالى و سماءه[66] وفي إطار ردّة الفعل، لم يحِد عن الموضوعية قيد أنملة لوضوح رؤاه وطمأنينة قلبه.بل يشير على عالمٍ جليلٍ أراد تأليف كتاب في “مثالب العلماء” بالترك لأنّ العلماء لن يفلحوا بعدها.
وقد كان السيد الشهيد (قدّه) نتيجةَ وعيه العميق ورصده الدقيق لمجريات الأمور، مدركاً حقيقة المكائد التي تحاك له -عن عمد أو غير عمد- حاملاً نسّاجها على الشبهة المصداقية.. وفي هذا الجوّ الحسّاس، يأتي دورنا قراءً موضوعيين في إخضاعه (قدّه) إلى امتحان في غاية الخطورة والحساسية، وذلك على ضوء ما تلاه على مسامعنا في “محاضرة المحنة” حين أفاد بأنّ التعامل مع المحنة تارةً يكون ذاتياً (ذووياً) وأخرى موضوعياً..
و من الأمور الواضحة في هذا المجال أنّ السيد الشهيد (قدّه) كان يتحلّى بدرجة عالية من الإخلاص جعلته يترفّع عن المسائل المتعلقة بشخصه. و هذا النحو من التعامل مع واقعه نتيجةٌ طبيعية لموقع الصدر كفقيه مفكر صاحب رؤية شاملة علوية للسنن التي تقوم على أثافيها الحياة في صراعاتها. و الصدر في ظلّ هذه الرؤية لا يخلع عن نفسه –تفكيراً و تعاملاً- لباسَ الآخرةِ ، مآلِ كدحه، ويجعل هذه الرؤية منطلقاً حاكماً على نحو تفاعله مع المنغصّات التي كان يتلقّاها من محيطه..
فقد كان الصدر (قدّه) “يمارس على الصعيد الداخلي (حوزوياً [حوزيّاً] ومرجعياً) درجة عالية من التفهم والصبر والتحمل والاعتدال ورفض الانفعالية والسماح بظواهر التسيب والانفلات للأمور، وهو ما يجعلنا نضع الصدر في قائمة الصدارة على هذا الصعيد إلى جانب العلامة الطباطبائي الذي واجه هو الآخر مشكلات داخلية عديدة..” [67].
ومن أمثلة ما قلناه أنّه كان لا يزال يعتقد بعدالة أحد تلامذته الذي انقلب عليه وراح يعرّض به[68].. ولا يتجاوز ردّه على أحدهم – حين يطلب من السلطة التخلّص منه (قدّه) كي لا يكون هناك خميني آخر في العراق- الحدودَ الموضوعية حيث يقول ” غفر الله لك يا فلان، إن قتلوني اليوم، قتلوكم غدا”[69]..كما تبقى علامات الهدوء مرتسمةً على وجهه عندما تبقى يده المسلِّمةُ ممدودةً في إحدى المجالس.. أو عندما تضيّق دون جلوسه المجالس.. حتى اتّهم من قبل بعض مريديه بالإفراط في التواضع.. لكنّ ذلك كان يبدو أمراً طبيعياً في فلك الرؤية الأخروية التي أشرب بها الصدر نفسه قلباً وعقلاً..
وقد تفتّق عن هذا الهدوء وقوع مثيري بعض الحزازيات في مأزق ميداني أفقدهم فعالية أدواتهم، وذلك عندما نفض الصدر قلمه الواعي وملأه من مداد تقواه ليملي على نفسه سؤالاً مفترضاً حول علاقته بأستاذه المقدّس، فكتب يقول ضمن جواب طويل :”..فلست إلا ثمرة من ثمرات وجوده وفيضه الشريف وولداً من أولاده الروحيين..”[70] وذلك لكي يقرّب لهم بأنّ المسألة لا تتعلّق بالأشخاص..
وقد وافق (قدّه) – في مقام الإخماد – على طوليّة مرجعيّته[71] وعدمِ “مزاحمة” المرجعية العليا، وشدّد على طلابه عدم طرح اسمه في عرض تلك المرجعية بل حرّم على بعضهم “أن يدخلوا في باب المقارنة بينه وبين تلك المرجعية”[72]..وكان إذا خرج بعضهم عن تلك الطوليّة، عمد إلى تذكيره وتنبيهه[73]..
هذه الأمور كلّها تعكس مدى الوعي التقي –إن صحّ التعبير- الذي كان يتحلّى به (قدّه) في تعامله مع هذه الأمور. فقد كان الصدر في وعيه تقياً وليس كل الواعين أتقياء.. وكان في تقواه واعياً وليس كلّ الأتقياء واعين..
نعم هذا كلّه كان يجري بعيداً عن شخص أستاذه الذي قال فيه إذ كان شاباً يافعاً:”إنّ هذا الرجل فلتة، هذا الرجل عجيب فيما يتوصّل إليه وفيما يطرحه من نظريات”[74]، بل وقد احتجّ به أمام بعض من عيّر النجف بعلماء الأزهر و”دكاترتها” قائلاً:”النجف تفتخر بالسيد محمد باقر الصدر فمن عندكم في قباله؟”[75] وقال أيضاً:”السيّد الشهيد (الصدر) مظلوم لأنّه ولد في الشرق وإلا لو كان مولوداً في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغرب فيه”[76]..
ولنعم ما نظمه فيه الشيخ الوائلي (حفظه الله):
(ولاقاه أبناء العقيدة بعدما قضى العمر في تكريمهم بجفاء).
المرجعية على نحو المعنى الحرفي[77]: وهنا يأتي دورنا مرةً أخرى في إخضاع السيد الشهيد (قدّه) إلى امتحان صعب هو الآخر، وذلك بعد أن قلنا بأنه حاول إفهام بعض الأطراف بأنّ مسألة المرجعية ليست مسألة شخصية. فتحتّم علينا أن نرى إذا كان (قدّه) قد التزم بذلك فعلاً..
في نظر السيد الشهيد (قدّه) “ليست المرجعيّة الصالحة شخصاً وإنما هي هدف وطريق و كلّ مرجعية حقّقت ذلك الهدف والطريق فهي المرجعيّة الصالحة التي يجب العمل لها بكلّ إخلاص”. ولقد كانت نظرة السيد الشهيد (قدّه) إلى القيام بشؤون المرجعيّة “نظرة حرفيّة باعتباره سبيلاً لخدمة الإسلام” لا أكثر.
لكن لا يمكننا بطبيعة الحال إخراج السيد الشهيد (قدّه) منتصراً من الامتحان إذا ما اقتصرنا على الجانب النظري، لوضوح أن التنظير شيء والالتزام عملاً شيء آخر، وبعد أن كنا نروم من دراسة هذه المسألة لحاظ الجانب العملي..
وستقف إن شاء الله تعالى على الأبعاد الأخلاقية والتوحيديّة المدهشة والمحيّرة التي قلّما تتحقّق بهذا المستوى العالي والراقي[78]، حيث كان من آثار هذه الرؤية استعداده للتنازل عن مرجعيته – مع لياقته الكبرى لها – للمرجعيّة التي تحقّق بنظره أهداف الإسلام..
يقول (قدّه) لطلابه في هذا الصدد:”يجب أن لا تتعاملوا مع هذه المرجعية [يعني مرجعيته] بروح عاطفيّة وشخصيّة وأن لا تجعلوا ارتباطكم بي حاجزاً عن الموضوعيّة بل يجب أن يكون المقياس هو مصلحة الإسلام، فأيّ مرجعيّة أخرى استطاعت أن تخدم الإسلام وتحقّق له أهدافه يجب أن تقفوا معها وتدافعوا عنها وتذوبوا فيها، فلو أن مرجعيّة السيد الخميني مثلاً حقّقت ذلك، فلا يجوز أن يحول ارتباطكم بي عن الذوبان في مرجعيّته”.
ويقول أيضاً:”..ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أن مرجعيّة السيد الخميني التي جسّدت آمال الإسلام في إيران اليوم لا بدّ من الالتفافِ حولها والإخلاصِ لها وحمايةِ مصالحها والذوبانِ في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم..والميدان المرجعيّ أو الساحة المرجعيّة في إيران يجب الابتعاد بها عن أي شيء من شأنه أن يضعّف أو لا يساهم في الحفاظ على المرجعيّة الرشيدة القائدة”.
ويكتب (قدّه) :”..وبعد ذلك أحسست بأن السيد الخميني أصبح في موضع حدّي وفاصل بحيث لا بدّ من تأييده من الناحية الدينية .. لأن سقوطه لا سمح الله يعني في الوقت الحاضر سقوط الكيان الديني كلّه فأبرقت له برقية مفصلة..”.
ويكتب (قدّه) :”حضرة آية الله العظمى الإمام المجاهد الخميني دام ظلّه..ونحن…نضع جميع وجودنا وإمكاناتنا في خدمة وجودكم العظيم والنهضة الإسلامية المقدسة”.
وكان (قدّه) يقول:”لو أنّ السيد الخميني أمرني أن أسكن في قرية من قرى إيران أخدم فيها الإسلام، لما تردّدت في ذلك، إنّ السيد الخميني حقّق ما كنت أسعى إلى تحقيقه..”.
وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة بأسبوع، أرسل (قدّه) أحد طلابه لتقديم التهنئة إلى الإمام الخميني (قدّه) وقال له:”إنّ العمل (هو) ما صنعه الإمام الخميني، ويجب على الجميع أن يكونوا في خدمة الإمام ولا حاجة إلى دعوة أحد إلى تقليدي لأن الهدف من الدراسة والمرجعية هو إقامة حكم الله وقد حققه الإمام الخميني. (و) الهدف من المرجعية ليس هو قبض الحق الشرعي وتوزيعه أو تدريس الفقه وأصوله، بل المسؤولية الكبيرة التي يجب أن نفكر فيها هي إقامة حكم الله..” [79].
خاتمة:
وفي خاتمة هذه الجولة القصيرة يمكننا تسجيل عدة نقاط:
1- إنّ ظاهرة النقد تعكس عند السيد الشهيد (قدّه) سلامة البنية الفكرية والنفسية لأية شريحة اجتماعية تعتمد النقد عنصراً حيوياً في حركتها التكاملية. و هوبطبيعة الحال مأخوذ على نحو الطريقية من أجل تحقيق نتائج أفضل. ونحن عندما نطلق كلمة “النقد” إنما نعني بها النقد الموضوعي بشرطه وشروطه.
كما أنّ من الواضح إيمان السيد الشهيد (قدّه) بضرورة طرح البديل في عرض المشروع النقدي لعدم إيقاع الناس في فراغ فكري وعملي.وبحسب نقل أحد تلامذته، فقد كان لديه (قدّه) “إشكال أساسي على التفكير الكلامي بأسره”[80] وكذلك على الفلسفة الأفلاطونية بحيث إنّه لو وفّق إلى بيان إشكالاته وطرح البديل، لشهد العالم المعاصر ثورة فكرية جديدة، إلا أنّه لم يقدم على نسفهما آنذاك إيماناً منه بضرورة مراعاة التدرّج في الطرح..
2- لقد كان واضحاً لدى السيد الشهيد (قدّه) وهو يمارس عملياً نقده الموضوعي في طريقة التفكير المعهودة، وجودُ تفاوت بين مقامي القول والعمل، فطرح في “حبّ الدنيا” بصوته الباكي سؤالاً حيّاً إلى يومنا هذا :”نحن نقول إننا أفضل من هارون الرشيد، أورع من هارون الرشيد، أتقى من هارون الرشيد، عجباً ! هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد؟ يا أولادي .. يا اخواني..يا أعزائي.. يا أبناء علي (ع)..هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا..عرضت علينا دنيا هزيلة”.
3- لقد كان السيد الشهيد (قدّه) صادقاً مع نفسه في تعامله مع الأفكار التي يطرحها، وكان يظهر في مرحلة تلقّيه لنقد الآخرين موضوعية يغبط عليها، فيجيب على نقد حادّ ولاذع وجّه إليه كاتباً :”.. قرأت رسالتك مراراً عديدةً وأظنّ أنها تركت في نفسي نفسَ ما تركه في نفس الإمام أمير المؤمنين قولُ عضده المجاهد مالك الأشتر حين رآه قد ولّى أولاد عمّه على أمصار المسلمين ، فقال: على ماذا حاربنا الشيخ بالأمس؟. أنا أظنّ أنّ الشعور الذي تركه كلام الأشتر في نفس صاحبه هو شعور الارتياح الممزوج بألم عنيف أو هو الألم الممزوجُ بالارتياح، ارتياح لأنّ في الأصحاب من يراقب ويسدّد، وألمٌ نتيجة لرغبة الشخص في أن يحيط أصحابه بوجهة نظره كاملة غير منقوصة، هذا مع فارق في المسألة كبير بين صاحبك وصاحب الأشتر، وهو أنّ صاحب الأشتر معصوم..”[81]
ولكنّ التمادي في التحامل عليه كان يثقل قلبه ليرجو الالتحاق بالرفيق الأعلى.
4- لقد كان السيد الشهيد (قدّه) على قناعة تامة بأنّ الحوزة وحدها هي التي تستطيع بـ”مرجعيتها الرشيدة” أن تنهض بالأمة الإسلامية..وكان (قدّه) يأمل أن تنهض الحوزة العلمية إلى المستوى الذي يؤهلها أن تتحمّل كبريات مسؤولياتها. يقول السيد الحائري (ده):” سُئل ذات يوم في بيت المرحوم السيّد عبد الغني الأردبيلي (قدس سره) وكنتُ حاضرَ المجلس: متى تقوم الحكومة الإسلاميّة في العراق؟ فأجاب: لا تقوم الحكومة الإسلاميّة في العراق إلا إذا نضجت الحوزة العلميّة على مستوى الإشراف أو إدارة الحكومة الإسلاميّة”[82].
5- إنّ المشروع الذي بدأ به السيد الشهيد (قدّه) في أوائل السبعينات كان – على صعيد التخطيط – أقدم عهداً من ذلك، لأنّ هذه الأفكار كانت تساوره من أيام شبابه، حيث كان (قدّه) قد “كتب لدى نعومة أظفاره رسالة وضّح فيها نقائص الحوزة العلميّة في النجف الأشرف ووضع حلولها وطريقة تنظيمها وترتيبها ومضت الأيّام والليالي إلى أن أصبح على أبواب المرجعيّة وعثر صدفة ضمن كتاب من كتبه أو في مكان آخر على تلك الرسالة وكان عدد من طلّابه -وأحدهم أنا (السيد الحائري) – متشرّفين بخدمته في بيته في العمارة الذي كان ملكاً لسماحة الشيخ المامقاني (حفظهاللَّه) في الغرفة الفوقانيّة من قسم البرّاني الذي كان قد اعتاد على عقد جلساته الخاصّة هناك، فقرأ علينا تلك الرسالة وقال: إنّ قيمة هذه الرسالة عندي فعلاً قيمة تاريخيّة وكانت الرسالة حقّاً تجسّد همومه وآلامه وآماله وطريقة وضعه للحلول وفقاً للمشاكل منذ نعومة أظفارهظ[83].
6- إنّ تجربة السيد الشهيد (قدّه) – كغيرها من تجارب العظماء- تستحقّ منا أن نتناولها بالدراسة والتحليل. وهي – كغيرها كذلك من تجارب العظماء- قابلة للملاحظة والنقد الموضوعي الذي ينصبّ على الأفكار ويهمل الأشخاص. ويعتقد كاتب السطور بأنّها كانت في الجملة تجربة ريادية تخطّت حدود الزمان والمكان اللذين نضجت داخل أسوارهما.
7- إنّ ما اصطلح عليه مؤخراً بعض المفكرين بـ”أزمة الخطاب الإسلامي المعاصر”، يحتاج اليوم إلى متصدٍّ يمتلك إلى جانب عمقه العلميّ وعياً شاملاً لآليات انطلاق وتحرك التيارات الفكرية المعاصرة. ومن المؤسف جداً أن نرى عياناً انتساب الشريحة العظمى من المتصدّين إلى غير الكيان الحوزيّ، بعد أن كان ذلك واجب الحوزة قبل أن يكون واجبهم. وإن لم نأمل بأفضل من تصدّي السيد الشهيد (قدّه) للمدّ الأحمر في الخمسينات ، فلنأمل بمثله ، أو أدنى..
8- في نهاية المطاف نورد ما يقوله بحقّه السيد الإمام الخميني (قدّه) الذي كان يراه “من مفاخر الحوزات العلمية، ومن مراجع الدّين و مفكّري المسلمين”، إذ يقول (قدّه):”كان السيد محمد باقر الصدر مفكراً إسلامياً فذاً ، وكان مؤملاً أن ينتفع الاسلام من وجوده بقدر أكبر، وأنا آمل أن يقرأ المسلمون ويدرسوا كتب هذا الرجل العظيم”[84]. ويختزل السيد القائد الخامنئي (حفظه الله تعالى) ما استعرضناه كلَّه بعبارة جامعة قائلاً:”..يحقّ لكلّ مجمع علميّ أن يرفع رأسه فخوراً بما قدّمه إنسان كبير كهذا العالم الجليل.. ما كان يمتلكه من كفاءة غير عادية ودأب قلّ له نظير جعل منه عالماً متعمقاً في ألوان الفنون ولم ينحصر ذهنه البحّاث رؤيته الثاقبة في آفاق علوم الحوزة المتداولة، بل أحاط بالبحث والتحقيق كلَّ موضوع يليق بمرجع دينيّ كبير في عالمنا المتنوع المعاش، خالقاً من ذلك الموضوع خطاباً جديداً، وفكراً بكراً، وأثراً خالداً. درّة علم وبحث، وكنـز إنسانيّ لا نفاذ له، لو بقي ولم تتطاول إليه اليد الآثمة المجرمة لتخطفه من الحوزة العلميّة، لشهد المجتمع الشيعيّ خاصة والإسلاميّ عامة في المستقبل القريب تحليقاً آخر في سماء المرجعيّة والزعامة العلميّة والدينيّة”[85].
دعوة: في نهاية المطاف لا يفوتنا توجيه نداء ملحّ إلى ذوي الأهلية عموماً وطلاب السيد الشهيد (قدّه) خصوصاً – الذين تجرعوا في كنفه حلاوة و مرارة تجربته الرياديّة – ، داعين فيه إلى النهوض من أجل تكملة مشروعه الشامل قراءةً ونقداً وتكملةً، لأنه “من الطبيعي ان المجددين الكبار يرحلون قبل ان يتموا مشاريعهم الكبرى لان مشاريعهم الفكرية والحضارية هي دوماً اكبر من اعمارهم وتحتاج إلى اجيال عديدة تستوفي اغراضها على يديها ، ولكن مع ذلك لابدّ من توجه صادق وقوي نحو هذه المهمة حتى نحقق بعد سنين نتائج مثمرة على هذا الطريق”[86]، وإننا “لا نجد من يتحمل مسؤولية إكمال المرحلة التاريخية التي بدأها الشهيد الصدر في ثورته الفكرية المباركة”[87].
فـ”فلسفتنا” الحديثة تحتاج إلى صدر جديد يخرجها عن حدّ “الامتناع” مخاطباً عقول العالَم المعاصر ..
وكذلك “اقتصادنا” الحديث لتحديد معالمه في الألفية الثالثة..
و”مجتمعنا” الذي لم يكن “مجتمعنا يسمح بإخراجه” صار خروجه ضرورياً في ظل الثورة الإسلاميّة..
وكذلك “البنك اللاربوي” المقرّر كتابته في كنف الحكومة الإسلامية ..
و”الفتاوى الواضحة” التي أراد فيها الصدر (قدّه) المقارنة بين معاملات الإسلام و النظام الوضعي مقدماً بـ”خطوط عن اقتصاد المجتمع الإسلامي[88].
ولا يغيب عنّا “صحيح أهل البيت عليهم السلام” الذي لم يعلم مصير الجزء الأول منه، والذي تمّ تدوينه.
وكذلك مشروع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي أراد له (قدّه) أن يطال عدداً محدوداً من المواضيع المهمة يستوعب كلٌّ منها بين خمس إلى عشر محاضرات، بعد أن كان يشعر “بأنّ هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي”[89] بشوط يستوعب التفسير التجزيئي التقليدي.
ومن خدمات هذا المشروع – لمن يعتقد به ضمن إطار الحوزة- تدريس الخارج على ضوء الحلقات..وكذلك تكملة مشروعه في قراءة الفقه قراءة شاملة بعد أن “فقد تجديد الفقه الإسلامي في شخص محمد باقر الصدر مفكّره الأكثر ألمعية وتألقاً”[90].
وممّا ينبغي المبادرةُ سريعاً إلى تفعيلِه وحمله على محمل الجديّة تداولُ “ثمرة عمره” كتابِ “الأسس المنطقية للإستقراء” في الأوساط الحوزيّة، وشرحُه بياناً للعرش ثمّ نقشُ العرش بالتحقيقات الوافية والمناقشاتِ العلميةِ، وتطويرُ أفكاره خاصةً بعد أن تمّت صياغة نظرية الاحتمال في الثلاثين سنة المنصرمة صياغاتٍ رياضيةً جديدةً وتنقيحُها وتعديلُها، بعد أن صار “واضحاً للمشتغلين في علوم الشريعة مدى أهمية دراسة الاستقراء، ونظرية الاحتمال في مجال اشتغالهم، اذ أدخل الفقيه المجدد الراحل السيد محمد باقر الصدر نظرية الاحتمال وتفسير الدليل الاستقرائي على أساس تلك النظري من باب واسع على علوم الشريعة -سواء منهج البحث علم الاصول أم البحث الفقهى، أم علم الحديث والرجال- وأضحت مواقع أهم كبريات البحث الاصولي ترتهن أساساً بالموقف المختار في نظرية الاحتمال”[91].
نعم إنّ “السيد باقر كان إنساناً”[92].. إنساناً ولد متمخضاً عن معاناة الأيام و عذابها.. و ليس متوقّعاً من الأيام النُفَساء أن تنجب لنا و هي في نِفاسها المديد صدراً جديداً عند كل فجر ، لأنّه لا يبزغ إلا عند الفجر الصادق من “رأس كل قرن”..
وقد “مثّل باقر الصدر نموذجاً متميزاً من منظّري الساحة وعلماً بارزاً في سماء نهضتها الفكرية وانبعاثها الحضاري”[93]، و “شكل بالفعل ظاهرة فريدة واستثنائية في تاريخ الفكر الإسلامي بشكل عام، ظاهرة قدمت الكثير على طريق تأصيل الفكر الديني وتجديد الوعي الإسلامي والإنساني، إلا أن هذه الظاهرة لم تلق بعد الاهتمام المطلوب من قبل الباحثين والدارسين وهذا ما يؤسف له. (و) لو كُتب للشهيد الصدر حياة أطول، لكانت، بالتأكيد، حياتنا الفكرية والثقافية أكثر إضاءة وتألقاً مما هي عليه الآن..” [94]، والتحسّر الشكور لا ينفي على أيّ حال وفرة مشاريعه التي يعوزها من ينبعث في الأمة مكملاً مشروع الإصلاح حتى يظهر الله دينه على الدين كلّه..[95]
والحمد لله رب العالمين
أحمد أبو زيد
(*) قد حتّم ضيق المقام تركَ الإشارة إلى المصادر غالباً وإن كان عمدتها “المباحث” و”سنوات المحنة” و”شهيد الأمة”. كما حتّم تجاوزَ بعض العناوين المثبتة في أصل البحث من قبيل: ظاهرة “النقد الذووي” (الذاتي) و”تقبّل النقد” التي عمل (قدّه) على إرسائها في الحوزة ، والمرجعية الموضوعية واختلاف الرؤى فيها، ومفهومه (قدّه) عن المرجعية ومهامها، وغير ذلك.
[1] ليس ذكرنا لهذه العبارات جرياً على عادة حشد الألقاب للمرجعية ، بل هو من باب الإشارة السريعة لأبرز خصائص شخصية السيد الشهيد (قدّه)..راجع عنوان “الجمود عند الألقاب”.
[2] من الأخطاء الشائعة قولهم “حوزوي” و”ذاتي”..والصحيح “حوزيّ” و”ذووي”.
[3] نظرات إلى المرجعية/ص9 ، 32.بقلم “العاملي” على شبكة الانترنت.
[4] “مباحث الأصول”/ج1/ص 92. ويفرّق السيد الحائري (دام ظله) في حديث صوتي له بين المرجعية الموضوعية والصالحة حيث يمكن أن تكون المرجعية صالحة غير أنها فردية ذاتية غير موضوعية.
[5] “المرجعية آفاق و تطلعات” / الشيخ محمد مهدي شمس الدين.. سلسلة “اخترنا لك” (7) ص 215.
[6] “وضع الدكتور عبد الباقي الهرماسي في كتابه “الإسلام الاحتجاجي في تونس” جدولاً يحدد فيه نسبة القراءة لأفكار و كتب المفكرين ، “فجاء الشهيد الصدر (قدّه) بعد القرآن الكريم مباشرةً و احتل نسبة 54 % فيما احتل سيد قطب 35 % و المرحوم الدكتور شريعتي 31 %”.
[7] يكتب (قدّه) :”..و قد قمنا بمشروع كفالة وجبة غذاء كاملة لطلبة المدارس و هو مشروع قد بدأ بنجاح ملحوظ و الحمد لله و المأمول أن يمتد و يساهم في لون جديد من الرعاية المرجعية للحوزة..” ؛ ثم يكتب (قدّه) :”بالنسبة إلى مشروع الإطعام استمر إلى نهاية شهر رمضان ثم أوقفناه لأن السيد الخوئي حينما تفاوضت معه في الموضوع لم ينفتح عليه و بدا منه بعض السلبيات..”. شهيد الأمة/ج1/ص365،431.
[8] “المرجعية آفاق و تطلعات” ، الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، اخترنا لك (7) /ص 216.
[9] راجع “صفحات لوقت الفراغ” ، ص6.
[10] محمد باقر الصدر/الحسيني/ص213.
[11] شهيد الأمة/ج1/ص290.
[12] شهيد الأمة/ج1/ص431-132.
[13] و هو ما اعتبره سماحة السيد علي أكبر الحائري في حديث معه أمراً طبيعياً و لو لم نكن نملك عليه رقماً حسياً.
[14] التأسيس في فكر الشهيد الصدر/السيد عمار أبو رغيف.. قضايا إسلامية/عدد3/ص 31.ظ[15] من الأمثلة إمداده الحوزة التي أسسها الشهيد السيد عباس الموسوي (قدّه) حيث يكتب:”..و إني منذ مدة أسمع عن المدرسة التي كان لكم شرف إقامتها ما يوجب اعتزازي و تقديري..و قد أرسلنا إليكم دورة من شرح اللمعة..و عدد من المنطق الكبير و من المنطق الصغير و دورة من الحلقات و نحن مستعدون لتزويدكم بما تحتاجه حوزتكم من كتب دراسية..” و يكتب أيضاً:”..و أما اقتراحكم بالنسبة إلى العون المالي للمدرسة فهو مقبول..” شهيد الأمة/ج1/ص424-425.
[16] من رسالة له (قدّه) إلى السيد الغروي.. شهيد الأمة/ج1/ص309.
[17] الفتاوى الواضحة ، ص 96.
[18] عبارة مقتطعة من رسالة للسيد الشهيد (قدّه)
[19] كفاية الأصول/ص130.
[20] يكتب (قدّه) إلى الشهيد السيد عباس الموسوي (قدّه) :”..كما إنا أرسلنا مع حامل الرسالة بعض أشرطة بحث التفسير من أجل تعميمها على الأمة كما رغبتم فإن في استماع الأمة إلى صوت المرجع تأثيراً كبيراً في نفسها و سوف نرسل إليكم باقي الأشرطة..” شهيد الأمة/ج1/ص425.
[21] يقول الدكتور حنفي:”وجدت الأنا هويتها في “فلسفتنا” و “اقتصادنا” ، من أجل التركيز على خصوصيتها في مواجهة الآخر ، و في نفس الوقت تنقد ثقافة الآخر الذي قام بإثبات طرفٍ و إنكار طرف آخر في الأسس المنطقية للإستقراء”. “مقدمة في علم الاستغراب،ص751.
[22] يروي السيد كمال الحيدري أن السيد الشهيد (قدّه) راح يحدثهم بعد الدرس حول القصص البوليسية ، فسألوه : هل يبقى لديكم وقت لقراءة القصص البوليسية ؟ فقال (قدّه) :”نعم و هي تعجبني كثيراً”..و لعله (قدّه) كان يقرأ لـ”أغاثا كريستي”.
[23] حدثني أحد العلماء المشايخ (رحمه الله) أن السيد الشهيد (قدّه) سأله ذات يوم عن حال أخيه الصغير –و كان قد انتسب إلى الحوزة في سن مبكرة (و لعله كان ابن 11 سنة)- فأجابه الشيخ بطريقة سلبية : إنه لا يزال طفلاً يقضي وقته بقراءة مجلات “سوبرمان” –أو “باتمان” و التردد مني و لعله قال الاثنين معاً- ، فأجابه (قدّه) مستنكراً سلبيته في الجواب :”و ما المشكلة في ذلك؟ أنا أيضاً أقرأ هذه المجلات.. ألا يجب علينا أن نعرف ماذا يبثون لأولادنا في المجلات ؟”..
[24] سنوات المحنة و أيام الحصار/ص 79 نقلاً عن السيد كاظم الحائري دام ظلّه.
[25] عن السيد صدر الدين القبانجي..مقدمة كتاب “المذهب السياسي في الإسلام”.
[26] السيد عمار أبو رغيف،”ماذا جاء حول فلسفتنا”/ص47.و يقول الدكتور زكي نجيب محمود :”إن فلاسفة الانكليز سيقرأون فكراً جديدا إذا أتيح لهم أن يقرأوا ترجمة الأسس المنطقية للاستقراء”.
[27] السيد عمار أبو رغيف ، “نظرية المعرفة في ضوء الأسس المنطقية للاستقراء” مجلة المنهاج العدد 17 ، ص 133.
[28] يكتب (قدّه) من لبنان :”..أما ما تم من عمل فهو كما يلي: أولاً: خطاب استنكار وقع عليه حوالي أربعين عالماً. ثانياً : ملصقة جدارية.. ثالثاً: برقيات طيرها أبو صدري –السيد موسى الصدر- إلى جميع رؤساء و ملوك الدول العربية و الإسلامية.. وقد جاء الجواب حتى الآن من جمال عيد الناصر و فيصل و الأرياني الرئيس اليماني..” و يقول:”الشارع الشيعي في بيروت مكهرب بالقضية..”.
[29] كتب (قدّه) سنة 1963م”..و أما بالنسبة إلى إيران فلا يزال الوضع كما كان و آقاي خميني مبعّد في تركيا من قبل عملاء أمريكا في إيران و قد استطاع آقاي خميني في هذه المرة أن بقطع لسان الشاه..” (شهيد الأمة/ج1/ص224)..و عن رحيل الإمام (قدّه) من النجف يقول (قدّه) :”إن رحيل السيد الخميني من النجف خسارة كبيرة”.و يكتب (قدّه) إلى “بختيار” بعد قيامه بإغلاق مطار طهران بوجه طائرة الإمام (قدّه) العائدة من باريس :”..باسم المرجعية و علماء النجف الأشرف أقدم استنكاري الشديد لغلق مطارات البلاد في الوقت الذي عزم فيه آية الله العظمى الخميني على العودة..”. شهيد الأمة/ج2/ص225.
[30] حثّ السيد (قدّه) بعد إحراق المسجد الأقصى السيد الحكيم (قدّه) على إصدار بيان لكافة المسلمين ، و يقول:”و قد شعرت بالرغم من الآلام التي لا تطاق بشيء من الارتياح لإيصال بيان سيدنا الأعظم عن حريق المسجد الأقصى..”.
[31] حين إقدام السادات على زيارة تل أبيب و المحادثات التي تمخضت عنها اتفاقية “كامب ديفيد” بعث (قدّه) ببرقية استنكار عاجلة للسادات أنذره فيها بعاقبته التي ينالها على أيدي أبناء المسلمين..
[32] راجع شهيد الأمة/ج1/ص365،368. و من اهتماماته (قدّه) بلبنان ما يكتب بشأنه :”دأبت منذ دخلت لبنان على تكرار مفاهيمنا عن الإسلام التي تبدو هنا غريبة كل الغرابة و تباحثت في تلك المفاهيم مع عدة من الأشخاص كالشيخ محمد جواد مغنية..”.
[33] يكتب (قدّه) :”..كما نهيب بالمسلمين جميعاً في مشارق الأرض و مغاربها أن يدركوا عمق المحنة التي يواجهها أخوان لهم مسلمون في الأفغان..”. محمد باقر الصدر/الحسيني/ص381.
[34] حين انتصار الثورة أعلن (قدّه) عن تعطيل أبحاثه ابتهاجاً و فرحاً و تحدّث لطلابه عن ضرورة دعم الثورة و إسنادها. و كتب (قدّه) إلى الإمام الخميني (قدّه) :”..و نحن .. نضع جميع وجودنا و إمكاناتنا في خدمة وجودكم العظيم و النهضة الإسلامية المقدسة..شهيد الأمة/ج2/ص226.
[35] يحدّث الشيخ محمد سعيد النعماني بأنّه (قدّه) قد دعا إليه يوماً بعض طلابه بعد أن طرق سمعه خبر تقصيرهم الدراسي ، فحثّهم بلغة أبوية على المثابرة قائلاً :”أريد أن أغزو بكم البحار”..
[36] مستفاد من مقدّمة السيد علي أكبر الحائري على كتاب الحلقات ص 65-66 ، عن مباحث الأصول/ج1/ص62.
[37] الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد من مجموعة “اخترنا لك” ص 226.
[38] مباحث الأصول / ج1 / ص 99
[39] من رسالة خطية له (قدّه) ، راجع شهيد الأمة ج1/ص312.
[40] من رسالة له (قدّه) إلى السيد مرتضى الرضوي.
[41] يقول الدكتور الشرقاوي:”إنني لم أقرأ نقداً موضوعياً هادئاً لنظرية الشورى كما قرأته في المقال الموجز للشهيد السيد محمد باقر الصدر”.
[42] يذكر أن كتب السيد الشهيد (قدّه) من المصادر المعتمدة في الجامعات الإسرائيلية و أبرزها “الأسس المنطقية للإستقراء”.
[43] كان بين السيد (قدّه) و الدكتور إعجاب متبادل..
[44] الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار / ص 61-77
[45] الصحيح في اللغة ما أثبتناه في المتن، لأنّ الباء التي يتعدّى بها فعل “استبدل” تدخل على المنصرم لا الحالّ ، والشاهد عليه قوله تعالى ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ (البقرة 61) وذلك عندما طلبوا الذي هو أدنى بعد أن كان بحوزتهم الذي هو خير.. وكذلك “ولا تستبدل بي غيري”..
[46] مباحث الأصول/ج1/ص99
[47] تقدّم أنّ الصحيح في دخول الباء ما أثبتناه في المتن.
[48] السيد محمد حسين الطهراني (قدّه)، “ولاية الفقيه في حكومة الإسلام” ، ج4 ، ص122-123.
[49] السيد محمد حسين الطهراني (قدّه)، “ولاية الفقيه في حكومة الإسلام” ، ج4 ، ص122.
[50] مباحث الأصول/ج1/ص51.
[51] عن السيد عمار أبو رغيف الذي كان حاضراً يومها.
[52] الغروي، السيد محمد، تلامذة الإمام الشهيد الصدر (قدّه)، ص 366، ط.دار الهادي 1422 هـ.
[53] الغروي، السيد محمد، تلامذة الإمام الشهيد الصدر (قدّه)، ص 338، ط.دار الهادي 1422 هـ.
[54] لا يقال بأنّنا وقعنا في المشكلة التي أشرنا إليها تحت عنوان “النـزعة الاستصحابية”، حيث درجنا هنا على التعبير ببعض العبارات الأصولية، فإنّ ذلك قد وقع من باب الأنس اللفظي فحسب وفي وسط يفهم هذه اللغة؛ والكلام بجوهره هناك منصبّ حول تحكّم هذه العقلية على طريقة التفكير لا التعبير، وبين المقامين بونٌ شاسع..(فتأمّل!!).
[55] ورد مضمون هذا الكلام في مجلة الوسط بعد رحيل السيد الخوئي (قدّه) في مقابلة مع الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين. كما ورد في كتاب “الاجتهاد والتجديد في الفقه الاسلامي/المرجعية والتقليد عند الشيعة/ص145.
[56] راجع شهيد الأمة/ج1/ص135.
[57] سنوات المحنة/ص72
[58] مجلة رسالتنا، العدد الثاني والثالث، ص 23. (نيسان 1983م)
[59] هذه العبارة وسابقتها من رسالة خطية له (قدّه)
ينقل السيد محمد الغروي عن السيد محمد حسين الحائري :”إنّ السيد الأستاذ وفي مناسبة دينية عقد مجلساً في بيته وتبرع الشاعر والخطيب الشيخ باقر الأيرواني بإنشاد بعض الأبيات فقام وبدأ قصيدته بقوله:
جلت ظلمة الدنيا بنورك مثلما أضاء الدجى بطلعته البدر
رأيتك لم يعقد على الأرض مجلس لأهل النهى إلا وكانت للصدر
فقاطعه سيدنا الأستاذ منادياً يا شيخ بطّل ( لا تمدح واقطع الإطراء)” (تلامذة الإمام الشهيد الصدر/ص322،323.
[60] نقلنا النصوص الآتية من عدة مصادر.راجع الإمام الشهيد محمد باقر الصدر/ص87. وشهيد الأمة/ج1/ص272-278.
[61] عن السيد علي أكبر الحائري، صحيفة المبلغ الرسالي، العدد 129 ، 13 نيسان 1998، ص5، مع تعديل لبعض الضمائر والحروف الصياغية.
[62] من رسالة خطية له (قدّه) .. شهيد الأمة/ج1/ص194.
[63] “..في يوم من الأيام شرع الإمام الشهيد بحثه في مسألة فقهية (من كان سفره اكثر من حضره) ثم عقب على ذلك بقوله: إني أصبح مرضي أكثر من صحتي وقد أديت ردحاً من الزمن دور التدريس العلمي وترية الطلاب وقد داهمتني اليوم عوارض الشيخوخة والأمراض فعليكم أن تبحثوا عن أستاذ غيري تواصلون عنده الدرس. وقد كان إعلان الإمام الشهيد «ره» تعطيل درسه طامة كبرى لطلابه فهرع كل واحد منهم يلتمس أستاذه بخضوع ورجاء وبكاء, غير انه «ره» لم يزل مصراً على رأيه. وفي مجلس التعزية الذي كان يعقده الإمام «ره» أسبوعياً في منزله وكان يومئذٍ حاشداً لأن الجميع يحاول أن يراقب الموقف عن قرب, وكان يومها قد حضر المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية «ره» ذلك المجلس ـ وكان في زيارة للعراق ـ فاستثمر ذلك الوقت للحديث مع السيد الصدر «ره» معاتباً إياه على هذا القرار: وأصر الشيخ مغنية على معرفة الدوافع لهذا القرار وحاول الإمام «ره» التزام الكتمان دون جدوى فانفجر البركان في صدره ليعلن عما في نفسه من آهات وآهات . . طالما غض الطرف عنها وكظم عنها وكظم غيظه وتلقاها بصدر رحب, ولكن التمادي بمثل هذه المنكرات أفقد الإمام صبره ليتخذ قراره في الكشف عما يلاقيه ويتعرض له. وعندها انطلق الإمام الشهيد «ره» يميط اللثام عن الصيغ المتنوعة التي يستخدمها هؤلاء النفر وهذه الحفنة من توجيه التهم والأباطيل لشخصه والتعرض لطلابه مما يضطرهم إلى ترك الحضور لديه خوفاً من هذه التهم التي تنالهم ويتعرضون لها في الطرقات والمجالس والمحافل فيلجأ بعض طلبته إلى سماع أشرطه التسجيل التي تسجل البحوث التي يلقيها الإمام الشهيد «ره» ويستعيض بسماعها عن حضور الدرس وتكفيه شر هذه الحرب الشعواء التي يثيرها هؤلاء… إنها شقشقة هدرت وسرعان ما كظم غيظه دون أن يتخلى عن قراره لأنه يهدف إلى المعالجة هذا الوضع بطريقة يمكن أن تشل نشاط هذه الحفنة ولذلك لم يقتنع بحديث الشيخ مغنية رحمه الله حينما حاول إقناعه بالتخلي عن قراره والرجوع إلى التدريس. ووصل إلى مسامع الإمام الخوئي نبأ قرار السيد الشهيد «ره» وإصراره على ذلك وعكف السيد الخوئي على تلطيف الأجواء والحيلولة دون إصرار السيد الشهيد فبعث بعض الأفاضل من تلامذته ودارت مناقشات بين السيد الشهيد ومبعوث السيد الخوئي (الشيخ) اسحق فياض أحد أفاضل الحوزة وقد تخلى السيد الشهيد «ره» عن قراره اثر هذه المباحثات..”.محمد باقر الصدر/الحسيني/ص88-89..مستفيداً من سماحة السيد علي أكبر الحائري..
[64] يقول (قدّه) قابضاً على لحيته الكريمة وقد سالت دمعة ساخنة من عينه :”لقد شابت هذه من أجل الإسلام أفؤتهم بالعمالة لأمريكا و أنا في هذا الموقع” (شهيد الأمة/ج1/ص186)
[65] ليس المقصود في المقام الميل إلى عدم إبداء الملاحظات على ما كتبه (قدّه)، بل إنّ ظاهرة النقد ظاهرة قد شجّع (قدّه) على إرساء قواعدها في الدرس الحوزيّ عموماً.. لكن المراد أنّ النقد تارةً يكون موضوعياً للوصول إلى الحقيقة وأخرى يكون شخصياً للثأر من أشخاص والحطّ من قدرهم لا لشيء إلا لتحطيمهم. ولا يخفى أنّه من الخطورة بمكان أن يخيّم النمط الأخير على الجوّ العلمي في الحوزة العلمية، ولهذه الظاهرة محاذير أخلاقية وسلوكية غير خافية..
[66] إشارة إلى الحديث القدسي :”لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن”.
[67] مجلة الكلمة، العدد 33، علم الكلام المعاصر .. قراءة في التجربة الكلامية عند الشهيد الصدر (قدّه)، الشيخ حيدر حب الله، ص 79.
[68] مباحث الأصول/ج1/ص46
[69] سنوات المحنة/ص127.
[70] من جواب خطي له (قدّه) ، راجع “شهيد الأمة/ج1/ص172”. ولتوضيح بعض أسباب تصديه (قدّه) للمرجعية يراجع “شهيد الأمة/ج1/ص255”.
[71] عبارة استخدمها (قدّه) في رسائله..منها:”يجب أن يكون السلوك بيننا على الطولية”..
[72] كتب (قدّه) :”وحرمت عليهم الدخول في باب المقارنة بيني وبينه أو أن يشهدوا لأحد بمساواتي أو أعلميتي على السيد دام ظله”.
[73] من رسالة خطية له (قدّه)، راجع “شهيد الأمة/ج1/175”.
[74] جريدة العهد، الجمعة 18 رمضان 1410 هـ.
[75] راجع ما ينقله السيد الحيدري في شرح الحلقة الثالثة/ق2/شريط 49 د 42 ثانية 41.
[76] نقلاً عن السيد كمال الحيدري/شرح الحلقة الثانية/شريط33/دقيقة 26:30.
[77] راجع “شهيد الأمة/ج1/ص251،261.
[78] من النادر جداً أن تجد في مخاطبات العلماء الكبار ما تجده عنده (قدّه)، حيث يخاطب الإمام الخميني (قدّه) قائلاً :”سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد الخميني..”. مباحث الأصول/ج1/ص138.
[79] تلامذة الإمام الشهيد الصدر، السيد الغروي، ص299.
[80] السيد عمار أبو رغيف، ملحق “ماذا جاء حول فلسفتنا”.
[81] من رسالة خطية بيده (قدّه)، راجع شهيد الأمة/ج1/ص198.
[82] من كلمة له (ده) في الذكرى السنوية الـ21 لاستشهاده (قدّه) و أخته (قدّها)..
[83] من كلمة للسيد الحائري (ده) في الذكرى السنوية الـ21 لاستشهاده (قدّه) و أخته (قدّها)..
[84] صحيفه نور، ج 14،ص 177.
[85] من نداء سماحة السيد القائد الخامنئي (حفظه الله) إلى المؤتمر العالمي للشهيد الصدر (قدّه) في 18-1-2001.
[86] من دراسة غير منشورة عن السيد الشهيد (قدّه).
[87] الأسس المنطقية للاستقراء، يحيى محمد، ص 15.
[88] يكتب (قدّه) :”وأنا الآن مشغول بوضع كتاب آخر .. في التخطيط لاقتصاد المجتمع الإسلامي.. وسيكون في نفسه مقدمة للجزء الثاني من الفتاوى الواضحة إن شاء الله تعالى..” شهيد الأمة/ج1/ص232.
[89] المحاضرة الثالثة من المدرسة القرآنية ، ص45 ، طباعة المؤتمر العالمي للشهيد الصدر (قدّه)..
[90] تجديد الفقه الإسلامي ، شبلي الملاط ، ص250.
[91] منطق الاستقراء ، السيد عمار أبو رغيف ، ص6.
[92] قالها السيد عمار أبو رغيف بعد أن غاب في صفحات الماضي وعلت وجهه ابتسامة رقيقة ..
[93] من دراسة غير منشورة عن السيد الشهيد (قدّه).
[94] الفقرة الثانية عن: د.حبيب فياض، قضايا إسلامية معاصرة، العددان 11-12 ، ص152.
[95] ومما يحسن أن أذكّر به نفسي والآخرين أنّ الذوبان في المرجعية التي تحقق أهداف الإسلام لا ينبغي أن يحوّلنا عن العلاقة الطولية بين هذه المرجعية وبين إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف..وقد يكون هذا الأمر مع وضوحه نظرياً صعباً مستصعباً عملياً.. والله ولي التوفيق.