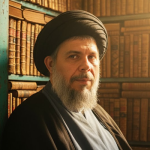الشيخ عبد المجيد فرج الله [1]
ملخّص
تميز الشهيد الصدر بنبوغ قل له نظير في كل ما طرقه من مجالات، من ذلك مجال التأثير في مستمعه وقارئه بأسلوبه الأخّاذ. ففي أساليبه البيانية التي تجري على البديهة تدرّج منطقي يؤدي إلى الإقناع التام، وفيها دقة في اقتناص المعاني، واختصار غير مخل للحقائق العلمية، وفنية في البرهنة الرياضية الاستقرائية، وفهم رائع للدين والتدين، وتجديد وإبداع في تقديم التعاريف والمصطلحات، وخطبه تتميز بكل ما قيل في الخصائص الفنية للخطابة، مع إبداع لخصائص أخرى.
لا يخفى أن سماحة المرجع الكبير والفقيه العظيم والمفكر المبدع السيد الشهيد محمد باقر الصدر(قده) كان من أشهر وأنبغ علماء مدرسة أهل البيت(ع)، وكان من أكفأ من كتب عن الإسلام الأصيل، وأن نتاجاته قد أحدثت صدى كبيراً في الواقع الفكري العربي والإسلامي وانعكست على المنظومة المعرفية العالمية لتغني وتطور وتفعّل وتتواصل من أجل رقيّ الإنسان.
لقد تميز الشهيد الصدر(قده) بمميزات كثيرة أثْرت الحوزة العلمية والواقع الفكري الإسلامي، كما كان لنتاجاته القيمة أبلغ الأثر في النقلة الكبرى التي أطلقت عظمة الإسلام وفتحت أمام عطاءاته الغنية آفاق الحركة العلمية، وزرعت في طريق الثلّة المؤمنة أزاهير العطاء الواعي الذي قال كلمة الإسلام بملء فمه متحدياً التيارات الهوجاء التي نالت من الإسلام واتهمته ۔ مفتريةً ۔ بالرجعية والتخلف والتقوقع، فإذا بمحمد باقر الصدر عملاقاً فكرياً وروحياً وقيادياً يوقد الدرب بشمس الحق الصِراح ويصدع بكلمة الإيمان الممتد مع كل زمان ومكان.
والأسباب والمؤهّلات التي أنضجت كتابات الصدر الكبير كثيرة وهامة، وقد اخترتُ أحدها ۔ الأسلوب الأدبي والفني ۔ لما له من تأثير بارز في كتاباته المختلفة، حيث نسجها بسحر خفي شدّ انتباه القارئ كأروع ما يكون الشد، وأسّس لنمط الطرح العلمي العميق بحُلل قشيبة يلوّنها بهاء الأدب.
وما إن أبحرت في عُباب البحث حتى تفتّقت الروعة من هذا البحر الزاخر بالمبهر والمعجب، فأنت مع محمد باقر الصدر تأسرك الفكرة الواثقة الرحيبة، وتدهشك المفردة الموحية الرشقية، وتأخذ بمجامع لُبّك الطلاوة الفاتنة، وتستولي على إعجابك المقدرة الفذّة على صوغ المعاني الدقيقة في قوالب الوضوح الجميل والسبك المحكم المغموس بظلال فنية محببة.
وها أنا الآن أقدّم خلاصة سريعة ومضغوطة جداً لعدد من نتائج هذا البحث:
أولاً: التمكن من الأساليب العربية
الذي يستطيع أن يملك ناصية البيان العربي، ويحلّق في سماواته الممتدة بعمق الدلالات الخاصة بكل مفردة من المفردات ثم مع الجمل المتآلفة المفردات ۔ إذا أتقن مبدعها التعامل الفذ معها ضمن إطار نظرية النظم التي طرحها عبد القاهر الجرجاني ثم اعتُمدت عالمياً في العصر الحديث ۔ فإنه سوف يتمكن من تطويع الأفكار الصعبة والنظرات الدقيقة ليصوغها الصياغة الجميلة ويطرحها الطرح الرشيق. ولهذا نجحت كثير من آثار الأدباء والعلماء الذين اعتمدوا أساساً راسخاً في علوم العربية المتعددة، في حين تراجعت آثار آخرين ۔ مع أهمية بعضها ۔ بسبب طرحها المشوّه في قوالب جامدة من التعبير تعتمد اللغة المفككة والعبارات الهشّة والكلمات المتنافرة غير الدالة.
وكلما توغلنا في البحث في هذه النقطة وجدنا الصدر الشهيد مالكاً ناصية البيان العربي، مستفيداً من دراساته الواعية للغة القرآن، ومتواصلاً مع آدابها القديمة والحديثة بشتى أشكالها البهيّة من شعر ونثر وفنون أدبية أخرى. ولذلك نجد الشهيد الصدر متمكناً جداً من التحرك على مساحة واسعة من أنماط التعبير العربي، فلا يدع المتلقّي إلا وقد أقنعه بكل هدوء وسلامة منطق وروحية موضوعية بالفكرة التي يتبناها، دون أن يسيء إلى الأمانة العلمية في النقل، أو ينزل إلى ما يشين الباحث الموضوعي الواثق بطروحاته، إلى جنب الحيادية الفذة في النقاش.
وكمثال على ذلك استخدامه الاستفهام الإنكاري بشكل مقنع مؤثر، ولنأخذ عيّنة من هذا القبيل قوله:
ولا أدري ماذا يقول هؤلاء الذين يشكّون في وجود اقتصاد إسلامي أو علاج للمشاكل الاقتصادية في الإسلام، ماذا يقولون عن عصر التطبيق في صدر الإسلام؟! أفلم يكن المسلمون يعيشون في صدر الإسلام بوصفهم مجتمعاً له حياته الاقتصادية وحياته في كل الميادين الاجتماعية؟! أفلم تكن قيادة هذا المجتمع الإسلامي بيد النبي والإسلام؟! أفلم تكن هناك حلول محددة لدى هذه القيادة يعالج بها المجتمع قضايا الإنتاج والتوزيع ومختلف مشاكله الاقتصادية؟! فماذا لو ادّعينا أن هذه الحلول تعبّر عن طريق الإسلام في تنظيم الحياة الاقتصادية، وبالتالي عن مذهب اقتصادي في الإسلام؟!
ومن خلال هذا النص نلاحظ عدة ملاحظات هي:
أ ۔ النص يعتمد في هيكليته البنيوية على أسلوب الاستفهام، وهو استفهام إنكاري لكنه غير جارح في إنكاريته، بل إنه يتنزل إلى مستوى المستفهم العادي، ومع ذلك يشحن بفكرته المهيمنة، ويسترسل في هذا المنحى حتى يصل إلى ذروة الفكرة، فيطلق الاستفهام الأخير وهو استفهام تقريري صادع بالنتيجة التي يتوخاها: (فماذا لو ادعينا أن هذه الحلول تعبّر عن طريقة الإسلام في تنظيم الحياة الاقتصادية..).
ب ۔ لقد اختزنت كلمته (ولا أدري) كثيراً من الإيحاء الأدبي، فهو لم يرد أن يعرض الفكرة مشحونة بالسخرية المباشرة، أو بالتقريرية السردية، أو بالتشنيع الجارح، إنما وشّى رأيه بكلمات رقيقة مهذّبة وهو يناقش الآخر بهدوء وموضوعية تذكّرنا بموضوعية القرآن الكريم: <وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ>[2]. وهذه النقطة على قدر كبير من الأهمية في استدراج الآخر للنقاش إلى جانب مداليلها القرآنية الأخلاقية التي تؤسس لمحورية سليمة في أدب الحوار والنقاش.
ج ۔ اختياره لصيغة (أفلم) ثلاث مرات دون غيرها من صيغ الاستفهام يدل على أنه يتقصدها دون سواها، وحينما نأتي إلى مدلولها نجده الأكثر عمقاً في تأدية أقصى درجات الحالة الاستنكارية من أغلب أدوات الاستفهام الأخرى، فإذا تحققت هذه الدرجة من قوة الاستنكار المطروح بكل هدوء وثقة أصبحت واضحةً جليةً الفكرةُ المتوخاة المشحونة بكل تلك الهيمنة الإقناعية المتحدية بالدليل. ولذلك نجد القرآن المجيد يستخدم هذه الصيغة الاستفهامية بكثرة كاثرة خاصة في الأفكار التي تتطلب قوةً في الطرح الاستنكاري.
د ۔ إن القارئ يجد نفسه مقتنعاً بهذا الطرح الجذاب أو على الأقل سيكون متفاعلاً معه وإن لم يقتنع تمام الاقتناع، وبهذا يكون الصدر قد هيّأ المتلقي لبحثه القيم هذا، وضمن أن القارئ سيتابعه حتى آخر الشوط.
هـ ۔ بعد ذلك يستدرج شهيدنا الفذ عقلية المتلقي من خلال طرح سلسلة من الاستفهامات الاستنكارية العاجّة بدلالاتها القوية التي تقتنص مواطن الضعف والهزال في فكرة الآخر المضادّة، فيطرحها هذا الطرح المؤثر للوصول بها أخيراً إلى البديل دون أن يكون هناك كثير عناء في إقناع المتلقي بقبول ذلك البديل.
ثانياً: دقة اقتناص المعاني والأفكار من الواقع بإبداع حي
حيث نجد روعة الفكرة التي تتتبع الواقع المعني بالدراسة والتقويم، فتتحرك حول الظواهر وتنفذ إلى ما وراء الأعماق وهي تجوس البنى الاجتماعية، والطبيعة المتفاعلة مع هذا الإنسان ۔ موضوع الدراسة ۔ أو ذاك، أو مع تلك الشريحة المدروسة أو هذه، ثم يستعرض ما لاحظه بحيوية نابضة. وهذا جانب يعطي كثيراً من القوة والتأثير في الأعمال الكتابية التي تحاول الجمع بين فنية الطرح ودقة النقاش الجدلي الإيجابي، فإذا بالخطاب الصدري المستفيد من هذا الجانب يقتنص أفكاراً تفاجئ المتلقي وتدهشه جداً بطرافتها وبهيّ إيجاءاتها، دون أن يستطيع الطرف الآخر الانتصار لفكرته التي يجادل عنها، فيبقى أمام خيارين: إما التسليم بصحة أطروحة الصدر، أو بقطع الحوار والنقاش معه ليقرّ بالاستسلام شاء أم أبى.
لنأخذ مثالاً على ذلك قوله:
إن الإنسان الأوروبي ينظر إلى الأرض دائماً لا إلى السماء، وحتى المسيحية بوصفها الدين الذي آمن به هذا الإنسان مئات السنين لم تستطع أن تتغلب على النزعة الأرضية في الإنسان الأوروبي بل بدلاً عن أن ترفع نظره إلى السماء، استطاع هو أن يستنزل إله المسيحية من السماء إلى الأرض، ويجسّده في كائن أرضي[3].
فهذه الاقتناصة الرائعة ۔ على اقتضابها ۔ شاهدة على عمق النظرة التحليلية لدى السيد الشهيد الصدر، ودالة على مدى وضوح الرؤية الفكرية عنده، وعلى المقدرة التنظيرية الفائقة لديه، كل ذلك بأقل كلام وأدل استنتاج، وبأيسر جمل وأبسط ألفاظ. على أن أروع اقتناص كان في قوله المبدع: (استطاع أن يستنزل إله المسيحية من السماء إلى الارض)، ففي هذه الجملة القصيرة تمكّن ببراعة من أن ينقد وينتقد ويقوّم مسيرة شعوب كثيرة، وواقع ديانة هي أوسع الديانات أنصاراً في أكثر أصقاع الأرض. وأمثال هذه كثيرة في كتاباته(رضوان الله علیه).
ثالثاً: اختصاره وإيجازه الدقيق للمطالب العلمية
كل من قرأ نتاجات الصدر وجد الاختصار الدقيق للمطالب العلمية المتشعبة والمضنية في قواعد سهلة مقتضبة، لكنها معبّأة علمياً وفكرياً. ومما لا يتنازع عليه اثنان أن القارئ العادي لأغلب الكتابات الفكرية يجد كثيراً من العنت والمشقة والتشتت الذهني وعدم الاستيعاب بسبب جفاف الطرح الفكري وضحالة اللغة المؤثّرة وغياب الأسلوب الجذاب، ثم تلك التشعبات والتداخلات التي تستهلك وقت القارئ وجهده، أما السيد الصدر في كتاباته الفكرية العلمية الراكزة التي تتبنى ردّ أعتى المدارس في الفكر الاقتصادي ۔ مع كثرة تنظيراتها والكتّاب الذين روّجوا لها ودافعوا عنها وطرحوها بأساليب متعددة وكثيرة وبأكثر من لغة ۔ فإننا نجده سيد المضمار والخاطف لقصب السبق ضمن طريقة أسلوبية لديه تعتمد كثيراً من نقاط القوة والشد والإدهاش والتأثير، ومنها ما يمكن أن أطلق عليها مصطلح: (فكرة اللمحة الآسرة) المتطورة عن الإيجاز البلاغي العربي، والشواهد المدللة عليها عديدة جداً ومبثوثة في عدد من آثاره القيمة، ولو أردنا أن نأخذ عيّنة فعلى سبيل المثال نجده يختصر جدلاً طويلاً بين المذهب الاقتصادي لدى الإسلام وبين المذاهب الاقتصادية الأخرى، يختصره في هذه العبارة الجميلة: (الإنتاج لخدمة الإنسان وليس الإنسان لخدمة الإنتاج).[4]
ومثل هذا قوله: (حيث لا تنمو الأمة لا يمكن أن تمارس عملية تنمية).[5]
ومثله قوله: (إن دولة القرآن لا تستنفد أهدافها، لأن كلمات الله تعالى لا تنفد، والسير نحوه لا ينقطع، والتحرك باتجاه المطلق لا يتوقف).[6]
إن هذه القواعد هي خطوط عامة تارة، أو خطوات تنظيرية تارة أخرى، أو رؤوس مطالب خطّط السيد الشهيد لتناولها لكنه أدرك أن العمر أقصر من ذلك، فراح يطلق بُنات أفكاره في عمق الزمن على أمل أن يستفيد منها إنسان، أما أهميتها على الصعيد الفني والأدبي فتكمن في الدرجة الأولى في روعة الاختصار، ولطافة الإيجاز البلاغي، وفي إغناء الفكرة تماماً مع ما فيها من دقة الاختزال، ومع كل ذلك نجد المفردة الواضحة، والأسلوب البسيط دون أدنى تكلف أو إرباك أو اضطراب أو قصور.
رابعاً: الفنية في البرهنة الرياضية الاستقرائية
فهو يبرهن برهنة رياضية استقرائية على صحة العقائد الإسلامية والفلسفة الإسلامية حاشداً عيّنات الواقع المدروس بأسلوب شفاف وعرض غير جاف، من خلال الاسترسال في الحديث الإنشائي، لكنه في واقعه مشحون بالأفكار المضغوطة وبالاستقصاء العلمي والبرهنة المنطقية الرياضية، مما يعطي المتعة في العرض إلى جانب الدقة البحثية.
ومن ذلك قوله متحدثاً عن الرسول الكريم(ص):
فابن مجتمع القبيلة ظهر على مسرح العالم والتاريخ فجأة لينادي بوحدة البشرية ككل، وابن البيئة التي كرّست ألواناً من التمييز والتفضيل على أساس العرق والنسب والوضع الاجتماعي ظهر ليحطّم كل تلك الألوان؛ ويعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليحوّل هذا الإعلان إلى حقيقة يعيشها الناس أنفسهم، ويرفع المرأة الموؤودة إلى مركزها الكريم كإنسان تكافئ الرجل في الإنسانية والكرامة، وابن الصحراء ۔ التي لم تكن إلا في همومها الصغيرة وسدّ جوعتها والتفاخر بين أبنائها ضمن تقسيمها العشائري ۔ ظهر ليقودها إلى حمل أكبر الهموم، ويوحّدها في معركة تحرير العالم وإنقاذ المظلومين في شرق الدنيا وغربها من استبداد كسرى وقيصر…[7]
فهو هنا ينشئ مستقرئاً، ويستقرئ منشئاً، ليتخلص أخيراً إلى البرهنة العلمية الاستقرائية التي تكون نتيجتها أن لا مجال أمام العقل الملتزم بالمنهج العلمي الرياضي إلا الاعتراف والإذعان بنبوة محمد بن عبد الله(ص) ورسالته الإسلامية السماوية.
وفي مثال آخر نجده يفتّح ذهن المتلقي، وهو يأخذه في استقراء علمي دقيق ليثبت له بموضوعية أن الله هو الخالق، لكنه في الوقت نفسه يتسلل بخفية إلى قلب قارئه وبحنوّ ليجعله مشاركاً للذهن في القرار النهائي، ونحن ندري أن التسلل إلى القلب لا يتأتى إلا لأديب بارع أو فنان متمكن، فإذا بنا نلمح هذا العالم العملاق يرسم بكلماته لوحة زاهية، وهو يمرّ بقارئه على خمائل الأزهار، لكنه مرور المتأمل المتفكر، فيقول:
حتى الجمال والعطر والبهاء كظواهر طبيعية نجد أنها تتواجد في المواطن التي يتوافق تواجدها فيها مع مهمة تيسير الحياة ويؤدي دوراً في ذلك، فالأزهار التي تُرك تلقيحها للحشرات لوحظ أنها قد زوّدت بعناصر الجمال والجذب من اللون الزاهي والعطر المغري بنحو يتفق مع جذب الحشرة إلى الزهرة وتيسير عملية التلقيح، بينما لا تتميز الأزهار التي يحمل الهواء لقاحها عادة بعناصر الإغراء.[8]
إن هذا الانتقاء الطريف وطرحه بهذه الطريقة التي يلوح منها طيف أدبي يخطر ما بين فجاج الحقائق العلمية ۔ محل الدراسة ۔ لَدليل على خطرات أدبية ومقاصد فنية أنتجت هذا الانتقاء، وساقته على هذه الهيئة البهية، وحشدت له ألفاظاً بعينها من قبيل: (الجمال، الجذب، البهاء، الأزهار، الإغراء).
خامساً: الدقة والتفنن في اختيار المفردات والجمل
تُلاحظ الدقة والفنية في تقسيم كلامه المتدفق في فقرات وجمل لها روعة السجع غير المتكلف، دون أن يكون لها شكل السجع الصارم المقيد للفكرة، والمعروف أن هذا النوع لا يأتي مطوعاً إلا للأديب المطبوع، أما المتكلف فهو مفضوح مرتبك الأسلوب كما يقول الشاعر:
| ما مَن تباكى مثل مَن يبكي دماً | فضحَ التطبع شيمة المطبوع |
ومن أمثلة ذلك قوله:
لو كان الدين وليد خوف وحصيلة رعب، لكان أكثر الناس تديّناً على مر التاريخ هم أشدهم خوفاً، وأسرعهم هلعاً، مع أن الذين حملوا مشعل الدين على مر الزمن كانوا من أقوى الناس نفساً، وأصلبهم عوداً.[9]
وكهذا قوله في حق الإمام الحسين(ع):
خرّ صريعاً مع الصفوة من ولده وصحبه بأيدي الطغاة، دفاعاً عن الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وعن أمة أراد الطغاة أن يسلبوها إرادتها، ويجمّدوا ضميرها الثوري، وإحساسها بوجودها، فحرّك أبو الشهداء بدمه ضميرها، وبصموده إرادتها، وبفاجعته إحساسها الكبير.[10]
ففي أمثال هذه الجمل نحسّ تقسيماً سجعياً تارة بتساوي القرائن وأخرى بتطاولها، مع عدم التقيد بحرف معين يختم به كل فقرة أو جملة، فهو قد أخذ روح السجع ولم يأخذ شكله القالبي الحائل دون انطلاق الفكرة، بل إنه لم يأبه أبداً حتى للقالب السجعي الذي ورد عفو الخاطر في قوله: (عن أمة أراد الطغاة أن يسلبوها إرادتها، ويجمّدوا ضميرها.. وإحساسها بوجودها) فلم يتوانَ في قصم هذا السجع بإضافة مفردة (الثوري) في الفاصلة الوسطى، لأنه كان يقصدها تماماً، وبـإضافة مفردة (الكبير) في آخر فاصلة: (فحرّك أبو الشهداء بدمه ضميرها، وبصموده إرادتها، وبفاجعته إحساسها..).
إن الصدر ركّز على الموسيقى السجعية لا على الرويّ هدفاً، فيكون قد أخذ سر جمال السجع الكامن في (أن له موسيقى تطرب لها الأذن وتهشّ لها النفس فتقبل على السماع من غير أن يداخلها ملل أو يخالطها فتور، فيتمكن المعنى في الأذهان ويقرّ في الأفكار ويعزّ لدى العقول).[11]
إذن لقد أصاب هدفين برمية واحدة؛ فهو لا يُعاب عليه ما يعاب على الملتزمين بالسجع لدى نقّاد اليوم، بالإضافة إلى حصوله على فائدة السجع المذكورة.
سادساً: الفهم الجميل للدين والتدين
والحديث عنهما بطريقة رائقة شائقة، حيث يأخذ حديثه بمجامع القلوب، فيقنع المشكك، ويقوّي عزيمة المقنع، ويدحض الدعوى المضادة، ويصحح التصور المغلوط.
إن هذا الفهم ضروري جداً ولابد منه في طروحات الدعاة إلى الإسلام والهادية إلى شريعته العالمية. وتتضح أهميته وخطورة ضده من خلال إخفاقات قاصمة بدأت تطفو على السطح بعد وفاة الرسول الأكرم(ص) وقد سببت كثيراً من الاضطراب والوهم والانكسار التاريخي والفكري، خاصة بعدما حاول أشباه المؤرخين وأصحاب السير المجاملون والمداهنون أن ينظّروا لتلك الإخفاقات محاولين إضفاء نوع من الشرعية عليها، مما أدّى إلى إرباك كبير ساعد في تشتت الجهود وتمذهب الأفكار وتطاحن أخوة الأمس.
ومما لا يختلف عليه أن وعي الدين الصراح، ومعرفة التدين الخالص الذي يعني النقاء الأول كما أراده الله ورسوله(ص) سيقود حتماً إلى أهداف القرآن، ويصل بالناس إلى درجات التقوى حيث لا يفقدهم ربهم حيث أمرهم ولا يجدهم حيث نهاهم. إن الذي يستطيع أن يرفع الغبش القاتم عن نصاعة دين الإسلام، ذلك الغبش الناتج من سوء فهم أحد هذين العمادين (الدين والتدين)، يرفعه بنظرته الثاقبة المتمثلة بالتجربة الدينية والتجربة التدينية والتجربة الكتابية المبدعة وبامتلاكه زمام التعبير عنهما بفنية جميلة وبيان ساحر عذب (وإن من البيان لسحراً) لوضوح الرؤية لديه ونصاعة حقيقتهما عنده، فإنه سيكون الأقدر على شدّ الناس بدينهم وعلى هديهم إلى حالة التدين الإيجابية التي ينطلق فيها العقل ويطهر فيها القلب، وتسمو فيها الروح، وتتوثق بها الخطى، ويستقيم معها الدرب.
وسوف نأخذ عينات متقاربة من نظرته العامة في العبادات للتدليل على ذلك. يقول السيد الشهد:
وزّعت العبادات الثابتة على الحقول المختلفة للنشاط الإنساني تمهيداً إلى تمرين الإنسان على أن يُسبغ روح العبادة على كل نشاطاته الصالحة، وروح المسجد على مكان عمله، في المزرع أو المصنع أو المتجر أو المكتب، ما دام يعمل عملاً صالحاً من أجل الله(عز).[12]
وغير خافية على أي متذوق للأدب العربي روعة عبارة (روح المسجد) ودلالاتها الحية المعبّرة في هذا النص الرشيق، الذي أعطى على قصره صورة حية متحركة لشمولية الإسلام ورحابة آفاقه وعميق امتداداته في حياة الإنسان.
وما أجمل اقتناصة (الإطار الكوني الشامل) الذي يريده الصدر لصورة الإنسان في قوله:
والله(عز) لم يركّز على أن يُعبد من أجل تكريس ذاته وهو الغني عن عباده.. ولم ينصّب نفسه هدفاً وغاية للمسيرة الإنسانية لكي يطأطئ الإنسان رأسه بين يديه في مجال عبادته وكفى، وإنما أراد بهذه العبادة أن يربي الإنسان الصالح القادر على أن يتجاوز ذاته ويساهم في المسيرة بدور أكبر، ولا يتم التحقيق الأمثل لذلك إلا إذا امتدت روح العبادة تدريجاً إلى نشاطات الحياة الأخرى، لأن امتدادها يعني ۔ كما عرفنا ۔ امتداد الموضوعية في القصد، والشعور الداخلي بالمسؤولية في التصرف والقدرة على تجاوز الذات، وانسجام الإنسان مع إطاره الكوني الشامل مع الأزل والأبد الذين يحيطان به.[13]
إن تركيز محمد باقر الصدر على مصطلح (روح المسجد) يدلل على انغماسه في بهائها وإحساسه المتواصل والمتأصل بها منذ بدايات حياته، كما تدلنا على ذلك سلوكيته وسيرته والبعد النفسي التحليلي لكتاباته، وهو بحديثه عنها بهذا الأسلوب وبـإسباغها على الواقع الحياتي بكل هذا الصدق، وبكل هذه الطرافة العلمية، ثم تأسيسه على قاعدتها لكل أنماط النشاط الإنساني سلوكياً وتربوياً، عبادياً واجتماعياً، يدلل كل ذلك على عظمة روحية ونفسية وأخلاقية لدى هذا الرجل، أفرزت كل سموّه وصفاته ومبدئيته حتى غدا مثلاً يحذو المجدّون حذوه لو يستطيعون إليه سبيلاً.
وإضافة إلى ما سبق نضرب أمثلة أخرى لتوكيد ما ذكر. يقول السيد الشهيد:
(كل ساحة يعمل عليها الإنسان عملاً يتجاوز فيه ذاته ويقصد به ربه والناس أجمعين فهي تحمل روح المسجد).
(وأما الاتجاه الثاني الذي يحصر الحياة في إطار ضيق من العبادة فقد حاول أن يحصر الإنسان في المسجد، بدلاً عن أن يمدّد معنى المسجد ليشمل كل الساحة التي تشهد عملاً صالحاً لإنسان).
(والشريعة الإسلامية ترفض هذا الاتجاه أيضاً لأنها تريد العبادات من أجل الحياة، فلا يمكن أن تصادر الحياة من أجل العبادات).
(من هذا المنطلق الواقعي الموضوعي صمّمت العبادات في الإسلام على أساس عقلي وحسي معاً، فالمصلي في صلاته يمارس بنيته تعبداً فكرياً، وينزّه ربه عن أي حد ومقايسة ومشابهة وذلك حين يفتتح صلاته قائلاً: (الله أكبر) ولكنه في نفس الوقت يتخذ من الكعبة الشريفة شعاراً ربانياً يتوجه إليه بأحاسيسه وحركاته، لكي يعيش العبادة فكراً وحساً، منطقاً وعاطفةً، تجريداً ووجداناً).
(فالفرائض من الصلاة شرعت فيها صلاة الجماعة التي تتحول فيها العبادة الفردية إلى عبادة جماعية، تتوثق فيها عرى الجماعة وتترسخ صلاتها الروحية من خلال توحّدها في الممارسة العبادية).
(وحتى فريضة الصيام التي هي بطبيعتها عمل فردي بحت ربطت بعيد الفطر باعتباره الوجه الاجتماعي لهذه الفريضة، الذي يوحّد بين الممارسين لها في فرحة الانتصار على شهواتهم ونزعاتهم).[14]
فأي فهم حقيقي واقعي للدين هذا؟ وأية روعة ودقة في التعبير هذه؟ وأي إقناع وتأثير يستبطن هذا الوعي الهادف المتدفق؟
سابعاً: محاولة تعرّف بعض أسرار التشريع وأهدافه بتعبير مقنع
فهو يجعل المتلقي يشاركه روعة الاكتشاف من خلال التأمل المحايد، والتفكر الحي في أسباب التشريع، ومتابعة مدى تواؤم الطرح التشريعي مع واقع الإنسان واحتياجاته وطموحاته الروحية والجسدية.
إننا لا نغالي ۔ أبداً ۔ إذا قلنا: إن إسلامنا اليوم بحاجة ماسة إلى عقلية كبيرة كعقلية الصدر، وإلى روحية نقية سامية كروحيته، وإلى أسلوب مبدع مؤثر كأسلوبه، لأن إنسان اليوم لا ينتشله من غفلته، ولا يثبّت أقدامه على صراط نجاته، ولا يحرّك عقله الموصود إلا هذا الطرح الصدري أو ما ضارعه من أساليب تعتمد المقومات المؤثرة التي اعتمدها سيدنا الشهيد، فأثْرت وأثّرت، هذا في عصر سرت فيه موجةُ توخّي الحالة العلمية غير الخرافية في شتى صنوف الحياة، المستندة إلى تحرر واقعيّ أو تحرر مزعوم. ولذلك وغيره كانت فكرة التدين البوابة الأولى التي حاول طرقَها بعضٌ، وحاول تهشيمها آخرون لكشف النقاب عن المقدَّس ودراسته ونقده، وإصدار الحكم في حقه بكل قوة وصلابة إرادة ونزوع إلى نبذ القديم المكبّ الخانق (كما يدعي كثيرون) لابد من تفسير وتوجيه وتوضيح ما يمتّ إلى الحالة الدينية والتدينية، خاصة تفسير الطقوس العبادية وإعطاء الأدلة المقنعة على صحة التشريعات، وأسبابها المتصلة بها.
وقد وجدنا السيد الشهيد يدلي بدلوه اللؤلؤي في هذا المنحى متوخّياً الموضوعية وسعة الصدر، ولم يكن على ديدن الكثيرين الذين راحوا يلعنون الظلام، بل كان يوقد الشموع والشموس الواحدة تلو الأخرى بكل هدوء وثقة، مع تأكيده على أن تفسير كل شيء يخرج الإنسان من دائرة تسامي الطاعة إلى دائرة تقصّي المصلحة الذاتية، حتى في الممارسات العبادية التي تهدف أساساً إلى توسيع اهتمامات الإنسان من نطاق الدائرة الأنانية والفردية الضيقة إلى الدائرة الاجتماعية والإنسانية، بل إلى الدائرة الكونية الموحّدة من خلال الإيمان والتحرك باتجاه الله.
وحينما نتفحص ما يصدر عنه الصدر الشهيد من بحر الإسلام العظيم نجده زخّاراً بالطريف والبهيج بل ربما يفاجئنا ببعض اللفتات المدهشة والنظرات العميقة والآراء البكر، فهو إذ ينطق الشهادة الأولى يتأملها بذهنية متوقدة ويحللها في فكره النيّر، فإذا به يقول:
الرفض والإثبات المندمجان في لا إله إلا الله هما وجهان لحقيقة واحدة، وهي حقيقة لا تستغني عنها المسيرة الإنسانية على مدى خطهاا الطويل؛ لأنها الحقيقة الجديرة بأن تنقذ المسيرة من الضياع، وتساعد على تفجير كل طاقاتها المبدعة، وتحررها من كل مطلق كاذب معيق.[15]
وحينما يريد أن يتحدث ۔ فقيهاً ۔ في فتاواه الواضحة عن الاعتكاف نجد اللفتة الذكية، والفهم الواعي للتشريع، فيقول:
وهو مشروع قرآناً وسنة وإجماعاً، ويبدو أن الشريعة الإسلامية بعد أن ألغت فكرة الترهب والاعتزال عن الحياة الدنيا واعتبرتها فكرة سلبية خاطئة <وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها> شرّعت الاعتكاف ليكون وسيلة موقوتة وعبادة محدودة تؤدّي بين حين وآخر لتحقيق نقلة إلى رحاب الله، يعمّق فيها الإنسان صلته بربه ويتزود بها تتيح له العبادة من زاد، ليرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي وقلبه أشد ثباتاً، وإيمانه أقوى فاعلية.[16]
والشهيد الصدر في حديثه عن صلاة الليل يفاجئنا بمصطلح تقطر منه اللمسة الأدبية الفنية حيث يصفها بالعبادة السرية فيقول:
توجد عبادات اختير لها جو من السرية والابتعاد عن المسرح العام كنافلة الليل.[17]
لكن السيد الشهيد لا يستغرق في هذا الجانب، حتى لا يعيش الإنسان الحالة المصلحية في العبادة، ولذلك يقول:
فإذا كان العمل الذي يمارسه العابد مفهوماً بكل أبعاده، واضح الحكمة والمصلحة في كل تفاصيله تضاءل فيه عنصر الاستسلام والانقياد، وطغت عليه دوافع المصلحة والمنفعة، ولم يعد عبادة لله بقدر ما هو عمل نافع يمارسه العابد لكي ينتفع به ويستفيد من آثاره.[18]
إذن نحن أمام خطين متوازيين: خط الفهم العلمي للعبادة، لكي نزداد يقيناً بصحة كل واجباتنا العبادية والتزاماتنا أمام تشريعات الله بكل أقسامها؛ وخط الانقياد الروحي لكل ما يأمر به الله، لنعيش بكل انقطاع وصفاء وتسليم الأجواء العبادية التي يحسها الإنسان كمحدود في كل شيء أمام إله معبود مطلّ في كل ما هو له.
ثامناً: التجديد والإبداع في التعريف والمصطلح
وأظن أن هذا واحد من أهم إنجازات الشهيد الصدر الفكرية التي طوّرت من الأساليب الحوزوية، وأغنت الساحة العلمية، وفتحت أمامها المجال واسعاً رحيباً لتتبوّأ مكانتها الحقيقية في وعي الأجيال، ولما كان هذا البحث معنياً بالجانب الأدبي والفني فقط، فسأعرض عن كثير من الجوانب الأخرى والشواهد القيمة التي تزخر بها آثاره الكثيرة الرصينة في مجال التعريفات والمصطلحات.
والرائع حقاً أنه لا يقتصر ذلك التجديد على استبدال تعريف غامض أو غير فني، بمصطلح واضح له حظ من الفنية فحسب، بل يتخطى هذا إلى ما هو أعمق وأدق وأكثر تطويراً وإثراء على صعيدي النمط الفكري والنمط التفكيري، فلا يكتفي باستبدال تعريف الاجتهاد السابق: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس عجزاً عن المزيد فيه)،[19] أو تعريف التقليد بأنه: (العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل)،[20] أقول: لا يكتفي باستبدالهما بقوله: (الاجتهاد هو التخصص في علوم الشريعة، والتقليد هو الاعتماد على المتخصصين)،[21] بل إنه يطرح تعاريف جديدة، ومصطلحات أبكاراً، في طيّات كتبه ومقالاته، منها على سبيل المثال لا الحصر: (الرشد الذهني)، (التصعيد الذهني)، (الطاقات الوهمية)، (التأليه المصطنع)، (التجريد النسبي)، (الاستبدال الثوري)، (إنسان الأنبياء)، (الثائر النبوي)، وغيرها الكثير.
وهي كلها مشحونة بدلالاتها وإيحاءاتها المكثّفة بالإضافة إلى بساطتها وسهولتها الفريدة، والذي يزيدها عمقاً وتأصلاً وأهمية أنه يجعل منها لبنات تأسيسية لما هو أرقى وأشمل، للوصول إلى طرح جديد يعتمد الاستقراء الحي للهدفية الإسلامية، فيجمع الصدر خيوطها ويصل بين نقاطها ويرسم تفاصيلها ويخرج بنظرة تحليلية شاملة لها تخرجها عن إطار الدراسات المبتورة أو المفككة أو على الأقل التجزيئية، وعن الفهم المتقطع لبعض شرائحها دون البعض الآخر. ولعل في التفسير الموضوعي لمحمد باقر الصدر وفهمه الدقيق للقواعد العامة والسنن القرآنية والتاريخية أبرز الأدلة على ذلك.
وسوف نأخذ عيّنة لفكرة مختصرة تناولها لنعرف كيف يشتقّ المصطلح ثم ينظّر له ثم يجمع الخطوط والخيوط ليقدّم لنا الفكرة الشاملة الحاكية عن الدقة المتناهية لمقاصد آداب الإسلام أو تشريعاته، يقول السيد الشهيد:
بل الثائر النبوي هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بأن الإنسان يستمد قيمته من سعيه الحثيث نحو الله، واستيعابه لكل ما يعنيه هذا السعي من قيم إنسانية، ويشنّ حرباً لا هوادة فيها على الاستغلال باعتباره هدراً لتلك القيم، وتحويلاً للإنسانية من مسيرتها نحو الله وتحقيق أهدافها الكبرى، وإلهائها بالتكاثر وتجميع المال. والذي يحدد هذا الموقع للثائر النبوي مدى نجاحه في الجهاد الأكبر لا موقعه الاجتماعي والانتماء الطبقي.[22]
وفي تعريفه للفيء نجد مثل هذه الروعة حيث يقول:
الفيء كلمة تدل على إعادة الشيء إلى أصله، وهذا يعني أن هذه الثروات كلها في الأصل للجماعة، وأن الاستخلاف من الله تعالى استخلاف للجماعة.[23]
هكذا نجد الشهيد السعيد يأخذ بطروحاته القيمة فكرة الفقه للجماعة أو الدين للجماعة من خلال الإنسان كدائرة صغرى ومن خلال القبيلة والأمة كدوائر أكبر فأكبر، فإذا بنا أمام طرح حي لمرامي التشريع لا على صعيد الإنسان المكلف وينتهي بعد ذلك كل شيء، بل على صعيد مجتمعه وأمته وأبناء جلدته، ثم على صعيد الحركة الكونية المتواصلة في مرضاة الله(عز).
هذه طائفة يسيرة وسريعة من مناحي الأسلوب الفني والأدبي المتميز لدى سيدنا الشهيد الكبير، وقد طبعت بإشراقها أغلب نتاجاته العظيمة التي ما فتئت تنير الدرب لاحباً أمام كل الطامحين لشرف الكلمة النبيلة والفكرة الهادفة والحقيقة الناصعة بعيداً عن الزيف والتضليل والخداع. أما لو درسنا كل نتاج من نتاجاته القيمة على حدة وحاولنا الاستقصاء الشامل لما في هذا النتاج أو ذاك بعمومياته المشتركة مع غيره وبخصوصياته المتركزة فيه لطال بنا المقام في آلاف الصفحات.
يبقى قبل أن ننتقل إلى لمحة سريعة في أسلوبيه الخطابي والمقالي، أن نشير إلى أن الأسلوب الأدبي ۔ دراسياً ۔ لا يعتمد على كل الأسس التي اعتمدها السيد محمد باقر الصدر في كتاباته، بل إنه يقتصر على بعض مما أشرنا إليه فيما سبق.
فقد ذهب كثير من الباحثين حتى من غير العرب، إلى أن الأسلوب الأدبي يقوم على العناصر التالية:
أ ۔ اختيار الجمل وتنسيقها.
ب ۔ تركيب الجمل.
ج ۔ إيقاع العبارات.
د – مضمونها.[24]
أما أسلوب السيد الشهيد فمع كونه محافظاً على هذه المقومات الأساس، إلا أنه اعتمد أُسساً أخرى إضافة إليها، وأضفى عليها من بهاء الاقتباس من القرآن الكريم والتراث العربي هالة ساحرة، تليق بالقيمة العلمية الكبرى لنتاجاته القيمة.
أدبية الخطبة الصدرية وفنّيتها
حينما نلقي الرحال عند واحته الخطابية تدهشنا المفردة المشحونة بالإيحاء، إضافة إلى أسلوب الهمس المؤثر الذي وشّى خطباً مشهورة له، منها خطبة (حب الدنيا). وقد أفاض الدكتور محمد مندور في الحديث عن الهمس في الشعر العربي الحديث ونظّر له،[25] إلا أن الهمس الخطابي الذي تميزت فيه مدرسة المنبر الحسيني في بعض أصنافها، كان له حضور هام على صعيد الذائقة الخطابية الشيعية تحديداً، ومع ذلك فقد تفرّد عن غيره همس محمد باقر الصدر الخطابي، وهو همس خارج إطار المنبر الحسيني.
وهكذا فقد أضاف السيد الصدر جديداً إلى فن الخطبة الدينية، بالإضافة إلى تقنية هامة طبعت خطب الصدر الشهيد، تلك هي شحن الخطبة بالعمق العلمي وتحريرها من المباشرة الخطابية والسطحية الجافة فكرياً، تلك التي ألقت بظلالها الكثيفة العميقة على مجمل الخطب الدينية في العصور المتأخرة، حيث نجد غالبية الخطب الدينية غير مشتملة على شروطها وأدواتها.
ولو اقتبسنا شيئاً من خطبته (حب الدنيا) وحاولنا المرور النقدي السريع عليها فإننا سنتعرف على مزيد من الروعة والجمال.
جاء في خطبته المشار إليها:
بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلوات على سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين.
خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع ولأدوار هذه العناصر، وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية: خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة، وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالاً نسبياً، ولكن كل واحد منهما له تأثير في الآخر على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي، وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فهماً موضوعياً تشكّل أساساً للاتجاه العام في التشريع الإسلامي.. .
ومن هنا نؤمن بأن الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة لمجتمع هي في الحقيقة تحتوي على جانبين: تحتوي على عناصر ثابتة، وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة، وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي تُرك للحاكم الشرعي أن يملأها فرضت أمامه مؤشرات إسلامية عامة أيضاً لكي يملأ هذه العناصر المتحركة وفقاً لتلك المؤشرات الإسلامية العامة.. .
وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان، خاصة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، وسوف أودّعكم فيه، إذ يبدأ التعطيل الموسمي في شهر رجب وشعبان والشهر المبارك، أريد أن نعيش معاً لحظات بقلوبنا لا بعقولنا فقط، بوجداننا، نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلاً عن أن نعرض أفكارنا وعقولنا، في هذه اللحظات الأخيرة، لحظات الوداع معكم، نعرض قلوبنا على القرآن الكريم، لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذلك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ إن الله(عز) لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبّين مستقطبين. إما حب الله، وإما حب الدنيا. أما حب الله وحب الدنيا معاً فلا يجتمعان في قلب واحد؛ فلنمتحن قلوبنا، لنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها؛ هل تعيش حب الله(عز) أو تعيش حب الدنيا؟ فإن كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً وإن كانت ۔ نعوذ بالله ۔ تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل، من هذا المرض المهلك.
إن كل حب يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدى صيغتين، وإحدى درجتين:
الدرجة الأولى: أن يشكّل هذا الحب محوراً وقاعدة لمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الإنسان، قد ينصرف عنه في قضاء حاجته في حدود خاصة، ولكن يعود، سرعان ما يعود إلى القاعدة لأنها هي المركز وهي المحور، قد ينشغل بحديث أو ينشغل بعمل، بطعام، بشراب، بمواجهة، بعلاقات ثانوية، بصداقات، لكن يبقى ذلك الحب هو المحور. هذه هي الدرجة الأولى.
والدرجة الثانية من الحب المحور: أن يستقطب هذا الحب كل وجدان الإنسان بحيث لا يشغله شيء عنه على الإطلاق، ومعنى أن لا يشغله شيء عنه أنه سوف يرى محبوبه قِبلته وكعبته أينما توجّه، أينما توجه سوف يرى ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحب المحور.
هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله، وينطبق على حب الدنيا« حب الله(عز) ۔ الحب الشريف لله المحور ۔ يتخذ هاتين الدرجتين:
الدرجة الأولى: يتخذها في نفوس المؤمنين الطاهرين الذين نظّفوا نفوسهم من أوساخ هذه الدنيا الدنية، هؤلاء يجعلون حب الله محوراً لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم.. .
وأما الدرجة الثانية: فهي التي يصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأئمة(ع)، علي بن أبي طالب الذي نحظى بشرف مجاورة قبره، هذا الرجل العظيم كلكم تعرفون ماذا قال، هو الذي قال: (إني ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه). لأن حب الله في هذا القلب العظيم استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعه من أن يرى شيئاً آخر غير الله.. .
نفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الدنيا، الذي هو رأس كل خطيئة على حد تعبير رسول الله(ص)، حب الدنيا يتخذ درجتين:
الدرجة الأولى: أن يكون حب الدنيا محوراً للإنسان، قاعدة للإنسان في تصرفاته وسلوكه، يتحرك حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك، ويسكن حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن، يتعبد حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد وهكذا، الدنيا تكون هي القاعدة.. .
وأما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل: فهي الدرجة المهلكة، حينما يعمي حب الدنيا هذا الإنسان، يسدّ عليه كل منافذ الرؤية، بحيث إن الإنسان لا يرى شيئاً إلا ويرى الدنيا فيه وقبله وبعده ومعه، حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده وبمنظاره إلى دنيا.. .
علينا أن نحذر من حب الدنيا، لأنه لا دنيا عندنا لكي نحبها، ماذا نحب؟ نحب الدنيا، نحن الطلبة؟ ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد أن نُغرق أنفسنا فيها ونترك رضواناً من الله أكبر؟ نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر.. ما هي هذه الدنيا؟ دنيانا هي مجموعة من الأوهام، كل دنيا وهم لكن دنيانا أكثر وهماً من دنيا الآخرين. مجموعة من الأوهام.. .
لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة.. . دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة، نقيس أنفسنا بهارون الرشيد.. . نحن نقول: إننا أفضل من هارون الرشيد، أورع من هارون الرشيد، أتقى من هارون الرشيد؛ عجباً، هل عُرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها؟ حتى نكون أورع من هارون الرشيد؟ يا أولادي، يا إخواني، يا أعزائي، يا أبناء علي هل عُرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا، عُرضت علينا دنيا هزيلة محدودة ضئيلة. دنيا ما أسرع ما تتفتت، ما أسرع ما تزول، دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد، هارون الرشيد يلتفت إلى السحابة يقول: أينما تمطرين يأتيني خراجك، في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر، هل جرّبنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ جرّبنا أنفسنا؟ طرحنا هذا السؤال على أنفسنا؟ كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله. إن هذه الدنيا دنيا هارون الرشيد كلّفته أن يسجن موسى بن جعفر، هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكّر بأننا أتقى من هارون الرشيد؟![26]
إن هذه المقاطع من خطبة الصدر لو عرضناها سريعاً على مسبار النقد لخرجنا بعدة نتائج:
الأول: إن الخطبة لدى الصدر الشهيد كانت تعتمد أسلوب الخطابة الحديثة، وليست مقتصرةً على النمطية الخطابية القديمة مع عراقتها عربياً وتنوعها، كما يبدو ذلك جلياً من خلال تطورات الخطابة بعد ظهور الإسلام وبروز خطباء مصقعين كالرسول الأعظم(ص) والإمام علي(ع)، ثم أصبحت لها بعد نهضة العرب والمسلمين في الفترة المتأخرة المميزات والتطلع معاً، ولذلك (تمتاز الخطابة الحديثة بسعتها وتنوّع موضوعاتها وحرية أسلوبها، وسمات أفرزها الواقع والتحدي، فبعد أن كانت قبل النهضة ضيقة النطاق تغلب عليها الصناعة ويسودها الإسفاف والتكلف المستهجن أصبحت واسعة المجال تجري في طريق التعبير المرسل الحر).[27]
الثانية: تمكّنه من شروط الخطابة وآدابها المقررة إلى حد أنها كانت واضحة في خطبه المرتجلة دون أن يكون فيها أي تكلف أو تشنج أو تهافت وكأنها إحدى سجاياه التي طُبع عليها، مع أن مضماره هو مضمار البحث العلمي والدراسات الفقهية والأصولية والفكرية العميقة جداً. وهذا نمط مختلف عن فضاءات الخطبة التي تخاطب الجماهير ببساطة، وتحاول التأثير بهم ورفع مستوياتهم بوضوح ومباشرة سطحية بعض الأحيان.
ولو أخذنا صفات الخطيب التي لابد أن يتحلى ويتّسم بها لتكون لديه آداب الخطابة السليمة، لوجدناها متوفرة عنده كاملة بل نجده قد أضفى عليها لمسات مؤثرة خاصة به.
يقول الأستاذ علي محفوظ معدداً صفات الخطيب:
الصفة الأولى: سداد الرأي وأصالة العقل، وتمييزه لوجوه الأمور ومعضلات المشاكل ليهتدي إلى إثبات الحق وإدحاض الباطل بالأدلة المعقولة، حتى يتأثر السامع لقوله وينقاد له.
الصفة الثانية: صدق اللهجة، وصحة القول، وحسن السيرة، ليقع في نفوس السامعين خلوص نيته واستقامة عمله وحرصه على الحقيقة.
الصفة الثالثة: التودد إلى الناس. وموجبات التحبب إليهم كثيرة، منها التحلي بالوقار والتصوّن والوفاء والأمانة والعفة وعزة النفس وعلو الهمة.. .
الصفة الرابعة: رباطة الجأش وشدة القلب.. .
الصفة الخامسة: البديهة الحاضرة وسرعة الخاطر.
الصفة السادسة: أن يكون طلق اللسان بريئاً من الحصر والعيّ واللجلجة والتمتمة والفأفأة والجمجمة والثرثرة وسماجة التكلف والإغراب.
الصفة السابعة: الحذق في إدراك مقتضى الحال، وملاحظة طوائف الناس من الأعلين إلى الأوساط والأدنين، فيختار من الألفاظ ما يناسب كل طبقة، ولا يجرح أحداً ممن يتحبب الأوساط والأدنين، حتى تبقى لخطابته هزة في كل قلب، وتستريح لمغزاها كل نفس.. .
الصفة الثامنة: المهارة في إثارة العواطف وتحريك أهواء النفوس، حتى يجعل أزمّة الحب والبغض والرغبة والنفور والفرح والحزن والرجاء واليأس والشجاعة والخوف والحمية والأنفة والحلم والغضب وغيرها من مشاعر النفس في قبضة يده.
الصفة التاسعة: سعة الاطلاع.
الصفة العاشرة: التجمل في شارته وإشارته وملابسه وهيئته، وهذا وإن لم يكن من الصفات التي تقوم عليها الخطابة إلا أنه أمر يجب العناية به، لأنه مطمح الأنظار، والنظر يفعل في القلوب ما يفعل السمع.[28]
وهذه الشروط أو المقومات أو الصفات واضحة في خطبته، فسداد الرأي وأصالة العقل وإثباته الحق ودحضه الباطل بالأدلة المعقولة واضح الظهور في هذه الخطبة وغيرها، وصدق لهجته وصحة أقواله وحسن سيرته وخلوص نيته واستقامة عمله لا يناقش فيها مناقش، ووقاره ووفاؤه وأمانته وعفته وعزة نفسه وعلو همته لا يشك فيها شاك، ورباطة جأشه وشدة قلبه وبديهته الحاضرة وسرعة خاطره يشهد بها كل من رآه وسمعه، وطلاقة لسانه لا يعكّرها إلا عدم إشباع خروج حرف الراء من مخرجه بشكل تام وهذا ما أعطى نبرة صوته الوديع وقعاً محبباً؛ لأن لثغه بالراء بسيط وغير مشين، أما ما عدا ذلك من هنات اللفظ فلا وجود له ناهيك عن التكلف والإغراب، فلغة الصدر واضحة بسيطة مترسلة معبرة.
وفيما يخصّ ملاحظته مستويات الحاضرين فهو يراعي ذلك تماماً، وفي هذه الخطبة الملقاة أساساً على طلبة العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف نجد حتى الكلمات التي تكررت باستمرار في حلقات الدروس من قبيل قوله: (ما هي قيمة هذه الصلاة؟ ما هي قيمة هذا الصيام؟ وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر إذا كان حب الدنيا هو الذي يملأ القلب؟) فمسائل الصلاة والصيام أقرب إلى انشغالهم وترك هاتين الفريضتين أو شرب الخمر واضح قبحه وشناعته لديهم فاختاره مثلاً.
وأما مهارته في إثارة عواطف المتلقين ففي ما اقتطفنا من المقارنة بين حالهم وحال هارون الرشيد ما يكفي للتدليل عليها، ومثله قوله في الحديث عن قرب أجله:
أبي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن، أخي لم يعش في نفس الحياة أكثر مما عشت حتى الآن، أنا الآن استوفيت هذا العمر، من المعقول جداً أن أموت في السن التي مات فيها أبي…
وفيما يخص سعة اطلاعه فحدّث ولا حرج.
وأخيراً فهيئة السيد الصدر وهيبته وملابسه المذكّرة بملابس الرسول الكريم(ص) وملامح وجهه المهيب وصوته الخاشع كأنه تسبيح كلها عوامل تتظافر لتتجمع مع الصدق في النصيحة والالتزام الكامل مع التطبيق لكل ما ينصح به ويدعو له، دون أدنى تكلف أو ادعاء أو رياء، كل ذلك وغيره جعل خطبة الصدر موثرة ناجحة.
أخيراً: أدبه المقالي
لقد كان النثر الاجتماعي الذي استخدمه الشهيد الصدر في كثير من كتاباته مؤثراً من جملة مؤثرات جعلت النجاح والإقبال حليف ذلك النتاج الكبير والعطاء الثرّ، (فالنثر الاجتماعي يتطلب صحة العبارة، وبالضرورة البعد عن الزخرف والزينة، ووضوح الجمل وترك المبالغات، وسلامة الحجج، وإجراءها على حكم المنطق الصحيح، لأن الغرض منه معالجة الأمر الواقع فلا ينبغي استعمال الأقيسة الشعرية ولا الخيال المجنح، اللهم إلا في المقامات التي تقتضي استفزاز الجماهير وإثارة عواطفهم وتحميسها للإقلاع عن خلّة فاسدة، أو للتظاهر على الاضطلاع بنفع عام، على أن يكون ذلك بقدر، فإن الأغراض الاجتماعية إنما تجري في حدود الحقائق الواقعة على كل حال).[29]
ولقد اشتملت نتاجات الصدر الكبير النثرية على ذلك، وأضافت إليه روعة طرح الفكرة العلمية الدقيقة في قوالب من اللغة السهلة الممتنعة التي تدلل على عظمة لغة القرآن، حيث تنضج فيها الفكرة كزهرة ربيعية تفوح بالشذا الزكي، هذا إلى جانب إتقان الأدوات الخاصة بفن المقالة.
ومقالة الصدر الموضوعية لو أدخلناها إلى مختبر النقد لوجدناها محتوية على مقوماتها بإتقان، حيث (تعنى المقالة الموضوعية بتجلية موضوعها بسيطاً واضحاً خالياً من الشوائب التي قد تؤدي إلى الغموض واللبس) و(تحرص على التقيد بما يتطلبه الموضوع من منطق في العرض والجدل وتقديم المقدمات واستخراج النتائج).[30]
وحينما نتكلم عن المعايير النقدية للمقالة فإنما نقصد بها المعايير السليمة الحديثة، لا تلك التصورات التي عُرفت في القرن الثامن عشر لدى الإنجليزي جونسون وأضرابه حيث يعرّف المقالة بأنها (نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظم، هي قطعة لا تجري على نسق معلوم، ولم يتم هضمها في نفس كاتبها).[31]
وقبل كل هذا وذاك علينا أن نفرّق بين أديب يكتب بنفس علمي، وبين عالم يكتب بنفس أدبي، وقد كان الشهيد الصدر من النوع الثاني، لكنه حقاً كان متميزاً، وقد أشار في مقدمة كتابه القيم (اقتصادنا) إلى ذلك بقوله:
إن هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي فحسب، ولا يعني بصبّه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفاء، وإنما هو محاولة بدائية ۔ مهما أوتي من النجاح وعناصر الابتكار ۔ للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام.[32]
إذن فكل همه الفكرة والمضمون، وليس القالب والشكل، لكنه يريده قالباً جميلاً دون تكلف أو إسفاف، وقد تم له ما أراد.
وللمزيد من الفائدة والاطلاع على أدبه المقالي تُراجع الافتتاحيات التي كان يكتبها لمجلة الأضواء النجفية التي أغنت الشباب المثقف وأسست لحركة ثقافية وتنويرية كبرى.
ونذكّر في الختام بأن الشهيد الصدر لم يكن لديه الوقت الكافي للتأنق والتحكيك وانتقاء المفردة، حيث تدلنا على ذلك تواريخ انتهائه من تآليفه، فلا يكاد ينتهي من مشروع كتابي حتى يباشر في مشروع جديد، وكأنه في سباق مع الزمن ومخاتلة للقدر، وللتدليل على هذا نجده قد فرغ من (الفتاوى الواضحة) في ليلة 22 ربيع الثاني 1396ق، وفرغ من (نظرة عامة في العبادات) في 2 جمادى الأولى 1396ق، أي بعد عشرة أيام من الفراغ من الفتاوى الواضحة. ولم يستغرق في (موجز في أصول الدين) إلا ثلاثة عشر يوماً، هي فترة التعطيل من 27 ذي الحجة 1396ق حتى 10 محرم 1397ق، مع العلم أنها فترة مهمة في الحوزة العلمية، مليئة بالزيارات والتعازي، بل يقال: إن السيد الصدر ما كانت كتبه إلا مسودات، فلم يُعِد كتابتها إنما أرسلها إلى المطابع دون تبييضها.
أجل لقد كان للسيد الشهيد الصدر رؤيته السليمة، ووعيه الفذ، وصدقه النادر، وأسلوبه المتميز، وتأثيره الكبير على الساحة الفكرية والثقافية والأخلاقية والجهادية.
فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً.
[1]. أديب شاعر مفكر في الحوزة العلمية.
[2]. سبأ: 24.
[3]. اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ط دار التعارف، ص 17.
[4]. الإسلام يقود الحياة، خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، محمد باقر الصدر، ص 109.
[5]. اقتصادنا، ص 12.
[6]. الإسلام يقود الحياة، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، ص 27.
[7]. موجز في أصول الدين، محمدباقر الصدر، ص 67 ۔ 68.
[8]. م. ن، ص 34 ۔ 35.
[9]. م. ن، ص 82.
[10]. م. ن.
[11]. البلاغة الصافية، د. حسن اسماعيل عبد الرزاق، دار السعادة، ج 1، ص 136.
[12]. نظرة عامة في العبادات، محمد باقر الصدر، ص 724.
[13]. م. ن، ص 725.
[14]. م. ن، ص 229 ۔ 725.
[15]. م. ن، ص 712.
[16]. الفتاوى الواضحة، محمد باقر الصدر، ص 655.
[17]. نظرة عامة في العبادات، محمد باقر الصدر، ص 720.
[18]. م. ن، ص 722.
[19]. شرح مختصر الأصول، الحاجبي، ص 46؛ تهذيب الأحكام، العلامة الحلّي، ص 100.
[20]. منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي، ط 8 – 1408، ص 5.
[21]. الفتاوى الواضحة، محمد باقر الصدر، ص 89.
[22]. الإسلام يقود الحياة، صورة عن اقتصاد المجتع الإسلامي، محمد باقر الصدر، ص 43۔44.
[23]. م. ن، ص 45.
[24]. فن المقالة، د. محمد يوسف نجم، دار الثقافة 1966، ص 124.
[25]. لقد تناول الدكتور مندور مسألة الهمس في الشعر المهجري وغيره في عدد من بحوثه ومقالاته وكتبه وقد ثار ضده عدد من الأدباء والنقاد في سجال معروف.
[26]. الخطبة التي ألقاها في 5 رجب 1399ق. وراجع: هكذا قال الصدر في المحنة وحب الدنيا، إعداد ميثم الجاسم، ص 73 ۔ 89.
[27]. الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة، أنيس المقدسي، دار العلم للملايين 1980، ص 399.
[28]. فن الخطابة وإعداد الخطيب، علي محفوظ، دار الاعتصام، ص 41 ۔ 44.
[29]. في الأدب الحديث، عمر الدسوقي، ط 3، دار الفكر العربي 1954، ص 219.
[30]. فن المقالة، ص 97.
[31]. أدب المقالة، د. زكي نجيب محمود.
[32]. اقتصادنا، ص 32.