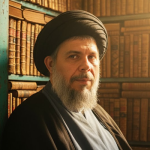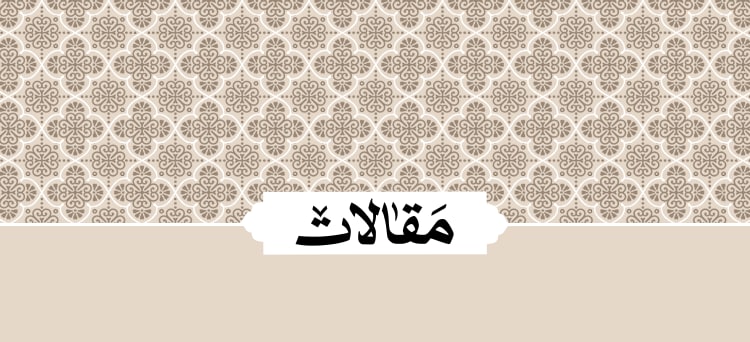نشرنا في العدد الثاني في حقل حصاد المجمع تعريفاً بكتاب «دروس في علم الاُصول» للشهيد الصدر (قدس سره) والذي حقّقه وقدّم له أحد أفاضل تلامذة السيّد الشهيد (قدس سره).وتضمّن ذلك التعريف مجموعة ملاحظات اُوردت على مقدّمة المحقّق الفاضل وعلى منهجة السيّد الشهيد (قدس سره).
وقد وردنا مقال يناقش الملاحظات المبحوثة، ننشره كما ورد في حلقتين آملين انكشاف الحقيقة لدى طلاّبها.
تمهيد:
«دروس في علم الاُصول» كتاب دراسي في علم اُصول الفقه ألـّفه في ثلاث حلقات لثلاث مراحل دراسيّة، سماحة آية اللّه العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره). وقد مضى على دخوله ميدان التدريس في الحوزة العلميّة المباركة حوالي سبعة عشر عاماً[1]، ولم يخضع منذ ذلك التأريخ إلى تحقيق أو تصحيح تامّ للأخطاء الواردة فيه رغم تعدّد الطبعات إلى حين تصدّي سماحة العلاّمة السيّد علي أكبر الحائري حيث بذل جهوداً مباركة في مجال تحقيقه وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء مطبعيّة.
وليس خفيّاً أنّ السيّد المحقّق أحد الذين تتلمذوا على يد السيّد الشهيد (رحمه الله)، وهو صاحب الممارسة القديمة والمتكرّرة في تدريس الحلقات في الحوزة العلميّة سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدّسة. وقد مارس عمليّة التصحيح للكتاب في حياة السيّد الشهيد وتحت إشرافه، وقد جمع ما دوّنه في ذلك ضمن جدول الخطأ والصواب، وكانت من الأهميّة بمكان بحيث قال السيّد الشهيد (رحمه الله) له: «أنت أحييت هذا الكتاب».
وبعد تهجيره إلى جمهوريّة إيران الإسلاميّة استطاع من خلال تدريسه المتكرّر للكتاب أن يجمع تلك التصحيحات ويزيد عليها الكثير، فاهتمّ بتحقيق الكتاب سيّما بعد أن بلغه أنّ السيّد الشهيد أوصى وهـو فـي ظــرف احتجـازه بالاهتمـام بالتصحيحات وأخذها بعين الإعتبار في الطبعات الجديدة للكتاب[2]. وأخيراً تمّ تحقيق الحلقة الاُولى والثانية وطبعهما من قِبَل مجمع الفكر الإسلامي عام 1413 هـ مع شيء يسير من التعليقات الضروريّة وهو الآن مشغول بتحقيق الحلقة الثالثة مع تعليقات أوسع من الحلقتين السابقتين، ندعوه تعالى أن يوفّقه لذلك.
هذا، وقد نشرت مجلّة الفكر الإسلامي في عددها الثاني من سنتها الاُولى في صفحة 283 موضوعاً للسيّد علي مطر ذكر فيه خمس ملاحظات. ثلاث منها تخصّ ما أورده السيّد المحقّق في مقدّمة الكتاب والأخيرتان حول ما ذكره السيّد الشهيد (قدس سره) في بحث تعارض الأدلّة. وذكر أيضاً اقتراحين يجدهما أولى من منهجة البحث التي اعتمدها السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) في بحث تعارض الأدلّة.
وأنا في الوقت الذي أرى فيه أنّ مسألة إثارة الملاحظات والشكوك حول فكرة أو اُطروحة مّا مساهمة في تكاملها وإثرائها وسبب لدفع ما يتوهّم بشأنّها، أرى على ضوء ما استفدته من السيّد الاُستاذ (محقّق هذا الكتاب) الذي كان تتلمذي في درس السطح سيّما درس الاُصول منه لديه ـ حصول نوع من الإلتباس فيما سجّله السيّد علي مطر في مقاله المذكور. وساُحاول إيضاح ما التبس إن شاء اللّه تعالى.
1ـ حول ما ورد في متن الكتاب:
ما سجّله السيّد علي مطر على ما ذكره السيّد الشهيد (رحمه الله) في متن كتاب الحلقات يتلخّص في ملاحظتَين واقتراحَين:
الملاحظة الاُولى: حول ما ذكره السيّد الشهيد (رحمه الله) من أنّ أحد أقسام التعارض هو التعارض بين الأدلّة المحرزة والاُصول العمليّة.
فسجّل عليه قوله: «ويلاحظ عليه أنّه لا يعقل وجود التعارض الأخير بين الأدلّة والاُصول ما دامت الاُصول في طول الأدلّة المحرزة، إذ لا تصل النوبة إليها إلاّ بعد فقد الدليل المحرز قطعيّاً كان أو ظنّيّاً».
الملاحظة الثانية: حول ما ذكره السيّد الشهيد (رحمه الله) من أنّ أحد أقسام التعارض هو التعارض بين أصلَين عمليَّين.
فسجّل عليه قوله: «كما أنّه لا تعارض بين الاُصول العمليّة أيضاً ما دام لكلٍّ منهما مجاله الخاصّ الذي يجري فيه، فالبراءة تجري عند عدم العلم مطلقاً، والاحتياط يجــري فـي مجــال العــلم الإجمــالي، والاستصحاب يجري عند الشكّ المسبوق بالعلم».
وأمّا الاقتراحان اللذان يجدهما أولى من منهجة البحث التي اعتمدها السيّد الشهيد (رحمه الله) فهما:
الأوّل: قوله: «فكان الأولى قصر هذا البحث ]يعني بحث التعارض[ على تعارض الأدلّة ]يعني الأدلّة المحرزة [وإيراده بعدها قبل الكلام على الاُصول العمليّة».
الثاني: قوله: «هذا مضافاً إلى أنّه من الأنسب تسمية هذا البحث [يعني بحث التعارض] بـ (علاقات الأدلّة) وتقسيمها إلى التخصيص، والتقييد، والورود، والحكومة، والتعارض، ذلك لأنّ التعارض واحدٌ من العلاقات القائمة بين الأدلّة، فلا مسوّغ لجعله عنواناً للبحث دونهما».
أقول: بما أنّ ما سجّله في الملاحظتَين وما ذكره في الاقتراحَين ينشأ من منشأ واحد وهو عدم الفهم الصحيح لمعنى التعارض، إذن لا بدّ أوّلا من التمهيد للجواب بتقديم مقدّمة نبيّن من خلالها معنى التعارض، ومن ثمّ ـ وعلى ضوء المقدّمة ـ نوضّح مواطن التوهّم في الملاحظتَين والاقتراحَين.
أمّا المقدّمة فهي:
إنّ معنى التعارض في علم الاُصول هو: التنافي بين مدلولَي الدليلَين الحاصل من أجل التضادّ بين الجعلَين المفادَين بهما[3]. ومجرّد وجود الجمع العرفي بينهما كالتخصيص، أو التقييد أو الحكومة لا يعني ارتفاع التنافي بين مدلوليهما فإنّ الدليل العام مثلا تبقى دلالته على العموم ثابتة رغم مجيء المخصّص المنفصل، وكذا الدليل المطلق عند ورود المقيّد المنفصل لأنّ غاية ما تقتضيه قواعد الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين في هكذا حالات هو أن يكون أحد الدليلَين مفسّراً للآخر بحيث يسقط أحدهما عن الحجّيّة مع بقائه على دلالته من إطلاق أو عموم مثلا. فمشكلة التعارض تُحلّ بسقوط حجّيّة العامّ في العموم والمطلق في الإطلاق، لا برفع دلالتهما فيهما من الأساس. وهكذا الحال في كلّ قرينة منفصلة، ذلك لأنّها لا تزيل ظهور ذي القرينة بمعارضتها إيّاه، بل تتقدّم عليه في مستوى الحجّيّة فقط. وهذا ما صرّح به السيّد الشهيد (رحمه الله) في أكثر من موضع من الحلقات الثلاث:
كقوله (رحمه الله): «وأمّا القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئاً من هذه الظواهر، وإنّما تشكّل تعارضاً بين ظهور الكلام الأوّل وبينها، وتتقدّم عليه وفق قواعد الجمع العرفي»[4].
وقوله (رحمه الله): «فإنّ القرينة المنفصلة لا تحول دون تكوّن أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنّما تسقطه عن الحجّيّة»[5].
وقوله (رحمه الله): «وعلى هذا الضوء نعرف أنّ القرينة مع الاتّصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة»[6].
وعلى هذا الأساس قسّم الشهيد الصدر (رحمه الله) التعارض إلى قسمَين:
قسم يمكن إجراء قواعد الجمع العرفي فيه وسمّاه بالتعارض غير المستقرّ، وقسم لا يمكن إجراء ذلك فيه وسمّاه بالتعارض المستقرّ[7]، فإنّ هذا التقسيم لا يعني أنّ ما تجري فيه قواعد الجمع العرفي يخرج من باب التعارض، بل إنّما يعني رفع اليد عن دلالة الدليل المغلوب من حيث الحجّيّة بالمقدار الذي تقتضيه دلالة الدليل الغالب وفق قواعد الجمع العرفي رغم بقاء أصل الظهور التصديقي للدليل المغلوب في إرادة المعنى الحقيقي للكلام، فالتعارض ينحلّ على مستوى الحجّيّة إذن لا على مستوى أصل الدلالة.
وعلى ضوء ذلك أقول:
أمّا الملاحظة الاُولى فاتّضح حالها بمعقوليّة وجود التعارض بين الأدلّة المحرزة والاُصول العمليّة رغم كون الثانية في طول الاُولى، ذلك لأنّ الطوليّة هذه إنّما حصلت ببركة إجراء قواعد الجمع العرفي بعد وقوع التعارض غير المستقرّ بين الدليل المحرز والأصل العملي. فمثلا لو دلّ دليل محرز ظنّي كخبر الثقة الحجّة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فسيقع التعارض بينه وبين ما دلّ على البراءة في مطلق ما لا يُعلم، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رُفع عن اُمّتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون…»[8] ، ثمّ ببركة إجراء بعض قواعد الجمع العرفي كالحكومة ـ بناءً على إحدى محاولات تبرير تقدّم الأمارة على الأصل ـ تتضيّق دائرة دليل البراءة فلا يكون حجّة في مورد الدليل المحرز.. وهذا معنى عدم جريان الأصل العملي إلاّ بعد فقدان الأدلّة المحرزة وقد نطق به الشهيد الصدر (رحمه الله) مشروحاً في الحلقتين الاُولى[9] والثانية[10].
إذن فلا تصلح الطوليّة بين الأدلّة المحرزة والاُصول العمليّة دليلا على عدم وقوع التعارض بينهما، لأنّ هذه الطوليّة إنّما حصلت بسبب وقوع التعارض بينهما أوّلا، ثمّ جريان بعض قواعد الجمع العرفي بينهما.
نعم، يمكن أن يقال بأنّ التعارض بين الأدلّة المحرزة والاُصول العمليّة يرجع بروحه إلى التعارض بين دليلَين محرزَين لأنّ التعارض في المثال المتقدّم مثلا يقع في الحقيقة بين دليل الأصل العملي ـوهو حديث الرفع المذكورـ وبين دليل حجّيّة خبر الثقة القائل بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهما من الأدلّة المحرزة.
لكن هذا غير ما تمسّك به الملاحظ من الطوليّة بين الاُصول العمليّة والأدلّة المحرزة.
أمّا الملاحظة الثانية فاتّضح حالها أيضاً بمعقوليّة وقوع التعارض بين الاُصول العمليّة، بمعنى كونه بين أدلّتها المحرزة كما أوضحناه. وإنّ ما احتجّ به السيّد الملاحِظ من أنّ لكلِّ أصل عمليٍّ مجاله الخاصّ الذي يجري فيه لا ينهض دليلا على نفي التعارض بينها، لأنه في مرتبة ما بعد وقوع التعارض، فالاختصاص المذكور إن وجد، فإنّما هو ببركة تطبيق بعض قواعد الجمع العرفي عليها بعد تعارضها، فإذا قام الدليل على أصالة البراءة الشرعيّة في كلّ ما لا يعلم وقام الدليل أيضاً على أصالة الاحتياط في بعض الشكوك كالشكّ في موارد الدماء والفروج، وقع التعارض بينهما
في النتيجة العمليّة في مورد أصالة الاحتياط فيحصل التعارض المصطلح بين دليليهما، وبما أنّ دليل الأوّل مطلق ودليل الثاني مقيّد فيقع التعارض بينهما على نحو الإطلاق والتقييد، وبتطبيق قاعدة تقديم المقيّد على المطلق ـ حسب مقتضى قواعد الجمع العرفي في باب التعارض غير المستقر ـ يقدّم دليل أصالة الاحتياط في مورده على أصالة البراءة. وبذلك يحصل الاختصاص المذكور.
كما أنّه يمكن وقوع التعارض أيضاً بين أصالة البراءة الشرعيّة مع الاستصحاب، فإنّ دليل البراءة الشرعيّة مطلق شامل لكلِّ شكّ سواء كان مسبوقاً باليقين أم لا، بينما دليل الاستصحاب خاصّ بالشكّ المسبوق باليقين، فيقع التعارض بينهما أيضاً، فيقدّم دليل الاستصحاب على أساس قواعد الجمع العرفي كالحكومة مثلا.
وعلى هذا الأساس يظهر أنّ اختصاص كلّ أصل عملي بمورده الخاصّ كثيراً ما يكون في طول تعارضه مع أصل عمليٍّ آخر، وتقديم أحدهما على الآخر بتطبيق قواعد الجمع العرفي. وقد مثّل السيّد الشهيد (رحمه الله) في الحلقة الاُولى له بالحالة البارزة وهي التعارض بين البراءة والاستصحاب.
ولا بأس بالتنبيه على خطأ آخر حصل لدى السيّد الملاحِظ في دعواه باختصاص أصالة الاحتياط بموارد العلم الإجمالي، فإنّ هذا خلط بين أصالة الاحتياط الشرعيّة وأصالة الاحتياط العقليّة، فإنّ الذي يجري في أطراف العلم الإجمالي إنّما هي «أصالة الاحتياط العقليّة»، وهي لا تدخل في بحث التعارض المصطلح لاختصاصه بالأدلّة الشرعيّة باعتبار ما لها من مدلول وجعل تكشف عنه. وأمّا أصالة الاحتياط الشرعيّة التي يمكن وقوع التعارض بينها وبين غيرها فإنّما تجري في مثل الدماء والفروج.
وأمّا الإقتراحان:
فالأوّل منهما قصر البحث في باب التعارض على تعارض الأدلّة المحرزة، وإيراده قبل الكلام على الاُصول العمليّة.
وقد انتفى موضوع هذا الاقتراح بما أوضحناه من عدم اختصاص التعارض بالأدلّة المحرزة.
ثمّ إنّ التعارض بين الاُصول العمليّة وإن كان يسري إلى أدلّتها المحرزة ـ على ما مضى ـ لكنّه لا يعني عدم تأثّر تلك الاُصول به، لأنّ ما يجري على أدلّتها من قواعد باب التعارض كالتخصيص والتقييد والحكومة يؤثّر بصورة مباشرة عليها فيتقدّم مثلا بعض الاُصول العمليّة على بعض أو يضيّق بعضها من دائرة البعض.
والثاني منهما تسمية بحث التعارض بـ (علاقات الأدلّة)، وتقسيمها إلى: التخصيص والتقييد والورود والحكومة والتعارض معلّلا ذلك بأنّ التعارض واحد من العلاقات القائمة بين الأدلّة، فلا مسوّغ لجعله عنواناً للبحث دونها.
وقد اتّضح أمر هذا الاقتراح أيضاً بما ذكرنا من أنّ التخصيص والتقييد والحكومة جميعها من قواعد الجمع العرفي في بحث التعارض غير المستقر، فلا وجه لجعلها قسيماً للتعارض، وإنّما هي أقسام منه.
لكن على ما عرّفنا به التعارض المصطلح ستخرج قاعدة الورود خاصّة عن التعريف، ذلك لكون القاعدة مختصّة بحالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، في حين أنّ اصطلاح التعارض مختصّ بما إذا كان التنافي بين الجعلين، وقد أوضح ذلك الشهيد الصدر في كتاب الحلقات[11]. لكنّ هذا لا يقتضي إفرادها ببحث مستقلٍّ لشدّة الترابط والتشابه بينها وبين قاعدة الحكومة، ووقوع الاختلاف بين العلماء في تطبيق هذه القاعدة أو تلك في بعض حالات التعارض، كما في وجه تقديم الأمارات على الاُصول، فالبعض حاول توجيهه بكون دليل الأمارة وارداً على دليل الأصل، وبعض آخر حاول توجيهه بكون دليل الأمارة حاكماً على دليل الأصل على تفسير وشرح ذكره السيّد الشهيد[12] (رحمه الله).
الـى هنـا ننتـهي مـن المـلاحظـات والاقتراحات التي أوردت على متن الكتاب وبه اتضح وجه الاشكال فيها.
يتبع
«دروس في علم الاُصول»
الشيخ حامد الظاهري
2ـ حول مقدّمة التحقيق:
الملاحظات التي أوردها السيّد مطر حول ما جاء في مقدّمة تحقيق الكتاب تتلخّص في ثلاث نقاط:
1ـ الشهيد الصدر ونظريّة القرن الأكيد:
جاء في المقدّمة: «إنّ نظريّة القرن الأكيد هي من النظريّات التي أبدعها اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في علم الاُصول وقد فسّر بها عمليّة الوضع في بحث الدلالة»[13]. وقد لاحظ عليه بقوله:
“المعروف إنّ هذه النظريّة من إبداع بافلوف وقد قام هو بنفسه بتطبيقها في مجال اللغة، كما ذكر ذلك السيّد الشهيد في كتاب إقتصادنا ».
أقول: إنّ هناك فرقاً جوهريّاً بين نظريّة (القرن الأكيد) التي تعدّ من إبداعات السيّد الشهيد (رحمه الله) في تفسير الوضع اللغوي في علم الاُصول وبين نظريّة (المنبّه الشرطي) التي توصّل إليها العالم الفيزيولوجي (بافلوف) في تجاربه التي حاول فيها وضع الأساس الفيزيولوجي لعلم النفس.
ويمكن توضيح هذا الفرق من خلال النقاط التالية:
أوّلا: إنّ غاية ما استطاع أن يدلّل عليه بافلوف من خلال تجاربه ـ بغضّ النظر عن الاستنتاجات الخاطئة من قبل أحد روّاد بعض المدارس الفكريّة المادّيّة الذي حاول أن يستفيد منها لصالح معتقداته ـ هو أنّه إذا ارتبط واقترن شيء معيّن بمنبّه طبيعيّ اكتسب نفس فعاليّته وأخذ يقوم بدوره ويحدث نفس الاستجابة التي يحدثها المنبّه الطبيعي.
فتقديم الطعام إلى الكلب مثلا منبّه طبيعي يحدث فيه استجابة سيلان اللعاب لديه عند رؤية الطعام، فلو اقترن دقّ الجرس مع تقديم الطعام عدّة مرّات سوف يحدث سيلان اللعاب لدى الكلب كما كان نفس تقديم الطعام يحدثه، فدقّ الجرس نفسه يحدث نفس الفعل المنعكس الذي كان المنبّه الطبيعي يحدثه ويؤدّي دوره. فأطلق على دقّ الجرس اسم (المنبّه الشرطي) وعلى سيلان اللعاب الذي يحدثه دقّ الجرس اسم (الاستجابة الشرطيّة).
وقد ذكر صاحب الملاحظة أنّ هذه النظريّة قام بافلوف نفسه بتطبيقها على مجال اللغة في حين أننا نرى أنّ بافلوف لو كان قد طبّق ذلك على مجال اللغة فليس ذلك في مجال تفسير دلالة اللفظ على معناه بل في مجال دعوى أنّ اللفظ بعد دلالته على معناه سيحدث نفس الاستجابة التي يحدثها المنبّه الطبيعي لدى الإنسان.
فمثلا يقال: كما انّ الإحساس الخارجي والرؤية الفيزيائيّة لمظاهر الطبيعة بأشجارها المورقة وأزهارها المتفتّحة وأرضها المخضرّة تورث في النفس انشراحاً وتملؤها بهجة والتذاذاً كذلك سماع الألفاظ – التي تحكي هذه المظاهر وترسم للسامع هذه الصورة الجميلة من الطبيعة ـ يورث في النفس نفس ما كان يورثه الإحساس الخارجي بالطبيعة… وكذا الألفاظ والكلمات التي تحكي الممارسـات الفجيعة (كالذي يجري الآن على شـعب البوسـنة المسـلم.. من قبل الصـربيّين الجُناة) يثير في النفـس نفـس ما يثيره الإحسـاس الفيزيائي بتلك الممارسـات وإن تفاوتت الاستجابة في مسـتوى الشدّة والضعف بين اسـتجابة المنبّه الطبيعي والمنبّه الشرطي في ذلك.
والملاحظ من خلال ذلك أنه اُخذت دلالة اللفظ على معناه المحسوس أمراً مفروغاً عنه ولم يرِد أي تصريح به؛ لأنه لم يكن بافلوف بصدد تفسير دلالة اللفظ على معناه، وإنّما كان غرضه دراسة استجابة شرطيّة أوجدها منبّه شرطي.. بل هذا واضح حتّى في كلمات من أراد أن يستنتج من تجارب بافلوف ما يفسّر به عامّة الإدراكات والنشاطات العقليّة لدى الإنسان تفسيراً يخضعها فيه للنشاط العضوي للمخّ كالكاتب الماركسي (جورج بوليتزر) حيث يقول:
«وقد اكتشف ]يعني بافلوف[ من ناحية اُخرى أنّ الكلمات ـ بمضمونها ومعناها ـ يمكن أن تحلّ محلّ الإحساسات التي تحدثها الأشياء التي تدلّ عليها»[14].
فقد فهم هذا الكاتب من اكتشافات بافلوف أنه كان بصدد بيان أنّ أدوات اللغة (بمضمونها ومعناها) يمكن أن توجِد نفس الاستجابات والمنعكسات الفسيولوجية للأشياء التي تدلّ عليها وإن حاول أن يحمّل النتائج التي توصّل إليها بافلوف ما لا تطيق، لذا نسب السيّد الشهيد هذه الاستفادات إلى جماعة لا إلى بافلوف نفسه في قوله:
«وعلى هذا الأساس حاول جماعة أن يفسّروا الفكر الإنساني كلّه تفسيراً فسيولوجيّاً»[15].
كما نسب ذلك إلى المدرسة السلوكيّة في قوله:
«… هذه هي نظـريّة العـالم الفيزيولوجي (بافلوف) وقد استغلّته السلوكيّة فزعمت أنّ الحياة العقليّة لا تعدو أن تكون عبارة عن أفعال منعكسة»[16].
وأمّا قول السيّد الشهيد (رحمه الله): «وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين إشاريّين…»[17] ، فليس مراده منه نسبة الافتراض المذكور إلى بافلوف حقيقةً وإنّما ذكره (رحمه الله) حكاية منه لما قالته تلك الجماعة التي ذكرها في صدر حديثه وقد مضى ذكرها في النصّ السابق منّا، فهي امتداد لبيان محاولة تلك الجماعة التي حاولت أن تفسّر الفكر الإنساني كلّه تفسيراً فسيولوجيّاً.
وبهذا يتّضح أنّ فكرة (المنبّه الشرطي) لم تكن قد طُبّقت في مجال اللغة من قبل بافلوف نفسه إلاّ بالمقدار الذي ذكرناه وهو خلاف ما ذكر السـيّد مطر في ملاحظاته.. والغريب أنه أسـند نقل ذلك إلى السـيّد الشـهيد (رحمه الله)، في حين أنه لم يذكر ذلك ناسـباً إيّاه إلى بافلوف، وإنّما نسـب تطبيق هذه النظـريّة على الفكـر الإنسـاني عامّة إلى جماعة تارةً وإلى السـلوكيّة اُخرى كما ذكرنا.
ثانياً: لو أخذنا بعين الإعتبار الاسـتنتاجات التي حصلت من روّاد المدارس الفكريّة أو السـيكولوجيّة في مجال الظواهر الاجتماعيّة كظاهرة اللغة ممّا اكتشفه بافلوف من (المنبّه الشرطي)، فسـوف نجد أيضاً فرقاً جوهريّاً بين ما قاله السيّد الشهيد الصدر في نظريّة (القرن الأكيد) وبين ما توصّل إليه هؤلاء من تطبيق فكرة (المنبّه الشرطي) على مجال اللغة، فإنّ هؤلاء افترضوا وجود منبّهات طبيعيّة لفكر الإنسان وهي المحسوسات الخارجيّة التي تستثير استجابات معيّنة فيه، ثم افترضوا وجود منبّهات شرطيّة تستثير نفس الاستجابات في الفكر الإنساني التي كانت تستثيرها المنبّهات الطبيعيّة بسبب إشراطها واقترانها بتلك المنبّهات الطبيعيّة ومن جملتها أدوات اللغة وألفاظها، فإنّ كلمة (ماء) مثلا بسبب اقترانها مراراً بالماء المحسوس أصبحت منبّهاً شرطيّاً يوجد نفس الاستجابة التي تحصل في الفكر برؤية نفس الماء المحسوس.
وبغضّ النظر عن تفسير هذه الاستجابة من حيث كونها نشاطاً مادّيّاً أو أمراً غير مادّيّ فإنّ هذه النظريّة تفترض وقوع الإشراط والإقتران بين مناشىء الاستجابة أي بين (الماء المحسوس) وبين سماع كلمة (ماء) لتحصل نفس الاستجابة المثارة من المنبّه الأوّل.
بينما (نظريّة القرن الأكيد) ترى وقوع الاقتران بين تصوّر الماء الخارجي وتصوّر كلمة (ماء) لا بين نفس الماء المحسوس ونفس اللفظ المسموع.. فهنا قرن أكيد بين تصوّرين مختلفين يُراد به خلق القدرة لدى أحد التصوّرين على أن يستثير التصوّرالآخر في النفس، فيكون تصوّر اللفظ مستتبعاً لتصوّر المعنى.
وفي نظريّة المنبّه الشرطي يراد الربط بين الأشياء الخارجيّة المحسوسة لاستثارة استجابة معيّنة كالربط الذي أوجده بافلوف بين رؤية الطعام وسماع دقّ الجرس من قبل الكلب لاستثارة تحلّب وسيلان لعابه عند دقّ الجرس.
هذا على الصعيد النظري ويترتّب عليه فرق على الصعيد العملي وهو أنه بناءً على (نظريّة القرن الأكيد) بإمكان أيّ شخص أن يجلس في غرفته بعيداً عن العالم ويضع أيّ لفظ شاء لأيّ معنىً شاء بتكرار عمليّة القرن بين تصوّريهما في ذهنه حتّى يحصل الربط الأكيد بينهما كما إذا تصوّر معنى البحر وقرنه كراراً بتصوّر لفظ من الألفاظ فإنّه تحصل بذلك العلقة اللغويّة في ذهنه خاصّة بين معنى البحر وبين ذلك اللفظ.. كما انّه لو استطاع أن يوجد هذين التصوّرين في ذهن جمع من الناس ويكرر عمليّة الربط بينهما ولو من دون إراءة البحر لهم مباشرة كفى ذلك لحصول العلقة اللغويّة في ذهن هؤلاء الناس أيضاً.. في حين أنّ هذا الأمر غير ممكن بناءً على نظريّة (المنبّه الشرطي) لأنها ترى ضرورة الإقتران بين الإحساس بالبحر الخارجي وبين سماع ذات اللفظ، فلأجل حصول المنبّه الشرطي لا بدّ من الذهاب لزيارة البحر والنظر إليه مباشرة مقترناً به سماع أي لفظ يختاره مكرّراً ذلك مراراً حتّى تتمّ العلقة ويترتّب على سماع اللفظ نفس ما كان يترتّب على رؤية البحر من فعل منعكس، وبذلك تتمّ المنبّهيّة الشرطيّة للّفظ المختار.. وكذا لو اُريد إيجاد هذه المنبّهيّة لدى جماعة من الناس لا بدّ أن يسافر بهم إلى البحر ويكرّر نفس العمليّة السابقة.
ثالثاً: اتّضح ممّا سبق أنّ من أساء استغلال نظريّة المنبّه الشرطي ـ من روّاد المدارس المختلفة وطبّقها على عموم النشاطات الفكريّة والإدراكات البشريّة بما فيها العمليّات الفكريّة الناشئة من استخدام ألفاظ اللغة وأدواتها ـ قد فسّر العلقة اللغويّة بالاستجابة المادّيّة للمنبّه الشرطي على أنها عمليّة وظيفيّة يؤدّيها المخّ، في حين أنّ (نظريّة القرن الأكيد) لا تنظر إلى الاستجابة المزعومة أبداً بل تجعل العلقة اللغويّة بين تصوّرين مجرّدين من المادّة وتؤكّد على أنّ الانصرافات الذهنيّة التي تحصل للإنسان بسبب العلقة اللغويّة ليست نشاطات مادّيّة وعمليّات فسيولوجيّة يؤدّيها الدماغ بل هي اُمور أرقى من ذلك، ومن هنا قال السيّد الشهيد في مقام ردّه لذلك الفهم:
«ليـس الإدراك والفـكر فعـلا فيزيولوجيّاً ينعكس عن منبّه شرطي نظير إفراز اللعاب كما يزعم السلوكيّون، بل نفس إفراز اللعاب هذا يعني شيئاً غيرَ مجرّدِ ردِّ الفعل المنعكس، يعني إدراكاً، وهذا الإدراك هو السبب في إثارة المنبّه الشرطي للاستجابة المنعكسة، فالإدراك هو الحقيقة التي نتبيّنها وراء ردود فعـل المنبّه الشرطي، وليس لوناً من ألوان تلك الردود»[18].
إذن، هذا فرق جوهري بين المبنَيَين لا ينبغي إغفاله عن الحساب.
ومن مجموع ما ذكرناه يظهر بوضوح: أنّ (نظريّة القرن الأكيد) إبداع فريد ينسب بحقّ إلى السيّد الشهيد وإن كان من المحتمل أن تكون كلمات بافلوف سهيمة لحدٍّ ما في إلفات نظر السيّد الشهيد (رحمه الله) إلى ما أبدعه.
ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إنّ أصل (نظريّة القرن الأكيد) ـ كمادّة أوّليّة ـ كانت مطروحة من قبل بافلوف على صعيد علم النفس أو الدراسات الفسيولوجيّة، فإنّه لا يشكّ أحد أنها لم تكن مطروحة على صعيد علم الاُصول بوصفها نظريّة ذات أبعاد وآثار كثيرة في شتّى أبحاث هذا العلم. والسيّد الشهيد هو أوّل من أدخل هذه النظريّة في علم الاُصول وحدّد أبعادها وحدودها وآثارها التي تمتدّ إلى بحث (الدلالة التصوّريّة والتصديقيّة) وبحث (الوضع التعييني والتعيّني) وبحث (المعنى الإسمي والحرفي) وبحث (دلالة هيئات الجمل) إلى غيرها من الأبحاث الاُصوليّة التي لا يعرف بافلوف ولا أتباعه شيئاً منها.. ويكفي هذا لأن يكون مبرّراً كافياً للسيّد الاُستاذ لإعطاء سمة إبداع نظريّة القرن الأكيد في علم الاُصول لاُستاذه الشهيد الصدر (قدس سره).
2ـ السيّد الشهيد الصدر ومسلك حقّ الطاعة :
قال السيّد الاُستاذ إنّ «مسلك حقّ الطاعة أيضاً من إبداعات اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في علم الاُصول حيث أسّس هذا المسلك في قبال مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان»[19].
وقد لاحظ عليه السيّد مطر بقوله: «وكان ينبغي الإشارة إلى أنّ لهذا المسلك جذراً في كلام الشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي كما صرّح بذلك السيّد الشهيد نفسه على ما هو مسجّل في كتاب بحوث في علم الاُصول، نعم قام السيّد الشهيد بتبنّي هذا المسلك وبلورته ».
ونُورد على ملاحظته هذه بأنّ ما ورد في الكتاب المذكور لا يشتمل على التصريح بوجود جذر لهذا المسلك في كلام العلَمَين المذكورَين (رحمهما الله) ـ سواء وجد جذر له في كلامهما حقّاً أو لا ـ وإنّما الموجود هو التصريح بأنه لم يظهر منهما تبنّي قاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث ورد فيه:
«فالشيخ المفيد والطوسي (قدس سرهما) لم يظهر منهما تبنّي هذه القاعدة العقليّة [يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان] بل قد يستشمّ من كلامهما العكس»[20].
ومن الواضح أنّ التعبير بعدم ظهور تبنّي قاعدة قبح العقاب بلا بيان منهما ليس تصريحاً بوجود جذر لمسلك حقّ الطاعة في كلامهما بل هو ظاهر في الشكّ في تبنّي القاعدة المذكورة.
وأمّا قوله: «بل قد يستشمّ من كلامهما العكس» فليس تصريحاً بذلك أيضاً لما فيه من كلمة (قد) المستفاد منها التضعيف وكلمة (الاستشمام) التي يعبّر بها عادةً عن الظهور الخفيّ جدّاً، مع أنّ المقصود من كلمة (العكس) مجمل لا يعلم أنّ المقصود منه تبنّي مسلك حقّ الطاعة أو أمراً آخر بين المسلك والقاعدة.
هذا، ولو لاحظنا منشأ الاستشمام المذكور من مصدره الأوّليّ وهو كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب العدّة لوجدنا ضعف ارتباطه بمسلك حقّ الطاعة. فإنّه قال فيما ينتفع به ولم يحكم العقل بحسنه أو بقبحه:
« واختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على الحظر أو الإباحة أو على الوقف » إلى أن قال: « وذهب كثيرٌ من الناس إلى أنها على الوقف، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحد منهما، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه (رحمه الله) [يعني الشيخ المفيد] وهو الذي يقوى في نفسي»[21].
وبملاحظة أنّ الشيخ (رحمه الله) قد خصّ كلامه هذا بالشبهات التحريميّة الدائرة بين الحظر والإباحة وأورده في فصل تحت عنوان (بيان الأشياء التي يُقال إنّها على الحظر أو الإباحة والفصل بينها وبين غيرها والدليل على الصحيح من ذلك) وهو لا يشمل الشبهات الوجوبيّة. لذلك نرى أنّ كلامه هذا لا يناسب النظر إلى حقّ طاعة اللّه تعالى إذ لا فرق في حقّ طاعته تعالى بين الشبهات التحريميّة والشبهات الوجوبيّة. هذا، وإنّه (رحمه الله) لم يذهب إلى القول بالحظر كي يُدّعى أنه يساوي القول بالإحتياط بمقتضى مسلك حقّ الطاعة بل ذهب إلى الوقف.
نعم قد يسـتفاد من تعليله للقول بالوقف أنه يقصد بالوقف معنى الإمساك عن الفعل من الناحية العمليّة ما لم يظهر الحكم الواقعي بدليل شرعي حيث قال (رحمه الله): «والذي يدلّ على ذلك [أي القول بالوقف] أنه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحاً مثل إقدامه على ما يعلم قبحه، ألا ترى أنّ مَن أقدم على الإخبار بما لا يعلم صحّة مُخبَرِه جرى في القبح مجرى مَن أخبر مع علمه بأنّ مُخبَرَه على خلاف ما أخبر به على حدٍّ واحد، وإذا ثبت ذلك وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعاً ينبغي أن نجوّز كونها قبيحة، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها»[22].
وهذا النصّ وإن كان ظاهراً في أنه يقصد بالوقف الإمساك وعدم الإقدام ما لم يظهر الواقع لكنّه ظاهر في نفس الوقت في عدم إرادة التمسّك بحقّ طاعة اللّه تعالى بل يقصد به التمسّك بما يشبه قاعدة (دفع الضرر المحتمل).
وعليه سيشاركني القارىء القول بأنه لم يَرِد أيّ تصريح من السيّد الشهيد (رحمه الله) بأنّ لمسلك حقّ الطاعة جذراً في كلام العَلَمَين العظيمَين (قدس سرهما)، بل إنّ ارتباط كلامهما بمسلك حقّ الطاعة ضعيف جدّاً.ولو غضضنا النظر عن ذلك نقول:
إنّه بناءً على ما هو التحقيق من أنّ مسلك حقّ الطاعة من المرتكزات العقليّة لا تعدّ الإشارة إليه في بعض الكلمات سهماً في تحقيقه ولا تشكّل جذراً في بلورته ما لم تطرح المسألة على بساط البحث والتحقيق، والحال أنها لم تبحث في فترة ما قبل السيّد الشهيد (رحمه الله) على مستوى البرهنة والتحقيق، وإذا ما وردت الإشارة من البعض إلى المسلك المذكور فإنّه استجابةٌ طبيعيّةٌ لما هو المرتكز في فطرتهم، أمّا بالنسبة له (رحمه الله)فإنّه قال بالمسلك المذكور بعد العصر الثالث من عصور تأريخ علم الاُصول الذي كاد أن يكون القول بالبراءة العقليّة فيه إجماعيّاً إذ اكتسب فيه القول بها صيغة فنّيّة تحت عنوان قاعدة عقليّة سُمّيَت بـ (قبح العقاب بلا بيان) وشكّلت أساساً من الاُسس الرئيسة للتفكير الاُصولي في هذا العصر[23]، وفي هكذا ظرف طرح السيّد الشهيد مسلكه على بساط البحث والتحقيق واستطاع أن يقف بوجه كلّ ما استدلّ به لصالح القاعدة المذكورة ويُثبت عدم صلاحيّته للبرهنة عليها[24] لينتهي إلى تأسيس مسلكه في حقّ الطاعة في مقابل القاعدة المذكورة في ضوء ما حقّقه في بحث حجّيّة القطع من أنّ الحجّيّة تدور مدار مولويّة المولى لا مدار ذات القطع وبما أنّ مولويّته تعالى أوسع دائرة من أيّ مولويّة اُخرى، إذن يترتّب عليها حقّ طاعته تعالى حتّى في المشكوكات والمحتملات من التكاليف ما لم يرِد نصّ منه تعالى بترك التحفّظ.
وقد أدخل (رحمه الله) نتيجة هذا البحث في بعض الأبحاث الاُصوليّة كمبحث (العلم الإجمالي) بما له من فروع وتفاصيل.
وعلى ذلك يكون الفضل كلّه للسيّد الشهيد (قدس سره) سواء في إبداع المسلك المذكور أو في بلورته وإدخاله في أبحاث علم الاُصول، فهو إذن ـ بحقّ ـ المحقّق الأوّل بلا منازع في ذلك كلّه.
هذا، ولو غضضنا النظر عن ذلك واعتبرنا ما ورد في كلمات الشيخ الطوسي (رحمه الله) جذراً لمسلك حقّ الطاعة، فهو بدرجة من الضعف بحيث لا يستساغ معه نفي إبداع المسلك عن السيّد الشهيد (رحمه الله) والقول بأنّ دوره (رحمه الله) كان مقتصراً على القيام بتبنّي هذا المسلك وبلورته فقط.
3ـ تنوين التمكين والتنكير :
صرّح السيّد الاُستاذ في مقدّمته بأنّ المصطلح لدى اُستاذه الشهيد في تنوين التنكير وتنوين التمكين يغاير فيه ما هو المصطلح بهما لدى النحاة، حيث قال:
« تنوين التنكير في مصطلح النحاة عبارة عن التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقاً بين معرفتها ونكرتها ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كصه ومه وإيه، وفي العَلَم المختوم بـ (ويه) بقياس نحو: جاء سيبويهِ وسيبويه آخر. لكنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) قصد بذلك التنوين الذي يلحق الإسم النكرة لإفادة قيد الوحدة مثل: « أكرم فقيراً » أي فقيراً واحداً.
وتنوين التمكين في مصطلح النحاة عبارة عن التنوين اللاحق للإسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله وأنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع الصرف، ويسمّى تنوين الأمكنيّة أيضاً وتنوين الصرف، وذلك كزيد ورجل ورجال. لكن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) قصد بذلك التنوين اللاحق للإسم المتمكّن لا لإفادة قيد الوحدة بل لمجرّد الإعلام ببقائه على التمكين مثل قول القائل: (رجل خير من امرأة) قاصداً بذلك جنس الرجل»[25].
وقد لاحظ السيّد مطر على ذلك بقوله: والواقع أنه ليس للسيد الشهيد اصطلاح خاصّ مقابل النحاة.
ولأجل إثبات ذلك قال في تنوين التمكين:
إنّه تنوين لفظي يُؤتى به للدلالة على كون الإسم معرباً وليس مبنيّاً ولا ممنوعاً من الصرف، ولأجل ذلك فهو لا يفيد شيئاً آخر كقيد الوحدة مثلا.
أمّا تنوين التنكير فقال فيه: إنّه تنوين معنويّ يفيد الكلمة الشيوع وعدم التعيين، ودخوله على الأسماء المذكورة (اسم الفعل والعلم المختوم بويه) ـ فرقاً بين معرفتها ونكرتها ـ يكون من أفراد هذا التنوين وتطبيقاته، ولا يمنع من دخوله على الممنوع من الصرف ـ بشرط أن يقصد واحد غير معيّن منه ـ والإسم المنصرف عَلَماً أو غير عَلَم لنكتة بلاغيّة تقتضي تنكيره.
ثمّ احتمل أن يكون تمثيل السيّد الشهيد (رحمه الله) لتنوين التنكير بكلمة (رجل) و (عالم) وهما من الأسماء المعربة هو الذي أدّى إلى قول السيّد المحقّق: إنّ لاُستاذه الشهيد اصطلاحاً خاصّا هنا.
ولأجل إثبات أنّ تنوين (رجل) يمكن أن يكون للتنكير وللتمكين معاً ذكر عبارات عدد من النُحاة، كالاسترآبادي الذي قال به، وإن ذكر مخالفة ابن الحاجب وابن هشام في ذلك. ثمّ رتّب على عباراتهم قوله: إنّ اصطلاح النُحاة على أنّ تنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء للدلالة على الشيوع وإرادة فرد غير معيّن… فلا مخالفة في الاصطلاح.
أقول: إنّ مجرّد اشتراك السيّد الشهيد (رحمه الله) مع النُحاة في أنّ دور تنوين التنكير دور معنويّ ودور تنوين التمكين دور لفظي لا يبرّر إثبات إتّحاده معهم في المعنى المصطلح بهذَين التنوينَين، فإنّه لو كان مصطلح تنوين التنكير المعنويّ مختصّاً في نظر النحاة بالأسماء المبنيّة، أو بها وبغيرها ممّا نقله السيّد مطر عن بعض النحاة مع فرض أنّ السيّد الشهيد (رحمه الله) لا يرى ذلك الاختصاص، فإنّ ذلك يشكّل فارقاً بين الاصطلاحَين.. كما أنه لو كان مصطلح تنوين التمكين اللفظي مختصّاً في نظر السيّد الشهيد (رحمه الله) بما لم يقصد به قيد الوحدة مع فرض أنّ النحاة لا يَرَون اختصاصه بذلك، فإنّ ذلك كاف للفرق كذلك.
ولهذا لا بدّ من مراجعة القيود التي قد تشكّل موادّ افتراق بين الاصطلاحَين، وعندها نجد السيّد الملاحظ قد بذل جهداً في نقله لكلمات بعض النُحاة لإثبات أنّ تنوين التنكير في مصطلح النُحاة غير مقيّد بالأسماء المبنيّة بل يدخل على الممنوع من الصرف والإسم المنصرف عَلَماً أو غير عَلَم بالشرط الذي ذكره لكلّ منهما ظنّاً منه أنّ هذا سيجعله مطابقاً لما هو المصطلح منه لدى السيّد الشهيد (رحمه الله) رغم اعترافه بمخالفة بعض النحاة لذلك كابن الحاجب وابن هشام اللذين صرّحا بأنّ تنوين (رجل) ليس من تنوين التنكير، في حين غفل فيه عن أنه حتّى على فرض التسليم بصدق تنوين التنكير على مثل تنوين (رجل) في مصطلح النحاة، فهذا لا يعني تطابق مصطلحهم هذا مع مصطلح السيّد الشهيد (رحمه الله)، ذلك لأنّ دعوى صدق تنوين التنكير على مثل تنوين (رجل): تارةً يكون مع التسليم بصدق تنوين التمكين عليه أيضاً ـكما هو المنقول عن بعض ـ، واُخرى يكون مع إنكار صدق تنوين التمكين عليه.
أمّا على الأوّل، فستكون النسبة بين التنوينين نسبة العموم والخصوص من وجه، وكفى به فرقاً بينه وبين مصطلح السيّد الشهيد (رحمه الله)، لأنّ النسبة بينهما على مصطلحهِ هي نسبة التباين الكلّيّ حيث يعبّر (رحمه الله) بتنوين التنكير عن كلّ تنوين قصد به قيد الوحدة، وبتنوين التمكين عن كلّ تنوين لم يقصد به قيد الوحدة بل إنّما يؤتى به لإشباع حاجة الكلمة المعربة المتمكّنة من الصرف من حيث عدم إمكان خلوّها من التنوين أو اللام أو الإضافة ـ كما هو مصرّح به في كلمات السيّد الشهيد (رحمه الله) ـ، والنسبة بين ما قُصد به قيد الوحدة وما لم يقصد به ذلك نسبة التباين الكلّي وليس العموم من وجه، ومقتضى التباين الكلّي عدم إمكان اجتماع التنوينين الذي ذهب إليه ذلك البعض من النُحاة كما هو واضح.
وأمّا على الثاني فلا يتطابق المصطلحان أيضاً، لأنّ السيّد الشهيد (رحمه الله) يشترط في صدق تنوين التنكير أن يقصد به قيد الوحدة، وفي تنوين التمكين أن لا يقصد به ذلك، فهو يفصّل بين تنوين (رجل) في مثل: (جئني برجل) أو (أكرم رجلا) وبين تنوينه في مثل: (رجلٌ خير من امرأة)، فالأوّل يعبّر عنه بتنوين التنكير والثاني يعبّر عنه بتنوين التمكين. في حين أنّ النحاة ـ على الفرض المذكور ـ يعبّرون عن تنوين (رجل) في كلتا الحالتَين بتنوين التنكير. بل على فرض تسميته بالتنكير والتمكين معاً لا يفرّقون أيضاً بين الحالتَين المذكورتَين، لأنّ كلمة (رجل) في كلتيهما نكرة ومتمكّنة من الصرف أيضاً.
إذن الفرق الجوهري بين المصطلحَين هو أنّ هناك ضابطاً في اصطلاح السيّد الشهيد (رحمه الله) والذي على أساس منه يفرّق بين التنوينين في مثل كلمة (رجل) وهو ما قصد به قيد الوحدة وما لم يقصد به ذلك، فيصطلح على الأوّل بتنوين التنكير، وعلى الثاني بتنوين التمكين، في حين أنه لا أثر لهكذا ضابط موضوعي في كلمات النُحاة لتحصيل هكذا تفصيل في مثل تنوين (رجل) في المثالَين السابقَين سواء على رأي مَن يراه من تنوين التمكين فقط كابن الحاجب وابن هشام، أو على رأي من يرى إمكان كونه من التمكين والتنكير معاً كالاسترآبادي وغيره، بل حتّى على فرض كونه من التنكير فقط.
بل إنّ بعض كلمات النُحاة التي استشهد بها الملاحِظ كاد أن يكون صريحاً في عدم الفرق عندهم بين الحالتَين، حيث إنّها تصرّح بأنّ تنوين التنكير هو ما «يكون وجوده دليلا على أنها نكرة، وحذفه دليلا على أنها معرفة» أو «أنه الفارق بين النكرة وغيرها»، فهي واضحة الدلالة على عدم الفرق عندهم بين تنوين (رجل) في مثل: (جئني برجل) وفي مثل: (رجلٌ خير من امرأة) فإنّها في كلا المثالَين نكرة وليست معرفة بحسب مصطلح النُحاة.
هذا على فرض شمول عبارة النُحاة تلك لمثل تنوين (رجل).
أمّا على فرض كون المقصود به مثل التنوين الذي يدخل على ما هو معرفة بطبعه الأوّلي إعلاماً بأنه قصد به معنى النكرة كـقولك: (هـذا أحمدُ، وهـذا أحمدٌ آخر)، فسيكون التنوين أجنبيّاً عن مثل تنوين (رجل)، ويكون تمكيناً في كلتا الحالتَين، خلافاً لتفصيل السيّد الشهيد(رحمه الله).إذن على كلّ التقادير والفروض وعلى جميع الأقوال والمذاهب المنقولة عن النُحاة فيما نحن فيه لا يتطابق ما هو المصطلح بالتنوينين لدى السيّد الشهيد (رحمه الله) مع ما هو المصطلح بهما لدى النُحاة.
هذا، ولو سلّمنا بما أراد إثباته السيّد مطر ـ وهو عمدة ما أراد أن يسجّله في ملاحظته ـ من أنّ تنوين التنكير غير مختصّ باسم الفعل والعَلَم المختوم بـ (ويه)، بل يدخل على الممنوع من الصرف والإسم المنصرف عَلَماً أو غيره بالشرط الذي ذكر لكلٍّ منهما، وانتهينا إلى أنّ التنوين في مثل كلمة (رجل) و (عالم) قد يكون للتمكين والتنكير معاً، فإنّه لا يؤدّي إلى القول بتطابق اصطلاح السيّد الشهيد (رحمه الله) مع اصطلاح النُحاة في التنوينين، بل إنّ ذلك ـ على القول به ـ سيؤدّي إلى بروز مشكلة التعارض بين إفادة الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي معاً، وهو ممتنع.
توضيحه: إنّ من حالات اسم الجنس أن يكون منوّناً بتنوين التنكير، كما أنّ من حالاته أن يكون خالياً من التعريف والتنكير، كما لو كان منوّناً بتنوين التمكين. فيكون في الحالة الثانية صالحاً للتطبيق على تمام أفراده بنحو الشمول ببركة إجراء مقدّمات الحكمة، وبهذا يكون قد أفاد معنى الإطلاق الشمولي.. وفي الحالة الاُولى ينسلخ اسم الجنس عن الصلاحيّة للتطبيق الشمولي؛ لأنّ التنوين يدلّ على قيد الوحدة فيتعذّر الإطلاق الشمولي فيتعيّن أن يكون المقصود هو الإطلاق البدلي[26]. فلو قيل بإمكان أن يكون التنوين للتنكير والتمكين معاً، فكيف يعقل إفادة البدليّة والشموليّة معاً؟! في حين أنهما معنيان متنافران كما هو واضح.
وبهذا ننتهي عمّا أراد تسجيله على السيّد المحقّق من ملاحظات وقد ظهر الحال فيها جميعاً.
أمّا ما ادّعاه السيّد مطر من بقاء ما يزيد على ثلاثين خطأً لغويّاً في متن الكتاب بعد تحقيقه، فإنّ التفسير المعقول لهذه الدعوى ـ في أكبر الظنّ ـ أنّ أكثرها إمّا هو محلّ خلاف بين اللغويّين فأخذ السيّد الشهيد (رحمه الله) برأي ويرى الملاحِظ خطأه، كالكلمات التي وقع الخلاف في إعرابها وبنائها، أو في تعريفها وتنكيرها أو ما شاكل ذلك.. وإمّا هو من الخطأ المشهور الذي لا ينبغي للمحقّق تغييره إذا استخدمه المؤلّف إلاّ بإذن خاصّ، مثل دخول الألف واللام على حرف (لا)[27] فضلا عن دخولها على حرف (غير)، ومثل استخدام حرف (أو) بعد همزة التسوية بدلا عن حرف (أم).
نعم، وقع في الكتاب بعض الأخطاء المطبعيّة في مواطن كثيرة وهي بسبب عدم مراعاة الدقّة في الطبع ممّا تتحمّله المؤسّسة التي تبنّت طبعه، ولا يعدّ نقصاً في التحقيق يعاب عليه المحقّق.
وأخيراً بودّي أن اُسجّل اقتراحاً متواضعاً لمسؤولي مجلّة الفكر الإسلامي المحترمين وهو المطالعة المتأنّية من قبل المتخصّص لأيّ موضوع يسجّل النقد فيه للإنتاجات الفكريّة لأكابر فقهائنا ومفكّرينا، كحلقات الاُصول التي تعدّ من العطاءات العلميّة الضخمة للسيّد الشهيد الصدر (قدس سره) وذلك قبل نشره كي يتوقّى الوقوع فيما لا يناسب مجلّتهم الموقّرة، وعبارة: «الآراء الواردة لا تعبّر عن رأي المجلّة» لا تكفي لدفع الإشكال.
وله تعالى الحمد أوّلا وآخراً.
الشيخ حامد الظاهري
[1] إستناداً إلى أنّ الطبعة الاُولى ـ وهي طبعة دار الكتاب اللبناني ـ كانت عام 1978 م
[2] راجع ما كتبه السيّد الاُستاذ في مقدّمته للحلقات، الصفحات 95ـ103 (طبعة مجمع الفكر الإسلامي) للمزيد من الإطّلاع
[3] دروس في علم الاُصول، الحلقة الثانية: 360، طبعة مجمع الفكر الإسلامي. والحلقة الثالثة 2: 325، طبعة دار الكتاب
[4] الحلقة الثانية: 127، طبعة مجمع الفكر الإسلامي
[5] الحلقة الثالثة 1: 270، طبعة دار الكتاب اللبناني
[6] الحلقة الثالثة 2: 335، طبعة دار الكتاب اللبناني
[7] الحلقة الثانية: 365، طبعة مجمع الفكر الإسلامي
[8] وسائل الشيعة 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1
[9] الصفحة: 278ـ279، طبعة مجمع الفكر الإسلامي
[10] الصفحة: 375ـ376، طبعة مجمع الفكر الإسلامي
[11] راجع الحلقة الثانية: 358ـ359، طبعة مجمع الفكر الإسلامي، والحلقة الثالثة 2: 329، طبعة دار الكتاب اللبناني
[12] راجع: الحلقة الثانية: 376، طبعة مجمع الفكر الإسلامي.
[13] دروس في علم الاصول ح 1 : 92.
[14] راجع «إقتصادنا»: 79، طبعة دار التعارف، الطبعة الحادية عشرة
[15] المصدر السابق: 81.
[16] فلسفتنا: 393ـ394، طبعة دار الكتاب الإسلامي، قم
[17] كتاب إقتصادنا: 81.
[18] فلسفـتنا : 165، طبعـة دار الكتـاب الإسلامي، قم.
[19] مقدّمـة الحـلقة الاُولـى : 92، طبعـة مجمـع الفكر الإسلامي، وكذا الصفحة 62 من المصدر نفسـه.
[20] بحوث في علم الاُصول 5 : 25.
[21] عدّة الاُصول 2 : 295 ـ 296، الطبعة الحجريّة
[22] المصدر السابق
[23] راجع : بحوث في علم الاُصول 5 : 24 ـ 29.
[24] المصدر السابق
[25] مقدّمة الحلقة الاُولى : 93 ـ 94، طبعة مجمع الفكر الإسلامي
[26] لأجل المزيد من التوضيح راجع : بحوث في علم الاُصول 3 : 433، ودروس في علم الاُصول، الحلقة الثانية : 105 ـ 106، طبعة مجمع الفكر الإسلامي.
[27] كما صنعه السيّد الشهيد (رحمه الله) في تسمية كتابه بـ (البنك اللاربوي في الإسلام).