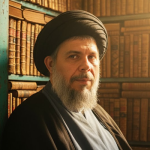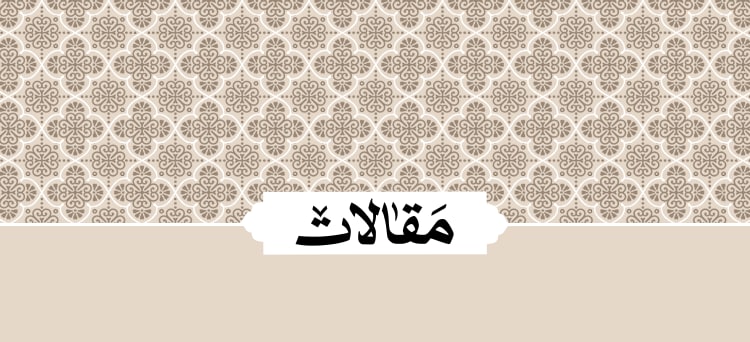تمهيد:
أولاً: تطبيقات النظرية الصدرية على المشروع الإحيائي لكتاب “أفكار هادفة”.
دعيت لكتابة قراءة نقدية تحليلية أو قل نقداً موضوعياً لموضوعات ومقالات كتاب “أفكار هادفة” الذي واكبت العديد من موضوعاته وهي بذور صغيرة ما لبثت أن تحولّت إلى زرع «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ»[1] والعاملين في حقل الرسالة.. ليغيظ به الكفّار، والحساد والمثبطين الذين لا يملكون ثقة بأنفسهم ممّن لم يعرفوا حقيقة أهداف دعوة الأنبياء والأولياء في الأرض..
وقد تبادر إلى ذهني أن أزن الكتاب في التطبيق والنقد الموضوعي الذي هو “ما يقال – عادة – من أنّ هذا البحث موضوعي في مقابل أن يكون بحثاً متحيزاً أو منحازاً.. نقصد “بالموضوعية” هنا: الموضوعية في مقابل التحيز.. الموضوعية التي هي عبارة عن الأمانة في البحث عبارة عن الاستقامة على جادة البحث”[2].
من خلال الأفكار التي قدمها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر – رضوان الله تعالى عليه – في كتابه “المدرسة القرآنية”[3] والتي تمثل نظرية قرآنية وفق منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم[4].. وهذه النظرية قد تناولت بحث مفهوم: (العمل الهادف، ودوره في صناعة التاريخ وحركة المجتمع) وعلى ضوء هذا المفهوم يبني الشهيد الصدر بعض أبحاث وأفكار محاضراته حين عرض الفكرة والقصة والمثال وتناول الآية القرآنية موضوع البحث..
أسئلة موجهة نحو (الكتاب):
إنّ السؤال الذي يطرح نفسه – في المقام – هو ما يلي: هل يمثل كتاب “أفكار هادفة”[5] عملاً هادفاً؟! وتتفرع أسئلة عديدة من هذا السؤال كالآتي:
1– ما هو الفكر؟
2– ما هو دور الفكر في حركة المجتمع والتاريخ؟
3– ما هو الأساس لحركة المجتمع؟
4– هل تعبّر الفكرة عن عمل؟
5– هل يعبر الفكر عن عمل؟
6– هل نعتبر الهدفية في كل عمل؟
سؤال آخر: هل نعتبر الصلاح والخير “يدعون إلى الخير”[6] في كل عمل هادف أم أنّ الأعمال الهادفة قد لا تدعو إلى الخير ولا تحمل الصّلاح؟!
وبعبارة أخرى: يقال عندئذ: ليس بالضرورة أن يكون كل عمل هادف عملاً صالحاً بل من الممكن أن يكون العمل الهادف غير صالح ولا يدعو إلى الخير بحسب دعوة القرآن إلى الخير..[7]
وللإجابة على هذه التساؤلات وإثبات أن النتاج الذي مثله الكتاب والمشرع الفكري “أفكار هادفة” يمثل عملاً هادفاً.. نحتاج أن نعرض “النظرية الصدرية” لمفهوم العمل الهادف ودوره في صناعة التاريخ وحركة المجتمع..
يقول الشهيد الصدر:
ليس كل عمل له غاية فهو عمل تاريخي ، هو عمل تجري عليه سنن التاريخ بل يوجد بعد ثالث لابد أن يتوفر لهذا العمل لكي يكون عملاً تاريخياً أي عملاً تحكمه سنن التاريخ.
البعد الأول كان هو “السبب” والبعد الثاني كان هو الغاية “الهدف” لابد من بعد ثالث لكي يكون هذا العمل داخلاً في نطاق سنن التاريخ، هذا البعد هو “أن يكون لهذا العمل أرضية تتجاوز ذات العامل، أن تكون أرضية العمل عبارة عن المجتمع”[8] وزيادة في التوضيح – العمل الهادف – هو العمل الذي يخلق موجاً، هذا الموج يتعدى الفاعل نفسه، ويكون أرضيته الجماعة التي يكون هذا الفرد جزءاً منها..
اختلاف أمواج العمل:
طبعاً الأمواج على اختلاف درجاتها هناك موج محدود – كما ستأتي الأمثلة – هناك موج كبير.. لكنّ العمل لا يكون عملاً تاريخياً، عملاً هادفاً إلاّ إذا كان الموج يتعدى حدود العامل الفردي.
الفرق بين العمل الشخصي “غير التاريخي” والعمل الهادف التاريخي:
(أ) أمثلة للعمل الشخصي:
قد يأكل الفرد إذا جاع ، قد يشرب إذا عطش، قد ينام إذا أحسّ بحاجته إلى النوم. لكن هذه الأعمال – على الرغم من أنها أعمال هادفة أيضاً – تريد أن تحقق غايات ولكنها أعمال لا يمتدّ موجها أكثر من العامل الفردي..
(ب) أمثلة للعمل الهادف التاريخي:
خلافاً لعمل يقوم به الإنسان من خلال نشاط اجتماعي، وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته، وهذه تمثل خصائص مميزة للعمل الهادف أو قل للعمل الاجتماعي الهادف. وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
أولاً: التاجر حينما يعمل عملاً تجارياً.
ثانياً: القائد حينما يعمل عملاً حربياً.
ثالثاً: السياسي حينما يمارس عملاً سياسياً.
رابعاً: المفكر حينما يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة. (كتاب “فلسفتنا” للشهيد الصدر مثال على ذلك…)
وغيرها من الأمثلة.
هذه الأعمال لها موج يتعدى شخص العامل، هذا الموج يتخذ من المجتمع أرضية له.. في حالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل عملاً تاريخياً عملاً للأمة وللمجتمع وإن كان الفاعل المباشر في جملة من الأحيان لا يكون إلاّ فرداً واحداً أو عدداً من الأفراد – وهذه ملاحظة وخاصية مهمة في العمل الهادف – ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع.. إذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الهادف الذي يكون حاملاً لعلاقة مع هدف وغاية ويكون في الوقت نفسه ذا أرضية أوسع من حدود الفرد وذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية له. وبهذا يكون عمل المجتمع..
وظيفة العمل الهادف:
“ليس كل عمل هادف يكون صالحاً”.
ينبغي معرفة أن العلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو أنه عمل هادف، عمل يرتبط بعلة غائية سواء كانت هذه الغاية صالحة أو طالحة ، نظيفة أو غير نظيفة – وهذه خاصية أخرى للعمل الهادف – على أي حال نعتبر هذا “عملاً هادفاً” نشاطاً تاريخياً هذا الأساس وهذه الغايات يرتبط بها العمل الهادف المسؤول.. هذه الغايات حيث أنها مستقبلية بالنسبة للعمل هي تؤثر من خلال “وجودها الذهني” في العامل لا محالة. لأنها بوجودها الخارجي، وجودها الواقعي طموح وتطلّع إلى المستقبل، ليست موجودة وجوداً حقيقياً وإنما من خلال وجودها الذهني في الفاعل وتكون عاملاً في تحريك هذا النشاط وفي بلورة هذا النشاط من خلال الوجود الذهني أي من خلال “الفكر” الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات حينئذ يؤثر في إيجاد هذا النشاط.. وذلك على أساس أنّ “الفكر في المفهوم الحضاري هو المعلومات والشرائع والمناهج والقيم التي تمثل وتقّوم شخصية الأمة الثقافية والحضارية، وتعطيها سمتها المميّزة لها عن الأمم الأخرى ، ويرسم لها دورها في (حركة التاريخ)”[9].
إن هذه المعلومات والشرائع والمناهج والقيم تشكل عقل الأمة وروحها وضميرها. وهي تنظر إلى الكون والحياة والإنسان والأمم الأخرى من خلال هذه المعلومات والشرائع والمناهج والقيم ، وتواجه مشاكلها ومسائل حياتها على ضوء الحلول والمواقف التي يحميها هذا “الفكر”. وإنتاجها العقلي النظري كله يكون مطبوعاً بطابع هذا الفكر، ومحتوياً روحه، ومستهدياً بالنور الذي يشعه..
مثلاً: الماركسية هي “فكر” العالم الشيوعي فهي تشكل عقل شعوبه وروحها وضميرها، وهي تميّز هذه الشعوب عن العالم الرأسمالي بالسمّات التي تطبع بها طريقة الحياة لدى هذه الشعوب. كما أنّ النتاج الثقافي النظري لهذه الشعوب مرسوم بالطابع الخاص للماركسية، بل لقد طمح المنظرون السوفيات إلى طبع النظريات العلمية التي تفسّر بها المادة بالطابع الخاص للماركسية..”[10].
” إذن الشيء الذي نستخلصه – ممّا تقدم – أن موضوع السنن التاريخية هو “العمل الهادف” الذي يشكل أرضية ويتخذ من المجتمع أو الأمة أرضية له على اختلاف سعة الموجة وضيق الموجة…”
الإجابة على الأسئلة المطروحة:
الآن نأتي للإجابة على الأسئلة المطروحة..
- ما هو الفكر؟
الفِكر – بالكسر – اسم من التفكر، الذي هو التأمل – والفكر يستعمل حسب ما ذكره علماء اللغة[11] – للدلالة على معنيين:
أحدهما: القوة المودعة في الدماغ ، الذي هو مركز التفكير، وإن كان علينا أن نعترف بأن لوضعية أعضاء أخرى في الجسم من حيث الصحة والمرض دخلاً في عملية التفكير. والفِكر – بهذا المعنى – اسم لآلة التفكير.
ثانيهما: أثر التفكير، وهو ترتيب أمور في الذهن منها (تتولد) معرفة جديدة ، أو تؤدي إلى تعميق وتوسيع معرفة قديمة. والفِكر بهذا المعنى – اسم لفعل التفكير أو لعملية التفكير.
هذا هو المعنى اللغوي لكلمة تفكر وفكر مع شرح وتوضيح. وثمة معنى ثالث لهذه الكلمة غلب استعمال اللفظ فيه في العصور الأخيرة، ولعلّه دخل العربية من الاستعمالات الأوربية، وهو نفس الأفكار والمعلومات التي يجعلها الفِكر – بالمعنى الأول – موضوعاً لعلمه، الفكر بالمعنى اللغوي الثاني، فيقال، مثلاً: الفكر الإسلامي، والفكر المسيحي، والفكر الماركسي، والفكر الديني، فالفكر المادي… يراد من ذلك “الأفكار والمناهج والمعلومات التي يتشكل منها ويقوم بها مذهب أو فلسفة أو دين. والمقصود ببحثنا هنا هو هذا المعنى لكلمة “فِكر”، كما أن الفِكر في الثقافة التي تقوّم شخصية كل أمة على قسمين: فِكر حي، وفِكر ميّت. والأول هو ما يطلق عليه لفظ “فِكر” في عصرنا الحاضر والثاني هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر مصطلح “تراث”[12].
- ما هو دور الفكر في حركة المجتمع والتاريخ ؟ ما هو الأساس لحركة التاريخ؟
للإجابة على هذا السؤال – ومن خلال ما تقدم بيانه – نقول: إنّ المحتوى الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في ركنين أساسين وهما “الفِكر” و”الإرادة” فالوجود الذهني الذي يجسد جانباً فكرياً يضم تصورات الهدف وجانباً يمثل الإرادة التي تحفّز الإنسان نحو الهدف هو المحرك لحركة التاريخ.. ولكنّ المستقبل معدوم فعلاً وإنّما يحّرك من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه المستقبل. وأن الأساس لبناء المحتوى الداخلي للإنسان هو المثل الأعلى (الله جل جلاله) الذي يحقق للإنسان المؤمن به غاياته التفصيلية بمقدار قوة ارتباطه به ومعرفته وحبّه.. “[13].
ومن هذا المنطلق نعلم أنّ “لكل فِكر بؤرة يرتّد إليها كل شيء باعتبارها مقياساً للصدق والأصالة والاستقامة، وينطلق منها كل شيء باعتبارها الذخر الأكبر للأصول الأساس في التكوين الثقافي للأمة”، مثلاً: كتاب (رأس المال) للماركسية والشيوعية، والإنجيل والتوراة، للمسيحية. والبهاجا فاد – جيتا، للهندوسية، والقرآن الكريم للإسلام. والآوستا للزردشتية.. وهكذا يكون لكل فِكر مركز أساس يتضمن الخطوط الكبرى والمبادئ المركزية لذلك الفِكـر”[14].
- هل تعبّر الفِكرة عن عمل؟ هل يعبر الفِكر عن عمل؟
نحن نعتقد – في مفاهيمنا الإسلامية – أن “نية المرء خير من عمله”[15] وذلك أنّ النية عبارة عن “الإرادة” الباعثة نحو العمل، وهي تتبع الغايات الأخيرة الواقعة نحو العمل، كما أن هذه الغايات تتبع الملكات النفسانية التي تشكل باطن ذات الإنسان وشاكلته.
فمن له حب الجاه والرياسة، وغدا هذا الحب ملكة نفسانية وشاكلة روحه، كان منتهى أمله البلوغ إلى سدّة الزعامة، وكانت أفعاله الصادرة منه تابعة لتلك الغاية، وكان دافعه ومحركه هو مبتغاه النفسي المذكور، وصدرت عنه أعماله للوصول إلى ذلك المطلوب…
وفي الحديث الشريف تلميح إلى هذا الموضوع، عندما يقول: “والنية أفضل من العمل ألا وإنّ النية هي العمل” واحتمل بعض أن هذا مبالغة، ولكنه ليس بشيء من المبالغة، بل مبني على الحقيقة، لأن النية هي الصورة الكاملة للعمل، والفصل المحصّل له، وصّحة العمل وفساده وكماله ونقصه، مرتبطة بالنية..”[16].
وقد اتضحت الإجابة على الأسئلة الباقية من خلال عرض النظرية الصدرية حول “مفهوم العمل الهادف.. “الذي نلخص خصائصه في النقاط التالية:
1- نشاط اجتماعي زائداً علاقات متبادلة، يقوم بها الفرد مع أفراد جماعته.
2- هو العمل الذي يخلق (يحدث) موجاً يتعدى الفرد (الفاعل) نفسه.
3- العمل الهادف، أرضيته الجماعة (المجتمع) الذي يكون الفرد واحداً منه.
4- العمل الهادف يساوي العمل الاجتماعي الهادف.
5- العمل الهادف عمل تاريخي، عمل يُقدّم للأمة (للمجتمع).
6- الفاعل المباشر في العمل الهادف قد يكون فرداً أو جماعة من الأفراد.
7- العمل الهادف عمل يحمل علاقة مع هدف وغاية ويكون موجه وأرضيته المجتمع لا حدود الفرد ذاته.
8- العمل الهادف قد يكون صالحاً وقد يكون طالحاً.
9– نتيجة: موضوع “سنن التاريخ” وحركته هو العمل الهادف الذي يتخذ من المجتمع أرضية له على اختلاف الموجة سعةً وضيقاً.
نتيجة عرض النظرية والتطبيق:
بعد هذا العرض المتقدم يتضح لنا كيف أنّ كتاب “أفكار هادفة” يمثل عملاً هادفاً بلحاظ:
- التعريف للعمل الهادف وخصائصه.. وكذلك – كما أثبتنا – كون الفكرة تمثلا عملاً وإن كانت فكرة في الذهن تنتظر المستقبل لتصنع نفسها بل ثبت أن الفكرة “النية” هي العمل..
- وبلحاظ دور العمل الهادف “أفكار هادفة” واتخاذه المجتمع أرضية له..
- وبلحاظ تحقيقه – كتاب “أفكار هادفة” – لأهدافه..
ومما يدل على أخذ التعريف بعين الاعتبار في المشروع الإحيائي نفسه من حيث الإعداد والمشاركة المتعددة فيه.. فمن حيث التعريف والتركيز على عنصر المجتمع وكونه يمثل أرضية العمل الهادف – كما يرى الشهيد الصدر – نجد قول المعدين للكتاب بما يلي نصه: “كثيرة هي المشاريع “الاجتماعية” التي بدأت كبيرة ثم انتهت وولت من دون رجعة، وعديدة تلك التي ولدت صغيرة ثم ما لبثت أن كبرت وترعرعت بإذن ربنا، وأصبح في كل سنبلة منها مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء.. وقد انبثقت فكرة هذا “المشروع” عندما كتب مقال (القرار الخطير) ومن ثم مقال (العادة عدو متملك)[17] ولقيا إقبالاً عند أبناء “المجتمع” وخصوصاً الطبقة النسائية منهم.
ومن حيث أخذ تضافر وتعاضد الأفراد في المشاركة في تحقيق العمل الهادف وأخذ التضافر والتعاضد والأفراد خاصية مهمة في العمل الهادف، نجد قول المعدين بما يلي نصه: “وبعد ذلك “فكّرنا “بدعوة كل من يجد لديه القدرة على الكتابة لكتابة مقالات متفرقة تعالج قضايا دينية واجتماعية وثقافية، تصدر كل أسبوعين تحت عنوان “سلسلة مقالات إسلامية هادفة” وبالفعل استطعنا حصد مجموعة من المقالات، متنوعة المواضيع والأفكار”، ص 10.
ومن حيث هل حقق العمل الهادف – كتاب “أفكار هادفة” – أهدافه التي تلخصت في:
1- تقويم المجتمع. 2 – ونشر عادة القراءة. 3 – وتشجيع الطاقات ص 9.
نجد قول المعدين بما يلي نصه: “وحمداً لله أنّنا تمكنا أن نغرس في نفوس الكثيرين “فكرة” إمكانية النشر والمساهمة في صناعة الكلمة الهادفة، ونجحنا في دفع البعض للكتابة لأول مّرة، كما وفقّنا لدعم ثلة من الأقلام النسائية. ومرت الأيام على انطلاقة “المشروع” وفوجئنا برأي القّراء الذين ألحوا علينا بضرورة جمع هذه المقالات ونشرها ضمن دفتي كتاب واحد، فما كان منّا إلاّ الاستجابة لهذا الطلب الكريم”[18].
والخلاصة:
إنّ الكتاب يمثل عملاً هادفاً من حيث كونه فكرة في الذهن ما لبثت أن تحولت إلى عمل اتخّذ من المجتمع أرضية له فكان له موجه الذي يصاحب كل عمل هادف سواء كان هذا العمل صالحاً أم غير صالح. الأمر الذي يجعل لهذا العمل دوره التغييري والحركي في صنع التاريخ وحركة المجتمع..
ثانيا: كتاب “أفكار هادفة” وعملية الإحياء للجدب الثقافي:
ممّا لا شك فيه إنّ كل عملية إحياء للجدب الثقافي لأفراد المجتمع.. حين يمثلها العمل الإحيائي، تحتاج إلى مقومات لسقي تلك الأرض والتربة الجدبة والقيام بعملية الإحياء.. فكما أن الأرض والتربة الجدبة تحتاج إلى الماء لتتم عملية الإحياء.. كذلك هو الحال بالنسبة إلى الجدب الثقافي الذي يعيشه أفراد المجتمع لابد له من الماء المناسب والمقومات المناسبة الأساسية التي تساعد وتكمل عملية الإحياء.
وقد تبدو عملية الإحياء صعبة وواسعة ولكن على المصلح للأرض والمحيي أن يصلح المواقع التي يكون قادراً على إصلاحها.. وبذلك يكون موج عمله يتسع بحسب قدره وقوته.. وهذا خير من أن يترك الإنسان دوره في عملية الإحياء والإصلاح للأرض الجدبة التي يمتلك هو مقومات إحيائها وإصلاحها وإن كان حسب قدرته وقوته ولحافــه[19].
انطلاقاً من قول الإمام علي – عليه السلام – فيما يروى عنه: “لا تستحِ من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه”، وانطلاقاً من أن كل عمل له دوره في الحياة والوجود والتاريخ مهما كان صغر هذا العمل وفاعليته.
إنّ المفاهيم الإسلامية ناطقة بصدق الوعد في الفلاح والنجاح والنصر والتسديد والتوفيق.. للعاملين في سبيل الله وطريق جهاده.. فالقاعدة الأساسية: في المفاهيم الإسلامية هي أن تعمل – مهما صغر العمل أو كبر – وتدعو إلى الخير في كل المواقع التي تستطيع أن تدعو فيها إلى الخير وأن الفلاح مضمون لك ولكل العاملين في سبيل الله – جل جلاله – ولكن وقت النصر قد تجهله..
قال تعالى:«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ»[آل عمران: 104].
«إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ» [آل عمران: 160].
«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ..» [النور: 55].
«وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»[العصر: 1- 3].
وغير ذلك من مفاهيم الإسلام العظيمة..
مقومات المشروع الإحيائي للجدب الثقافي في الأمة[20]:
فما هي أساسيات مقومات إحياء الجدب الثقافي لأفراد المجتمع؟
إنّ المقومات الأساسية للمشروع الإحيائي للجدب الثقافي في الأمة تتلخص فيما يلي:
- أن تكون الأمة قارئة ومنفتحة على إسلامها.. وبعبارة الشهيد الصدر – رضوان الله تعالى عليه – “إنّ الشرط الأساسي لنهضة الأمة – أي أمة كانت – أن يتوفر لديها المبدأ الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها ويضع لها مثلها العلياء ويرسم اتجاهها في الحياة فتسير في ضوئه واثقة من رسالتها مطمئنة إلى طريقها متطلعة إلى ما تستهدفه من مثل، وغايات مستوحية من المبدأ وجودها “الفكري” وكيانها الروحي.
ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود المبدأ الصحيح أولاً وفهم الأمة له ثانياً، وإيمانها به ثالثاً[21]، فلا بد أن نقف عند “المبدأ الإسلامي” في فلسفته عن الحياة والكون وفي فلسفته عن الاجتماع والاقتصاد وفي تشريعاته ومناهجه لنحصل على المفاهيم الكاملة للوعي الإسلامي والفكر الإسلامي الشامل”[22].
- أن تكون الأمة مثقفة بمنهج العلم والعمل المطلوب الذي يمثله القرآن الكريم وفكر أهل البيت (عليهم السلام ).
- أن يتحرك أفرادها كل بحسب قوته وقدرته وطاقته للقيام بعملية الإحياء والعمل الهادف كل من الموقع الذي يقدر عليه.
- أن يتعرّف أفراد المجتمع على أوضاع العصر وإمكانياته وقدراته واختراعاته الحديثة خصوصاً في المجال المعرفي ومصادر المعلومات والاتصال ونقل الأفكار وتبادلها، ويأخذ ذلك طريقه في التطبيق والاستفادة..
- أن يقدّم أفراد الأمة – كل من موقعه واختصاصه – الدراسات والبحوث المعاصرة حول الإسلام وأساليب المواجهة مع الفكر الآخر والحضارة الغربية وما تطرحه من موضوعات وإشكالات.
- أن يتمكن أفرادها من الدخول في عملية الحوار الحضاري والتبادل الثقافي وفق الأسس العلمية والموضوعية، ومناهج البحث والدراسة الأكاديمية وما تلتزم به من الأمانة العلمية وغير ذلك، لصناعة البحث القائم على الأدلة الواقعية والموضوعية..
ومن مجموع ما تقدم تتلخص المقومات الأساسية لمعالجة الجدب الثقافي في الأمة في العناوين التالية:
1- الأمة القارئة.
2- التثقيف بمنهج العلم والعمل المطلوب.
3- التحرك بحسب القدرة والطاقة.
4- التعرف على أوضاع العصر وقدراته.
5- تقديم الدراسات والبحوث المعاصرة حول الإسلام.
6- الدخول في عملية الحوار الحضاري.
مناقشة مجملة للعناوين السابقة:
فيما يلي عرض ومناقشة للعناوين السابقة من خلال التطبيق على كتاب “أفكار هادفة” كما يلي:
- أمة قارئة:
أمة قارئة يساوي أمة واعية ، فالقراءة هي التي تصنع الوعي لأفراد الأمة.. فممّا لا شك فيه – بحكم العقل قبل النقل، ومن هنا ما وافق عليه العقل وافق عليه النقل وما وافق عليه النقل (الشرع) وافق عليه العقل – إن للقراءة دورها الفاعل في عملية الإحياء للجدب الثقافي لأفراد الأمة.. إذ “لا يخفى على القارئ العزيز السر في كون أول آية نزلت من السماء كانت تأمر الإنسان بالقراءة مخاطبة إيّاه بقوله تعالى “اقرأ ..” ونحن على إيمان بأن قراءة الإنسان للقرآن الكريم والأدعية، من شأنها أن تعمل على تطهير النفس من الأذران والشوائب وتجعلها طاهرة شفافة”[23]، الأمر الذي يتحقق معه حصول النفس على الوقود اللازم الذي يدفعها للتغيير ومعالجة الجدب الثقافي في الأمة، بل كيف سيكون هناك جدب ثقافي إذا كانت كل الأمة ريّانة قارئة؟ مبتعدة عن كل أسباب الترف واللهو والطرب من الدفوف والغناء[24] وكيف سيسعى الإنسان إلى إصلاح غيره وهو لم يصلح نفسه؟ إذ “عجبت لمن لم يصلح نفسه كيف يصلح غيره”، كما يروى عن علي عليه السلام؟
وكيف يتغير ما بالقوم – من جدب ثقافي – ونفوس القوم لم تتغيّر أفكارها الفاسدة التي لا تتلقى من الإسلام ولا تلتقي معه.. فـ«إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»؟
- التثقيف بمنهج القرآن ومنهج أهل البيت عليهم السلام:
إنّ التثقيف بمنهج القرآن ومنهج أهل البيت – عليهم السلام – يساوي الحياة الحقيقية للإنسان والماء الصالح العذب لإحياء الجدب الثقافي لأفراد الأمة.. وإنّ كل أمة أرادت لنفسها ولأفراد مجتمعها الإحياء من الجدب الثقافي الذي تعاني منه ولم تأخذ بهذين المنهجين – الذين هما في الحقيقة منهج واحد وحبل واحد وإن كانا – في الظاهر والتعبير – اثنين – فإن ماء إحيائها – المرجو – هو الملح الأجاج[25]..
وكذا لو أخدت بواحد من المنهجين وتركت الأخذ بالآخر فإن منهج إحيائها – المرجو – هو الماء الطاغي المختلط (الملح الأجاج) خصوصاً “في هذا العصر ما أصعب النجاة، وما أصعب السلامة وما أصعب تحقيق السعادة دنياً وآخرة.
إنّنا لا يمكن أن ننجو في عصر استفاد منه المجرمون من كل الأدوات والوسائل في سبيل إفساد الناس وتضليل العالم إلاّ بالرجوع إلى رسالة الله والعودة إلى منهاج أوليائه.. ولقد أرشدنا الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طريق الهداية والنجاة بقوله المشهور: “إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي” “[26].
- التحرك بحسب القدرة والطاقة:
لا شك في أن عملية الإحياء للجدب الثقافي في الأمة لا تعتمد على فرد أو فردين أو ثلاثة بل هي تحتاج إلى كل القوم وكل الأمة وكل قدرة وطاقة.” قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} إذن التغيير الأساس هو تغيير ما بنفس القوم والتغيير التابع المترتب على ذلك هو تغيير حالة القوم، النوعية، التاريخية، الاجتماعية، ومن الواضح أنّ المقصود من تغيير ما بالأنفس، تغيير ما بأنفس القوم ، بحيث يكون “المحتوى الداخلي” للقوم كقوم وكأمة وكشجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين، متغيراً وإلاّ تغيّر الفرد الواحد أو الفردين أو الأفراد الثلاثة لا يشكل الأساس لتغيير ما بقوم، وإنما يكون تغيير ما بالقوم تابعاً لتغيير ما بأنفسهم كقوم” [27].
إيماناً بأن التغيير الاجتماعي الصحيح تغيير عملي لا يغرق في الغيبة «إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» [الرعد: 11]، كما أنّه تغيير يعتمد العامل الداخلي لا الخارجي منطلقاً «حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ». [28]، وذلك “أنّ الآية الكريمة تتحدث عن تغييرين: أحدهما تغيير القوم: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ» يعني تغيير أوضاع القوم، شؤون القوم، الأبنية العلوية للقوم، ظواهر القوم، هذه لا تتغيّر حتى يتغيّر ما بأنفسهم”[29].
ونرى أنّ السبب الحقيقي هو مركب مزجي من عناصر متداخلة من الأسباب، الذاتية والخارجية، لكنّنا – في الوقت نفسه – نؤمن بضرورة تحطيم العقبات، والانطلاق نحو الفضاء الواسع المنفتح، كما نؤمن بأن المثقف [حين نتكلم عن دوره في التغيير] ملك كامل الآليات والقدرة على ذلك، وإن كان يحتاج منه إلى كدح ونشاط، لكنها طبيعة الحياة القائمة على الأسباب والمسببات”[30].
غير أني “.. أعتقد أن العملية الثقافية ينبغي أن تعطى كامل الحرية في الطرح وإبداء الرأي، وكل طاقة شابة تحمل في كوامنها شيئاً تريد البوح به لا ضير في تشجيعها وتوجيهها [لا أن تكون العملية الثقافية والتغييرية خاصة بالمثقف وطاقاته وقدراته دون غيره من القدرات] فهذا التصرف الحكيم كفيل ببناء أوّل لهذه الطاقة حتى يكتمل البناء”[31].
ويتحقق تغيير ما بالقوم.. عندما يتحقق تغيير كل الأبنية المتعددة.. حتى يكتمل البناء..
- التّعرف على قدرات العصر وإمكاناته:
ممّا لا شك فيه إن التعرف على قدرات العصر وإمكاناته يعني أشياء كثيرة للعاملين في حقل الرسالة الإسلامية والذين يسعون لخدمة المجتمع وتقديم وإيجاد الأعمال الهادفة فيه.. فممّا يعنيه ذلك: التعرف على:
1 – نقاط قوّة العدو الحضاري وأساليب المواجهة التي يواجهنا بها..
2 – وكذلك معرفة أساليب نقل الفكرة الحضارية وطريقة تقديمها.
3 – وكذلك الخروج من الإطار الضّيق الذي تعيش فيه الفكرة الهادفة.. إلى الإطار الواسع الذي يلتقي بالدنيا والعالم أجمع.. “لا سيّما في عالم الانفجار المعرفي والعلمي، الذي تعددت مصادره: كمّاً وكيفاً، بما يجعل غير المتابع يعيش على هامش الزمن والتاريخ وحركة الواقع المتسارعة”[32].
4- البحوث والدراسات المعاصرة حول الإسلام:
ممّا لا شك فيه إن مواكبة لغة العصر وأسلوبه من الحقول التي لا بدّ للعاملين في حقل الرسالة الإسلامية أن يتمكنوا منها في الصراع الحضاري وتعد البحوث والدراسات المقدمة حول الإسلام بلغة العصر شاهد هذه المواكبة.. “ففي جانب المطلق الثابت ننطلق من قيم الذات، وحقائق الدين والعقل، وقيم المجتمع الصحيحة، لأننا بحاجة إلى المثقف الفقيه كما أننا بحاجة إلى الفقيه المثقف…”[33].
وكذلك الحال فيما يتعلق بمواكبة العصر ولغته وأسلوبه ووسائله وإمكاناته “في جانب النسبي المتغير نأخذ بكل ما يستجد من سبل ووسائل نهضوية، «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» [الأنفال:60]. إن الأخذ بالأصالة – وحدها – يعني الانغلاق والجمود والتحجر..”[34].
وهذا “ما ابتلينا به في الحقبة الزمنية الماضية، كداء عضال أصاب الأمة الإسلامية والمسلمين، وخاصة عندما وجد صنف من العلماء المتقوقعين، ممن يرفضون التعامل مع معطيات الواقع الجديد بفهمه الجديد الذي يدخل ضمنه الالتزام بثوابت الإسلام وتراثه، إذ نحن لا ندعو إلى فهم منفصل عن الماضي”[35].
” كما أنّ الانفتاح – وحده – يعني الذوبان وفقدان الهوية ، والجمع بينهما هو الأخذ بجناحي الطيران للتحليق في سماء النجاح”[36].
- الحوار الحضاري والتبادل الثقافي:
إن الحوار الحضاري والتبادل الثقافي الذي يدخل فيه أفراد الأمة يعتبر من المقومات الأساسية لعلاج الجدب الثقافي في الأمة.. وذلك أنّ الحوار الحضاري والتبادل الثقافي عملية أخذ وعطاء واستفادة جديدة ومفيدة وعلم مستأنف لأنّ “في التجارب علم مستأنف[37] وخبرات وأساليب جديدة.. وخصب ثقافي بعد ذلك الجدب والموت الثقافي.. “من هنا ندرك أن المجتمع الحي لا بد أن يكون فيه حضور واضح للطبقة المثقفة (النخبة) على مسرح العمل والنشاط، بأن تتحول من مجرد مكتف باستهلاك الأفكار إلى المشارك في إنتاج الفكر وتطبيقه التطبيق الرشيد”[38].
فممّا لا شك فيه إن الأمة حين تخصب ثقافتها وينمو زرعها تستطيع أن تستهلك الفكرة والأسلوب والخبرة بكل وعي وعمق.. وتحاور وتتبادل في الثقافة.. وهي تملك المنهج الخصب والمقومات الأساسية لعلاج حالة الجدب فيها.. بل وتصدير منهجها وثقافتها.. بل وتصنع القرار المطلوب صنعه[39]..
ثالثاً: الملامح العامة لمقالات كتاب “أفكار هادفة”:
يمكننا أن نعدّد الملامح العامة لموضوعات كتاب “أفكار هادفة” في النقاط الآتية:
1- أنها تنطلق من معطيات إسلامية تريد أن تؤكدها وتدعو المجتمع لاتخاذها سلوكاً في حياته.. وكشواهد نصّية على هذا ما نلحضه في المقالات من بناء الفكرة على الآية أو الرواية أو الشعر..
2- أنها تمثل تجربة قلمية نابعة من معطيات آخذة في التقدم الفكري والثقافي أو بعبارة أخرى نابعة من فكر إذ “لكل فكر بؤرة يرتد إليها كل شيء باعتبارها مقياساً للصدق والأصالة والاستقامة، وينطلق منها كل شيء باعتبارها الذخر الأكبر للأصول الأساس في التكوين الثقافي للأمة”[40] ولا شك أنّ المقالات تنطلق – كما ذكرنا في الملمح الأول – من فكر قرآني في المعالجة…
3- أنها موضوعات تعالج مسائل وقضايا فكرية وسلوكيات اجتماعية.. “متنوعة المواضيع والأفكار، فمنها عن الشباب وطاقاتهم، وعن الشيوخ وتجاربهم، وأخرى عن الآباء والأبناء، وعن المرأة والزواج، وكذلك عن المؤمن وثقافته، وعن المثقف ودوره، وحول العلم وطلبه، وأخرى…”[41]
4- أنها موضوعات تطرح الموضوع كمشكلة وتحاول أن تقدّم الحلول المناسبة لها في شكل تساؤل وجواب عن هذا التساؤل… انطلاقاً من فكر يستند إلى المعطيات الإسلامية من آية ورواية وشعر..
5- أنها تجربة قلمية ريادية جريئة موفقة في طريق التخطيط لسبل مقومات المشروع الإحيائي للجدب الثقافي في الأمة بلحاظ الأهداف التي حدّدها المعدان للموضوعات والتي تتلخص في:
(أ) تقويم المجتمع: وتثقيف أفراده ومحاولة الرقي بهم.
(ب) نشر عادة القراءة والترويج لها.
(ج) تشجيع الطاقات والمواهب الكتابية لدى أبناء المجتمع[42].
وبلحاظ ما صدر لأحد المعدين من إنتاج فيما يمثله مشروعه الإحيائي – في نظره – للجدب الثقافي في الأمة.. فقد صدر – للأستاذ حسن آل حمادة – إنتاجان إحيائيان يلمس بوضوح من عنونة الإنتاج تبني “مشروع إحيائي” ينطلق من تخطيط مدروس تدل عليه شواهد من قبيل: العنونة التحتية للكتاب “أمة اقرأ… لا تقرأ: خطة عمل لترويج عادة القراءة”.
وهذا جاء عرضاً في بطاقة العمل النقدي هذه، الأمر الذي يحتاج إلى تسليط الضوء على هذا الإنتاج وموجه من خلال عرض الشواهد الدّالة عليه كالسرقة لأفكار الإنتاج في عمود كاتب في جريدة[43].. وكشهادة الإعجاب من أساتذة الفن والبحث[44].. وشهادة التقدير والشكر من مدير التعليم بالمنطقة الشرقية[45].. أو حتى الشواهد التي دلّل بها أصحابها على نوع حقد وغيرة في نفوسهم وأخلاقهم.. وكذلك شاهد الانتشار السريع للإنتاج وتناول الأيدي له والاستفادة من طرحه وأفكاره[46]..
خليل آل حمادة
الكتاب: أفكار هادفة
الكاتب: إعداد: حسن آل حمادة وبشير البحراني.
الناشر: دار الكنوز الأدبية – بيروت.
سنة النشر: ط1- 1420هـ.
عدد الصفحات: 163صفحة.
[1] إشارة إلى الآية (29)، سورة الفتح إشارة إلى الآية (29)، سورة الفتح
[2] المدرسة القرآنية، الشهيد محمد باقر الصدر، ط2. بيروت: دار التعارف، 1401هـ ، ص 29.
[3] كتاب “المدرسة القرآنية” عبارة عن محاضرات ألقاها الشهيد الصدر في النجف الأشرف على مجموعة من طلبة العلم وعامة الناس سنة 17/1/1399هـ في ظروف اجتماعية وسياسية خاصة تناولت موضوع منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وعناصر المجتمع، والسنن التاريخية.. راجع كتاب “محمد رضا النعماني” حول حياة الشهيد الصدر “الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار” عرض لسيرته الذاتية، ومسيرته السياسية والجهادية. 1417، مطبعة اسماعيليان.
[4] جدير الاطلاع على الموسوعة القرآنية “مفاهيم القرآن” للشيخ جعفر السبحاني، ليلاحظ القارئ العزيز رسائل الشكر وكلمات الإعجاب من العلماء والمجتهدين في حق هذه الموسوعة التي اتبعت منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.. لاحظ مثلاً رسالة الشهيد الصدر في رجب عام (1400هـ) ألقى محاضراته القرآنية وفق منهج التفسير الموضوعي سنة (17/1/1399هـ) وكذلك يلاحظ رسالة السيد الطباطبائي – صاحب تفسير الميزان – سنة 1393هـ وكذلك رسالة الشيخ محمد جواد مغنيه سنة (ج2/1396هـ) وغير ذلك.. يقول الشيخ السبحاني: “أجل يمكن القول بأن العلامة المجلسي هو أول من استعمل إجمالاً هذه الطريقة (التفسير حسب الموضوع)، فإنه في كتابه “بحار الأنوار” جمع الآيات المربوطة بكل موضوع في أول الأبواب، وفسّرها تفسيراً سريعاً بلا استنتاج منه. وهذه الخطوة القصيرة خطوة جليلة في عالم التفسير نأسف على أن المفسرين بعده لم يسيروا على ضوئها. ولا يمكن تفسير القرآن بالقرآن، والاستفادة الكاملة منه، وتلقى مفاهيمه العالية الصحيحة إلا بالمنهج المذكور.. يمكن مراجعة المجلد الثالث، ط2. بيروت: دار الأضواء، 1405هـ. ويمكن للباحث أن يعقد دراسة بعنوان: التفسير الموضوعي، منهج وتطبيق. لاحظ عرض الشهيد ومنهجيته في التعريف بالمصطلح في كتاب (المدرسة القرآنية)، ص 12-13. ولاحظ تعريف الشيخ السبحاني في موسوعته. المجلد الثالث، ص 33.
[5] كتاب “أفكار هادفة” من إعداد الأستاذ حسن آل حمادة ، والطالب الجامعي بشير البحراني، صدر عن دار الكنوز الأدبية، بيروت، 1420هـ، والكتاب عبارة عن أربع وعشرين مقالة، شارك في كتابتها ستة عشر كاتباً (التفاصيل خلال البحث) والدراسة النقدية هذه…
[6] إشارة إلى الآية القرآنية (104)، سورة آل عمران.
[7] يقول الشهيد الصدر: نتذكر من مصطلحات الفلاسفة “التميز الأوسطي” بين العلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائبة، لتوضيح الفكرة فالمجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل “أرضية العمل”. كما أن العلة الفاعلية تتمثل في الفرد أو الأفراد. المدرسة القرآنية، الدرس السادس، الأربعاء 4ج/2/1399هـ، ص 89
[8] حركة التاريخ عند الإمام علي – عليه السلام – دراسة في نهج البلاغة ، محمد مهدي شمس الدين،ط1. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1405هـ، ص 58.
[9] المصدر السابق، ص 59.
[10] المدرسة القرآنية، الشهيد الصدر، مصدر سابق، ص 89. ملاحظة: ذكرنا النظرية بدون التطبيقات القرآنية والأمثلة التاريخية.. وفق منهج التفسير الموضوعي للقرآن. كما طرح الشهيد الصدر – قدس سره-، راجع الدرس السادس.
[11] يقول الرازي في معجم “مختار الصحاح” مادة ذ ك ر. (التّفكر) التأمل والاسم (الفِكر) و(الفِكرة) والمصدر (الفَكْر) بالفتح وبابه نَصَر و(أفْكَر) في الشيء و(فَكّر) فيه بالتشديد و (تفكّر) فيه بمعنى ورجل (فِكِّير) بوزن سِكّيت كثير التفكر. مختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مكتبة لبنان، 1986، ص 213.
[12] حركة التاريخ عند الإمام علي – عليه السلام-، مصدر سابق، ص 55.
[13] المدرسة القرآنية، الشهيد الصدر، ص 139.
[14] حركة التاريخ عند الإمام علي – عليه السلام-، مصدر سابق، ص 59.
[15] أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، ج2، نقلاً عن كتاب “الأربعون حديثاً”، للإمام الخميني، ص 308
[16] الأربعون حديثاً، الإمام الخميني، ترجمة السيد محمد الغروي، لبنان، 1411هـ.
[17] كتاب “أفكار هادفة” المقدمة “بمثابة تقديم”، ط1، 1420هـ، ص 9-10. الموضوع الأول: القرار الخطير، للأستاذ / حسن آل حمادة، والموضوع الثاني: العادة عدوٌ متملك، للطالب الجامعي / بشير البحراني.
[18] كتاب “أفكار هادفة”، ص 10.
[19] في المثل الشعبي “مد رجلك على قدر لحافك” ويقصد به أن على الإنسان أن يتحرك في أموره المطلوبة بحسب ما يملك من قدرة وطاقة ومال…
[20] قال الزمخشري في مادة (ج د ب): جدب المكان جُدُوبة وجَدِب وأجدَب، نحو خَصِب وأخصَب. ومكان جَدب وجَديب، وأرض جَدبة وجديبة، وبلد مُجدِب وبلاد مَجَادِب… ومن المجاز: نزلنا ببني فلان فأجدبناهم إذا لم يجدوا عندهم قِرى وإن كان مُخصبين.. أساس البلاغة، الإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. بيروت: دار المعرفة، 1402هـ. وقال الرازي في مختار الصحاح: الجَدب: ضد الخصب.. و(أجدَب) القوم أصابهم الجدب.. و(الجدْب) أيضاً الغيب وفي الحديث “أنه جَدَب السَّمر بعد العِشاء” أي عابه. مختار الصحاح، مصدر سابق، ص 40. نسب الزمخشري الحديث “لعمر” وقال أيضاً ودعا رجل عُتبة بن غزوان إلى منزله، فقال: امْضِ في رَشَدِ الله وصحبته فما أتجدَّب أن أصحبك أي: لا أتذمّم. أساس البلاغة، ص 52.
[21] رسالتنا، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وجماعة العلماء، تقديم: السيد محمد حسين فضل الله، الدار الإسلامية، ص 51.
[22] فلسفتنا، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ط14. بيروت : دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ، ص 12.
[23] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “العلاج بالقراءة” وقد تناول الأستاذ: حسن آل حمادة، موضوع”القراءة” وأهميتها في معالجة الجدب الثقافي لأفراد الأمة – كما اصطلحنا – في دراسة ومعالجة لطيفة تناولت الإجابة على سؤالين كالآتي: (1) لماذا لا نقرأ؟ (2) كيف نستطيع أن نروج لعادة القراءة في أوساطنا الاجتماعية؟ والنص الذي اقتبسناه من مقالته يعالج آليات ومصادر القراءة.. فيما لو طرح سؤال “ماذا نقرأ؟ “أمة اقرأ… لا تقرأ: خطة عمل لترويج عادة القراءة”، حسن آل حمادة. ط1، الدمام: دار الراوي، 1417هـ.
[24] إذا لا حظنا – بدقة غلاف كتاب “أفكار هادفة” بشكله المقلوب – حسب طريقة الرسام “سلفادور دالي” – نجد واقعاً اجتماعياً وسلوكياً – (صورة فرقة موسيقية تدقّ الدّفوف) – يعكس فكراً ميّتاً (تراث) حسب تحليل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، في “حركة التاريخ عند الإمام علي (عليه السلام) ص 56، وبملاحظة المعنى اللغوي والمجازي لمادة “جَدْب” نجد أنّ هذا السلوك يشُخصّ على أنّه حالة “جدْب ثقافي” وإن القوم مخصبين ويمتلكون المقومات الإحيائية التي لا يستفيدون منها لسبب أو لآخر .. وكذلك تعبّر عن ثوابت مذموم ومعاب.. بل وتراث جاهلي بلحاظ ما قاله الرازي في مادة (د ف ف): (الدُّفُّ) بالضم الذي يضرب به والفتح لغة فيه..(مختار الصحاح) ص 87، وقال الزمخشري: “ومن المجاز: حفظ ما بين الدفتين وهما ضما ما بين المصحف من جانبيه. وقرع دّفتي الطبل وهما جلداه” (أساس البلاغة) ص 132، وبلحاظ أن “أشهر آلات الموسيقى عند الجاهليين العرب (الدُّف) وهو أشكال منها المستدير والمربّع والكبير والصغير، و (المزمار) على أبسط أنواعه…” (الغِناء في الإسلام)! علي العسيلي العاملي. ط 1، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1404هـ، ص 18. أقول: ومن الحقيقة إن عقيدة الشيعة الإمامية (الاثنا عشرية) في القرآن هي أنَّه – ما بين الدفتين – محفوظ ومصون من التحريف والنقصان وهو كما أنزله الله تعالى، وما عليه نسخ المسلمين المتداولة، انظر مجلة “الكلمة” فكرية ثقافية تصدر من بيروت، ع (23) السنة السادسة، ربيع 1420هـ / 1999م موضوع “اجتماع دولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية” إعداد الأستاذ / محمد دكير.
[25] إشارة إلى الآيات القرآنية التالية “مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان” [الرحمن: 19-20]، بلحاظ “هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج” [فاطر: 21].
[26] كتاب ” أفكار هادفة ” موضوع ” طريق النجاة والسعادة ” لكاتبه ، الشيخ / محمد العوامي ، ص 98
[27] المدرسة القرآنية، الشهيد محمد باقر الصدر. ص 141
[28] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “المثقف والدور المرتجى.. غياب أو تغييب”، الشيخ علي آل موسى، ص 131.
[29] المدرسة القرآنية، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ص 141.
[30] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “المثقف والدور المرتجى.. غياب أم تغييب”، ص 37.
[31] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “أهمية التشجيع للطاقات الشابة” للكاتب / عقيل المسكين، ص 21.
[32] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “المثقف والدور المرتجى.. غياب أو تغييب”، الشيخ علي آل موسى، ص 133
[33] المصدر السابق، ص 135
[34] المصدر السابق، ص 135. المصدر السابق، ص 135.
[35] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “الوجه الآخر لحب الذات” الأستاذ زكي القطان. ص 153
[36] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “المثقف والدور المرتجى.. غياب أم تغييب” الشيخ علي آل موسى، ص 132.
[37] يروى عن علي (عليه السلام).
[38] كتاب “أفكار هادفة” موضوع “المثقف والدور المرتجى.. غياب أو تغييب”، الشيخ علي آل موسى، ص 132.
[39] حول المقومات الأساسية لمعالجة حالة الجدب الثقافي لأفراد الأمة، راجع مثلاً (اقتصاداً) للشهيد محمد باقر الصدر. بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1411هـ، حول العناصر الثلاثة التي تتكون منها التربة أو الأرضية للمجتمع الإسلامي وهي (1) العقيدة (2) المفاهيم (3) العواطف والأحاسيس التي يتبناها الإسلام، ص 292. مثلاً: لو واجه العقل هذه القضية، هل الأخذ بمنهج القرآن وأهل البيت عليهم السلام يعد من المقومات الأساسية لمعالجة حالة الجدب الثقافي لأفراد الأمة بل وحتى حالة الجدب الاقتصادي.. أم لا؟ لا شك أن العقل يرى في أن الأخذ بمنهج القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) وتطبيق ذلك في الواقع من المقومات الأساسية لمعالجة حالة الجدب المذكورة.. ما نريد قوله: إن المقومات التي ذكرها هي مما يوافق عليها العقل والشرع.
[40] حركة التاريخ عند الإمام علي (عليه السلام)، مصدر سابق، ص 59.
[41] كتاب “أفكار هادفة”، بمثابة تقديم، كلمة المعدين، الأستاذ / حسن آل حمادة، والطالب الجامعي / بشير البحراني، ص 10.
[42] نفس المصدر، ص 9.
[43] قصة السرقة هذه طويلة: وخلاصتها أن الأستاذ: ناصر اليحيوي، مدير مدرسة “حراء الثانوية” والكاتب في جريدة “الندوة” كتب في عموده في “صفحة الحوار المفتوح” وقد عرض في عموده الذي وضع عنوانه لهذه المرة “أمة اقرأ… لا تقرأ”، تلخيصاً لأفكار ومطالب كتاب الأستاذ / حسن آل حمادة، وقد احتجّ الأستاذ حسن على ذلك وراسل بالفاكس رسالة لمدير المجلة ضمنها خطاب طويل ومفصل مع نسخة من الكتاب، وقد طلب مدير المجلة من الأستاذ اليحيوي أن يرد على الاحتجاج فلم يرد. (التفاصيل في جريدة الندوة الصادرة يوم الاثنين 10 ربيع الأول 1418هـ، العدد 11764، وكذلك جريدة الندوة يوم الأربعاء 26/3/1418هـ.
[44] قال الدكتور / عباس طاشكندي وهو أستاذ بقسم “المكتبات والمعلومات” في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، “لقد شعرت وأنا اقرأ دراستكم بفخر كبير وإعجاب شديد، ذلك أنني توسمت فيكم تلك النباهة، وصدق حدسي… وسوف أستفيد من دراستكم فائدة جمة” وقال أيضاً مشيراً إلى الكتاب “وهو على صغر حجمه كبير في مضمونه، عميق في أفكاره وطروحاته. وأصدقك القول أنني قرأته بمتعة كبيرة فشد اهتمامي، خاصة وأنني أشتغل الآن على بحث.. تحتل القراءة فيه حيزاً كبيراً”.
[45] جاء في رسالة مدير التعليم بالمنطقة الشرقية ما يلي نصه: ” المكرم الأخ الأستاذ / حسن آل حمادة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم بجزيل شكري وتقديري على إهدائكم لنا نسخة من كتابكم “أمة اقرأ… لا تقرأ”… سائلاً المولى عز وجل أن يوفقكم لمزيد من العطاءات لخدمة (أبناءنا الطلاب)” مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور: صالح بن جاسم الدوسري، 26/6/1418هـ.
[46] طبع من الكتاب “2000” ألفان نسخة، وزعت داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وللكتاب صداه في المجتمع وعند طلبة المدارس الأكاديمية وهو محل الإعجاب والحديث