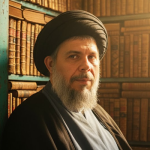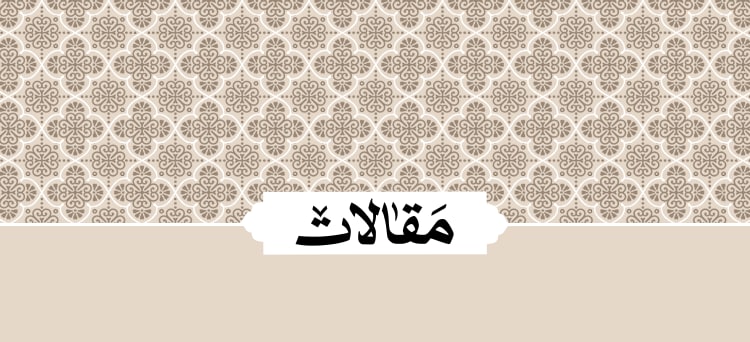لا تقتصر اهمية السيد محمد باقر الصدر على مساهماته الفكرية الكبيرة التي عالجت منهج النظرية الإسلامية في الاقتصاد، والفلسفة والمجتمع فحسب وانّما تنبع من أنّه كان على رأس مؤسسة دينية تمتدّ في ماضيها إلى ما يقرب من عشرة قرون من الزمن.
فقد تشكّلت هذه المؤسسة على الهيئة المتوارثة منذ بداية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، واصبحت مؤسسة دينية لها مرتكزات خاصة بها على يد فقهاء بغداد (الشيخ المفيد، الشريف المرتضى، الشيخ الطوسي) في أيام الدولة البويهية بسبب الحرية الفكرية التي منحها البويهيون لجميع التيارات، والمذاهب الدينية، والفلسفية، والكلامية، من الاشاعرة والمعتزلة، والزيدية، والاثنا عشرية، وغيرهم.
وقد تميّزت هذه المؤسسة الدينية بنمط من الفقهاء يتشابهون في عطائهم الفكري وتوجهاتهم السياسية أو المحايدة وان تباعدت فواصل الزمن بينهم.
انّ تقريب أوجه التشابه بين فقهاء الامامية لا يعني بالضرورة مبدأ المطابقة التام بينهم في جميع الاتجاهات وعلى ذلك يمكن ايضاح دور فقيه. في فترة زمنية محددة مع دور فقيه آخر في فترة اخرى من خلال هذا التقسيم:
1ـ المنحى التوفيقي، والتوازن العلمي:
ويمثل هذا الاتجاه:
1ـ الشيخ الطوسي(460 هـ/1068م).
2ـ المحقق الحلي(676 هـ / 1277م).
3ـ الشيخ مرتضى الانصاري(1281 هـ / 1864م).
4ـ السيد أبو القاسم الخوئي(1413 هـ / 1992م).
حيث يتميّز هؤلاء الفقهاء بمنهج التوازن العلمي، فيتشابه الطوسي مع المحقق الحلي بأنه استطاع عن يمتص «الصدمة» التي ولّدها الاتجاه العقلي الحاد الذي تبنّاه استاذاه: الشيخ المفيد والشريف المرتضى منهجاً في مؤلفاتهما، وذلك بالتوفيق بينه وبين الاتجاه النقلي، كما استطاع ان يعيد جملة من آرائهما في علم الكلام وغيره من العلوم من خلال اختصار بعض مؤلفاتهما، وتنقيح مطالبهما العلمية.
أما المحقق الحلي فهو بدوره واجه المشكلة نفسها في (مدرسة الحلّة) في القرن السابع الهجري، حيث امتصّ الصدمة القوية التي ولّدها المنحى العقلي الحاد للفقيه ابن ادريس الحلي(598 هـ / 1201م) كما استفاد من تطوير آرائه النقدية بعيداً عن الحملة التي شنّها ضد شيخ الطائفة الطوسي.
اما الشيخ الانصاري والسيد الخوئي فهما يمثلان المنحى العلمي المتوازن من خلال اصالة مدرستهما الاصولية والفقهية وان كان الخوئي يعدّ في نهاية المطاف آخر المراجع الذين اعتمدوا منهج الانصاري ومن الذين أقفلوا الباب بعده.
2ـ منحى تأييد الفقيه للسلطة
ويمثّل هذا الاتجاه الفقيهان:
1ـ الشيخ نور الدين علي بن الحسين المعروف بالمحقق الكركي(940 هـ / 1533م0.
2ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء(1228 هـ / 1813 م).
حيث تصدّى الكركي إلى دعم مشروع الدولة الصفوية في القرن (العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي) بازاحة الطرق الصوفية واحلال عقائد الاثنا عشرية فحلها وقد اُبعد الكركي إلى العراق مرتين، وقُتل بطريقة غامضة على يد الصفويين أنفسهم عام(940 هـ / 1533م).
أما الشيخ جعفر كاشف الغطاء فقد كان متفانيا في دعم الشاه فتح علي القاجاري ومتقرباً إليه بمنحه الصلاحيات الدينية التي يمتلكها على الرغم من أنّ «الشاه» لم يكن مندفعاً في تأييده إلاّ بما يحققه من اضفاء الشرعية الدينية على حكمه مع ملاحظة أن (الفقيه) و (الحاكم) في كلا المرحلتين (الصفوية والقاجارية) ينتميان إلى (مذهب) مشترك.
3ـ المنحى المذهبي، والمنحى السياسي:
ويمثّل هذا الاتجاه:
1ـ العلاّمة الحلّي(726 هـ / 1325م).
2ـ السيد مهدي القزويني(1300هـ / 1883م).
3ـ الامام الخميني(1410 هـ / 1989م).
حيث كانت للعلامة الحلي. في فترة الحكم المغولي. اليد الطولى في التبشير بالمذهب الاثنا عشري ونشره أيام السلطان اولجاتيو (خدابنده) الذي أعلن (التشيّع) رسمياً في السلطنة المغولية.
ويشترك السيد مهدي القزويني مع العلاّمة الحلّي في نجاحه بتحويل مجموعة قبائل زبيد الممتدة منازلها بين دجلة والفرات من شمال الكويت إلى منتصف الطريق إلى بغداد إلى المذهب الاثنا عشري بعد هجرته من النجف إلى الحلة سنة 1253 هـ / 1837م: وقد لُقّب من جرّاء ذلك بلقب معزّ الدين كما اطلق بعض مترجميه عليه لقب العلاّمة الثاني وهذا اللقب ربما تأتّى من غزارة النتاج العلمي ومتانته عند كلا من الفقيهين مع تشابه جهودهما في نشر المذهب الاثنا عشري.
ويلاحظ انّ تحرّك العلاّمة الحلي كان تحركاً رسمياً، بينما كان القزويني معتمداً على جهوده الذاتية وعلاقته المباشرة بالقبائل العربية الخاضعة لسلطان الحكم العثماني السنّي.
امّا الامام الخميني فهو نسيج وحده في صراع الفقيه مع السلطان: حيث اعتمد على المنحى السياسي العام في صراعه مع الامبراطورية الشاهنشاهية بعيداً عن اللجوء إلى الذريعة المذهبية في المواجهة حيث دار الصراع بين «فقيه» شيعي، و«ملك» شيعي، وقد نجح الخميني في اسقاط الملكية واقامة الحكم تحت ظل جمهورية الفقهاء.
4ـ منحى الشهادة:
اما النمط الاخير فيمثله:
1ـ الشهيد الاول محمد بن مكي العاملي(786 هـ / 1384م).
2ـ الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي(965 هـ / 1557م).
3ـ الشهيد الثالث محمد باقر الصدر(1400 هـ / 1980م).
فهم يلتقون بغزارة التأليف والتجديد في الدرس الفقهي وبالشهادة أيضاً، حيث نال الشهيد الاول درجة الشهادة على يد الدولة المملوكية التي استعملت الذريعة المذهبية بفتوى اثنين من قضاة المماليك أحدهما شافعي، والآخر مالكي حيث تواطأ هذان القاضيان على ايراد الشهيد الاول مورد التهلكة، فصدر الحكم عليه بالموت قتلاً، ثم صلباً، ورجماً، واحراقاً، وذلك في قلعة دمشق بمحضر من الفقهاء، ورجال الدولة، وحشود جماهيرية عارمة.
اما الشهيد الثاني فقد اغتالته الدولة العثمانية حينما استدعاه السلطان العثماني إلى اسطنبول للتحقيق معه في وشاية لمذهبية (كما تقول النصوص التأريخية)، وقد اختفت اخباره بعد ذلك: وقيل انّه قُتل قبل ان يصل إلى (الباب العالي)، وبقي سرّ مقتله خفياً في كتب التراجم والتاريخ.
اما الشهيد الثالث: السيد محمد باقر الصدر فقد قُتل في بغداد تحت طائلة التعذيب الجسدي، وذلك بقطع أصابع كفيه واحراق وجهه بالنار وتهشيم رأسه بمسمار كبير ولم يكن مقتله بدافع طائفي، وانما كان بدافع سياسي محض، وذلك بسبب الاضطرابات التي طالت العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران عام 1979م.
والملاحظ أنّ الشهيد الاول والشهيد الصدر قتلا في بلادهما وعلى يد حاكم من البلاد نفسها: في حين ان الشهيد الثاني كان قد قُتل على يد العثمانيين الأتراك بعيداً عن وطنه.
كما أنّ الشهيد الاول والشهيد الصدر كانا قد سعيا إلى المرجعية المطلقة للطائفة لكنّ الزمن لم يسمح لهما لأن يكونا مرجعين عامّين للشيعة الامامية بسبب شهادتهما.
اما الشهيد الثاني فلم يوفّر الظروف العدائية التي انعكست عليه في بلاد الشام من جرّاء الصراع الصفوي ـ العثماني الوقت المناسب ليكون مرجعاً بدرجتيهما من ناحية الاتباع.
المرجعية الشهيدة:
من هنا يمكن دراسة أعمال الامام الصدر باعتباره ممهّدة لفترة ثقافية جديدة بما تضمنته من دراسات حديثة خارجة عن المنحى المألوف في الدراسات العلمية النجفية.
ويمكن حصر جهوده في مرحلتين:
المرحلة الاولى:
تبدأ منذ الستينات الميلادية حتى بداية السبعينات حيث عمل الصدر خلالها على ملء الفراغ الفكري الذي كانت الساحة الإسلامية بحاجة إليه وذلك بعد نشاط الحزب الشيوعي في العراق بعدما وقع الاسلاميون في اشكالية (الاطروحة البديلة) التي تعتمد رؤيتهم الفكرية المستقلة.
قدّم الصدر دراستين: الاولى بعنوان (فلسفتنا، 1959م) والثانية (اقتصادنا 1961م) تناول في الكتاب الاول مسألتين فلسفيتين مقارنتين بالنظم الفلسفية المادية، وهما نظرية المعرفة، والمفهوم الفلسفي للعالم.
وقد نقد الفلسفة الماركسية نقداً عنيفاً لم يستطع الماركسيون مجابهته، أو نقضه خلال ثلاثة عقود من الزمن حتى انهيار الشيوعية في العالم اوائل السبعينات الميلادية.
اما كتاب (اقتصادنا) فقد ناقش المذهبين الماركسي والرأسمالي مقدّماً تصوراته عن النظرية الاقتصادية الإسلامية
المرحلة الثانية:
بدأت منذ السبعينات الميلادية وانتهت بقتله عام 1980م، وفي هذه المرحلة تفرّغ الصدر للوصول إلى (المرجعية)، وأصدر جملة تأليفات في الفقه والاصول، كما طُبعت تقريرات بحوث دراساته العالية بأقلام بعض تلامذته المجتهدين.
وقد ركّز جهوده على:
1ـ تطوير (الرسالة العملية):
وهي كتاب يتناول الابواب الفقهية على شكل مسائل يحتاجها المكلفون في حياتهم اليومية في جانبي العبادات والمعاملات. وقد اعتاد الفقهاء الذين يصلون إلى درجة (المرجعية) ان ينشروا مسائل الاحكام الشرعية طبقاً لفتاواهم بكتاب يرجع اليهم اتباعهم بالرأي ويسمّى هذا الكتاب «بالرسالة العملية» وقد بدأت بالظهور منذ منتصف القرن الرابع الهجري حيث ألّف الشريف المرتضى كتاب «جمل العلم والعمل» وهو في ترتيبه يشبه إلى حدّ كبير ترتيب الرسائل العملية التي اُلّفت بعده.
وبمرور الزمن فقد تطوّر اسلوب الرسائل العملية واُضيفت اليها زيادات في أصول الاعتقاد وفي الابواب الفقهية المستجّدة.
ان اهتمام الصدر بتطوير الرسالة العملية ظهر من خلال كتابه «الفتاوى الواضحة» الذي يدل اسمه على مسمّاه. فقد استعمل الاسلوب العصري الذي يفهمه الناس من خلال استخدام لغة مبسّطة واضحة تختلف عن اللغة التي ألّفها اسلافه فيما كتبوه من رسائلهم العملية، كما ساهم أيضاً باعادة ترتيب الابواب الفقهية التي تسالم عليها فقهاء الامامية منذ عصر المحقق الحلّي الذي قسّمها في كتابه «شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام» إلى اربعة اقسام: وهي:(1ـ العبادات، 2ـ المعاملات، 3ـ الايقاعات، 4ـ العقود).
اما تقسيم (الفتاوى الواضحة) فهو كالآتي: «1ـ العبادات، 2ـ الاموال، 3ـ السلوك الخاص، 4ـ السلوك العام».
2ـ تطوير المنهج الدراسي:
حيث سعى الصدر إلى استبدال كتب في علم الاصول كتبها بنفسه بالكتب الدراسية القديمة ابتداءً من المرحلة الاولى لدراسة هذا العلم حتى المرحلة النهائية التي تؤهّل الطالب لحضور بحوث المجتهد، والتي يُصطلح عليها بـ «البحث الخارج»، وقد كتب بهذا الصدد «دروس في علم الاصول» طُبعت عام 1978م. احتلت مكانتها الرسمية في مراكز التدريس الدينية، كما صدرت شروح لها من قبل بعض المتخصصين بدراسة هذا العلم، وتدريسه.
3ـ اطروحة المرجعية الصالحة:
أراد الصدر أن ينقل المرجعية من حالتها الفردية إلى مؤسسة ثابتة تعتمد على التخصص في الاشراف العلمي وادارة الاعمال، وقد ألقى تصوراته بهذا الشأن على شكل محاضرات في بداية السبعينات الميلادية على جملة من طلابه، لكنها لم تنشر إلاّ بعد وفاته من قبل أحد تلامذته المجتهدين.
المرجعية الشهيدة:
احتلت مرجعية الصدر مكانتها في تاريخ الاثنا عشرية، وتذكرنا جهود الصدر الضخمة في مجال العلوم العقلية بجهود العلاّمة الحلي في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي الذي اُعتبر فاتحة لعصر جديد: حيث اصطُلح على الفقهاء الذين سبقوه بمصطلح «المتقدمين» والذين أتوا بعده بمصطلح «المتأخرين»، ويمكن ان يُعدّ عصر الصدر. فيما بعد. مرحلة فاصلة بين مرحلتين في تأريخ الفقهاء الامامية.
اما العناصر التي تميّز هذه المرجعية فهي:
1ـ انها مرجعيّة فكرية منفتحة على تيارات العصر، ومشكلاته المتطورة.
2ـ انها مرجعية تركت آثارها التجديدية في مسلك المرجعيات المعاصرة لها.
3ـ انها مرجعية شهيدة: تدلل على الخلفية الاصلاحية، والسياسية التي تتمتع بها.
منهج دراسة الصدر:
وتجدر الملاحظة إلى ان فترة ما بعد الصدر لم تفرز مجتهداً يضاهيه بالتنوّع العلمي، والاستلهام أو السعي إلى تطوير معطياته الفكرية، وتبسيطها سوى ما ظهر من نتائج بحوثه في علم الاصول التي اصدرها بعض تلامذته الكبار، وهي بحدّ ذاتها كتبت لأمثالهم من المتخصصين في الدراسة المنهجية العالية.
ومن جانب آخر فانّ أغلب الكتابات التي نشرت عن الصدر بأقلام «موالية» اتصفت بالتقريرية البعيدة عن مناهج البحث العلمي.
وقد أضفت معظم هذه الابحاث صفة «القداسة» على مجمل أعماله الفكرية والنصوص التي تركها بعده حتى تذكرنا فترة ما بعد الصدر بتيّار «المقلّدة» الذي ظهر في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي بعد رحيل شيخ الطائفة الطوسي حيث بقي الفقهاء ثابتين على النصوص التي تركها حتى ظهور ابن ادريس الحلّي الذي أزاح هذه القدسية المستلهمة من تراث الطوسي، وأرجع حركة الاجتهاد إلى مسيرتها المواكبة للتطور.
واذا كان لذلك العصر ما يبرره من أسباب توقف الحركة العلمية وتحكم نتاج جهود القرن الخامس الهجري بما بعده من قرون: فليس لهذا العصر ما يبرره بعد الانفجار الذي وقع في العلوم النظرية، والثورات العلمية المتجددة، وتوفر الوسائل المعرفية.
وبالرغم من دراسات الصدر في الفلسفة والاقتصاد، واجتهاده بتفسير بعض النصوص القرآنية وقراءة التاريخ والتي تضعه في مصاف الكتّاب الكبار: فانّها والحال هذه لا تعبّر عن المنهج التطبيقي المتكامل الذي ينطبق على مفردات هذه العلوم.
ومثال واحد يشير إلى التسامح في تفسير موروثات الصدر بما نلاحظه في المحاضرات التي القاها على طلبة العلوم الدينية في النجف، والتي نشرت بعنوان «محاضرات في التفسير الموضوعي للقرآن» حيث اختار موضوع «السنن التاريخية في القرآن»، وأشبع الحديث فيه.
وقد أشرتُ فيما نشرته عن الامام الصدر إلى أنّ هذه المحاضرات القرآنية كانت محاضرات سياسية القيت في فترة حرجة وذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية الايرانية عام 1979م، وتأثر التيار الاسلامي في العراق بها فكان الصدر قد تنبّأ في محاضراته هذه إلى حتمية انهيار النظام الذي وصفه بالنظام الفرعوني القائم على الاستبداد، وكذلك المجتمع الذي يرزح تحته ومن ثم برر صراعه مع هذا النظام على انّه صراع يهدف إلى ازاحة التسلّط الفردي عن السلطة واحلال سلطة القانون محلة. وأكّد أنّ مواجهته مع النظام لا تحقق النصر له لتوقف ذلك على الاستعداد. وتوفير القوة المتكافئة، كما ذكر أيضاً انّه لا يستطيع انجاز مشروعه في تفسير القرآن لأيام المعدودة المتبقية من حياته.
وتعيد هذه المحاضرات للاذهان ما كتبه عبدالرحمن الكواكبي(1320 هـ/ 1902م) من بحوث طُبعت عام 1900 م في كتاب «طبائع الاستبداد» والتي عالج فيها الصيغة التي اقترحها لنهضة عربية موحدة، وكذلك ما كتبه الشيخ محمد حسين النائيني(1355 هـ / 1936م) في أحداث صراع الحركة الدستورية مع الملكية القاجارية في دراسة طبعت تحت عنوان «تنبيه الاُمّة وتنزيه الملّة» والتي تُعتبر أول بحث تناول الفكر السياسي الشيعي في مسألة الحكم. وقدم حلاً في شرعية الدولة. ولم يسجّل التاريخ السياسي الشيعي بحثاً سياسياً صريحاً. قبل رسالة النائيني إلاّ ما كتبه الشريف المرتضى «في القرن الخامس الهجري» في مسألة جواز «العمل مع السلطان» الذي يبرز فيه صلة الفقيه بالسلطة البديهية.
ان جهود الإمام محمد باقر الصدر في معالجة قضايا الفكر الاسلامي بشكل عام وقضايا التجديد في التراث الشيعي بشكل خاص سوف تضيف إلى وهجه العلمي وهجاً آخر ناضحاً من دم الشهادة.
انّ محمد باقر الصدر هو الشهيد الثالث في تاريخ (المرجعية الشهيدة)!
جودت القزويني