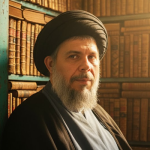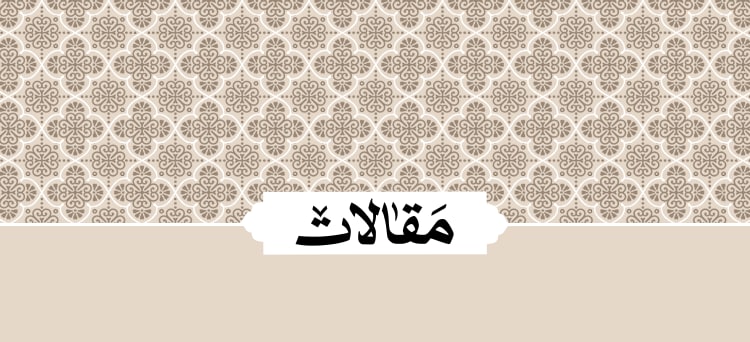1ـ مدخل
أطل الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (1932 ـ 1980) على المسرح الحضاري، في لحظة تاريخية بالغة الأهمية على الصعيد المحلي (العراق) وعلى الصعيد الإقليمي (العالم الإسلامي) وعلى الصعيد العالمي.
والسمة المشتركة لهذه الصعد الثلاثة، في لحظاتها التاريخية تلك، تمثلت في احتدام الصراع الحضاري بين خيارات حضارية متعددة، أشار إليها الإمام الشهيد في مقدمة كتاب فلسفتنا، حيث قال:
(إن أهم المذاهب الإجتماعة التي تسود الذهنية الإنسانية العامة اليوم، ويقوم بينها الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الإجتماعي في حياة الإنسان هي مذاهب أربعة:
1ـ النظام الديمقراطي الرأسمالي.3ـ النظام الشيوعي.
2ـ النظام الإشتراكي. 4ـ النظام الإسلامي [1].
وإذا كان الصراع الحضاري بين الأطروحة الإلهية ممثلة في النظام الإسلامي والأطروحة الوضعية ممثلة بالأنظمة الثلاثة الأول، ذا أفق عالمي واضح، فإن الإمام الشهيد قرر أن ينزل حلبة المعركة ويخوض هذا الصراع، في إحدى حلقاته (المحلية) ذات الأهمية البالغة، ونعني بها الغراق. ففي ستينات هذا القرن، وتحديداً بعد انهيار النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري في 14 تموز عام 1958، كان العراق ساحة صراع حقيقي بين مشروعين حضاريين، هما:
المشروح الحضاري الإسلامي، والمشروع الحضاري الوضعي، الذي وجد تمظهراته في صيغ مختلفة، تفاوتت من (الليبرالية) الرأسمالية إلى الشيوعية الماركسية، وكان لهذا المشروع الحضاري على إختلاف تياراته، أحزابه السياسية وأدواته الصراعية، بينما كان الإسلام يقف شبه أعزل، ويتعرض لهجمات شعواء، حتى قدر الله للإسلام الفقيه الشاب السيد محمد باقر الصدر، الذي رفع الراية وقرر خوض الصراع بكافة أبعاده، متسلحاً بفهم متميز للإسلام، وبفهم معمق للواقع، وكانت حصيلة هذين الفهمين (المشروع الحضاري الإسلامي) الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه المقالة.
على المستوى العالمي، كان الشهيد الصدر يدرك أن جوهر الأزمة الحضارية يمكن في تشخيص (النظام الإجتماعي) الصالح، الذي (يصلح للإنسانية وسعد به في حياتها الإجتماعية)[2] وتعاني البشرية من ألوان (المآسي والمظالم)، ويعود السبب في هذا، إلى عدم توصلها إلى معرفة النظام الصالح.
ولم تتوصل البشرية إلى حل أزمتها الحضارية، في العصر الراهن، رغم أن احساس الإنسان المعاصر بالمشكلة الإجتماعية أشد من إحساسه بها في أي وقت مضى من أدوار التاريخ القديم من جهة، ورغم أن الإنسان الحديث، من ناحية أخرى، أخذ يحقق تطوراً هائلاً في سيطرته على الطبيعة لم يسبق له نظير، لكن هذه السيطرة تزيد المشكلة الإجتماعية تعقيداً وتضاعف من أخطارها، لأنها تفتح أمام الإنسان مجالات جديدة وهائلة للإستغلال[3]. وفي تحليله لطبيعة الأزمة الحضارية التي تعاني منها البشرية، لم يتوقف الشهيد الصدر عند الكثير من الهموم اليومية والمشاكل المتنوعة، وإنما حاول أن ينفذ إلى (عمق المشكلة وجوهرها)، وقد أوصله هذا البحث إلى وضع اليد على (مشكلة رئيسية ثانية ذات حدين أو قطبين متقابلين بعاني الإنسان منهما في تحركه الحضاري على مر التاريخ، وهي، من زاوية، تعبر عن مشكلة الضياع واللإنتماء، وهذا يمثل الجانب السلبي من المشكلة، وزاوية أخرى تعبر عن مشكلة الغلو في الإنتماء والإنتساب، بتحويل الحقائق النسبية التي ينتمي إليها إلى مطلق، وهذا يمثل الجانب الإيجابي من المشكلة)[4].
وهاتان هما مشكلتا الإلحاد والشرك. ونضال الإسلام ضدهما هو (في حقيقته الحضارية نضال ضد المشكلتين بكامل بعديهما التاريخيين)[5].
أما على مستوى العالم الإسلامي، فقد شخص الشهيد الصدر أبعاد مشكلته الحضارية بثلاثة أمور، هي: عدم تطبيق الإسلام، الإستعمار والتبعية، وأخيراً: التخلف العام.
ففي سياق تحليله لشروط النهضة، في افتتاحية العدد الأول من مجلة الأضواء النجفية الصادر في 15 ذي الحجة 1379هـ، قال الإمام الشهيد أن الشرط الأساسي لنهضة الأمة هو أن يتوفر لديها المبدأ الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها ويضع لها مثلها العليا، ويرسم اتجاهها في الحياة، ويعني (توفر المبدأ الصالح) ثلاثة أمور هي: وجود المبدأ الصحيح أولاً، وفهم الأمة له ثانياً، وإيمانها به ثالثاً[6]. والأمة الإسلامية تملك العنصرين الأول والثالث، ولكنها تفتقد للعنصر الثاني، وهو (فهم المبدأ)[7]، حيث لا تعرف الأمة من الإسلام شيئاً واضحاً محدداً أو تعرف ما زوره المستعمرون من أفكاره وحقائقه[8]. وطبيعي أن جهل الأمة بالإسلام يحول إيمانها به إلى (عقيدة باهتة)[9] لا تؤدي الكثير على صعيد الحركة الحضارية للأمة، من جهة، ولا تفعل الكثير على صعيد تطبيق الإسلام من قبل الأمة، من جهة ثانية.
ويعاني العالم الإسلامي من مشكلة الإستعمار والتبعية، وقد أشار الشهيد الصدر إلى هذه المشكلة وآثارها المدمرة على الإسلام والمسلمين في وقت مبكر من كتاباته العلنية، ففي افتتاحية العدد الأول لمجلة الأضواء، التي أشرنا إليها قبل قليل، أرجع الإمام عدم فهم الأمة للإسلام فهماً صحيحاً إلى (المؤامرات الدنيئة المستترة تارة والسافرة أخرى من أبناء الصليبيين المستعمرين أعداء الإسلام التاريخيين، تلك المؤامرات الهائلة التي شنوها علي الأمة وكيانها حتى انتهت بالغزو الإستعماري المسلح)[10]. وحين انتصرت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، قال الشهيد الصدر أن الإنسان الغربي وعلماءه المثقفين هم الذين حجبوا نور الإسلام (وبذلوا كل وسائلهم من الإحتلال العسكري إلى التشويه الثقافي والتحريف العقائدي في سبيل ابعاد العالم الإسلامي عن هذا النور، لكي يضمنوا لأنفسهم السيطرة عليه، ويفرضوا عليه التبعية)[11].
ولاحظ الشهيد الصدر أن هذه (التبعية) عبرت عن نفسها بأشكال ثلاثة مترتبة زمنياً، ولا تزال هذه الأشكال الثلاثة متعاصرة في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي، وهي:
ـ الأول: التبعية السياسية، التي تمثلت في ممارسة الشعوب الأوروبية الراقية اقتصادياً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة.
ـ الثاني: التبعية الإقتصادية التي رافقت قيام كيانات حكومية مستقلة من الناحية السياسية في البلاد المتخلفة، وقد تجسدت التبعية عملياً عندما فسح المجال للإقتصاد الأوروبي لكي يلعب على مسرح تلك البلاد بأشكال مختلفة، ويستثمر موادها الأولية، ويملأ فراغاتها برؤوس أموال أجنبية، ويحتكر عدداً من مرافق الحياة الأقتصادية فيها، بحجة تمرين أبناء البلاد المتخلفين على تحمل أعباء التطور الإقتصادي لبلادهم.
ـ الثالث: التبعية في المنهج، التي مارستها تجارب عديدة في داخل العالم الإسلامي، حاولت أن تستقل سياسياً وتتخلص من سيطرة الإقتصاد الأوروبي، وأخذت تفكر في الإعتماد على قدرتها الذاتية في تطوير اقتصادها والتغلب على تخلفها، غير أنها لم تستطع أن تخرج عن فهمها لطبيعة المشكلة التي يجسدها تخلفها الإقتصادي عن إطار الفهم الأوروبي لها، فوجدت نفسها مدعوة لاختيار نفس المنهج الذي سلكه الإنسان الأوروبي في بنائه الشامخ لاقتصاده الحديث[12].
أما التخلف فهو المعلم الثالث من معالم الواقع المعاصر في العالم الإسلامي، والذي تناوله الشهيد الصدر بالدراسة والتحليل. وقد تحدث مطولاً عن المعركة ضد التخلف وشروط نجاحها.
ودرس الشهيد الصدر (الواقع المحلي)، ونقصد به العراق، الذي لم يكن يختلف عن غيره من (مجتمعات العالم الإسلامي التي تشكو من أعراض التخلف والتمزق والضياع وتعاني من الوان الضعف النفسي)[13].
وإذا كان قد قدر للشهيد الصدر أن يطل على الواقع العالمي والإسلامي والعراقي بفهم معمق لأوضاع هذا الواقع، وطبيعة صلته بالإسلام، فإن الشهيد أطل على هذا الواقع بفهم متميز للإسلام أيضاً.
كان الشهيد الصدر عالماً دينياً وفقيهاً إسلامياً، ولكنه لم يكن كغيره من العلماء والفقهاء الذين سبقوه، أو الذين عاصرهم. وكانت نقطة الإختلاف المركزية بينه وبينهم تكمن في طريقة فهمه وعرضه للإسلام. فقد فهم الشهيد الإسلام باعتباره (مشروعاً حضارياً شاملاً ومتكاملاً).
وقد ميز بين صورتين للإسلام هما: الصورة الكاملة، والصورة المحدودة، بإعتبار أن الصورة المحدودة، هي الصورة التشريعية التي تعطى في حالة فرد متدين يعني شخصياً بتطبيق سلوكه وعلاقاته مع الآخرين على أساس الإسلام مع كونه يعيش ضمن مجتمع لا يتبنى الإسلام نظاماً في الحياة، في حين أن الصورة الكاملة هي الصورة التشريعية التي تعطى في حالة مجتمع كامل يراد بناء وجوده على أساس الإسلام وإقامة إقتصاده وخلافته في الأرض على ضوء شريعة السماء [14]وقد اعتبر أن أكثر الرسائل العملية التي كتبها الفقهاء تقدم الصورة المحدودة لأنها تتعامل مع فرد متدين يريد أن يطبق سلوكه على الشريعة رغم تواجده في مجتمع غير ملتزم بالإسلام منهجاً للحياة[15] أما السيد الصدر فقد سعى إلى تقديم (الصورة الكاملة للإسلام)، بإعتباره مبدأ كاملاً، (لأنه يتكون من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظام إجتماعي شامل لأوجه الحياة، ويفي بأمس وأهم حاجتين للبشرية، وهما القاعدة الفكرية والنظام الإجتماعي) [16].
ولعل من الأمور المهمة التي تميز فهم السيد الصدر للإسلام هو تفسيره الحضاري لأصول الدين الخمسة، أي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وقد لخص رؤيته الحضارية هذه بقوله: (إن أصول الدين الخمسة، التي تمثل على الصعيد العقائدي جوهر الإسلام والمحتوى الأساسي لرسالة السماء، هي، في نفس الوقت، تمثل، بأوجهها الإجتماعية على صعيد الثورة الإجتماعية، التي قادها الأنبياء، الصورة المتكاملة لأسس هذه الثورة، وترسم للمسيرة البشرية معالم خلافتها العامة على الأرض)[17].
وقد شرح في أماكن متفرقة من كتاباته الأخيرة، التي جمعت لاحقاً في كتاب حمل اسم (الإسلام يقود الحياة)، بعضاً من المحتوى الحضاري والإجتماعي لأصول الدين.
فالتوحيد هو جوهر العقيدة الإسلامية، وبالتوحيد يحرر الإسلام الإنسان من عبودية غير الله، ويرفض كل أشكال الألوهية المزيفة على مر التاريخ، وبذلك يحطم كل القيود المصطنعة والحواجز التاريخية التي تعوق تقدم الإنسان[18]. والتوحيد هو الذي يقدم للإنسان الرؤية الواضحة فكرياً و(أيديولوجياً)، ويجمع ويعبئ كل الطموحات وكل الغايات في مثل أعلى واحد، هو الله سبحانه وتعالى[19].
والعدل، رغم أنه من صفات الله، إلا أنه فصل عنها (لميزة إجتماعية)، لأن العدل هو الصفة التي تعطي للمسيرة الإجتماعية، وهي التي تغنيها[20]. لأن العدل في المسيرة، وقيامها على أساس القسط هو الشرط الأساسي لنمو كل القيم الخيرة الأخرى، وبدون العدل والقسط يفقد المجتمع المناخ الضروري لتحرك تلك القيم وبروز الإمكانات الخيرة[21]. وينطبق الأمر نفسه على باقي أصول الدين، التي سعى الشهيد الصدر إلى بيان أبعادها الحضارية والإجتماعية. من خلال هذا الفهم، قدم الإمام الشهيد المشروع الحضاري الإسلامي، باعتباره طريق الخلاصة للأمة الإسلامية، والبشرية، معاً:
(إن الإسلام هو طريق الخلاص، وأن النظام الإسلامي هو الإطار الطبيعي الذي يجب أن تحقق (الأمة) حياتها وتفجر طاقاتها ضمنه وتنشيء كيانها على أساسه.
فالأمة على الصعيد الإسلامي ـ وهي تعيش جهادها الشامل ضد تخلفها وانهيارها وتحاول التحرك السياسي والإجتماعي نحو وجود أفضل وكيان أرسخ واقتصاد أغنى وأرفه ـ سوف لن تجد أمامها عقيب سلسلة من محاولات الخطأ والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك وهو التحرك في الخط الإسلامي، ولن تجد إطاراً تضع ضمنه حلولها لمشاكل التخلف الإقتصادي سوى إطار النظام الإقتصادي في الإسلام.
والإنسانية على الصعيد البشري وهي تقاسي أشد ألوان القلق والتذبذب بين تيارين عالميين ملغمين بقنابل الذرة والصواريخ ووسائل الدمار لن تجد لها خلاصاً إلا على الباب الوحيد الذي بقي مفتوحاً من أبواب السماء وهو الإسلام)[22].
2ـ مقدمات نظرية
أولاً ـ الإنسان:
الإنسان هو موضوع المشروع الحضاري الإسلامي، ومحوره المركزي، ولا مبالغة في هذا إذا تذكرنا أن الحضارة هي في التحليل الأخير حصيلة تفاعل الإنسان مع الطبيعة (فالإنسان والمادة يتفاعلان علي مر الزمن)[23] ، وقد حرص الشهيد الصدر على توضيح دور الإنسان وموقعه في المشروع الحضاري، فالإنسان في دوافعه الذاتية أو غريزة حب الذات، التي قال عنها الشهيد الصدر إنها (أقدم) غرائز الإنسان (فكل الغرائز فروع هذه الغريزة وشعبها)[24]. والدافع الذاتي، الذي هو مثار المشكلة الإجتماعية، ينبع من حب الإنسان لذاته[25]. وهذا هو الجانب الأول لدور (الفطرة) في المشكلة الإجتماعية والحضارية، فهي تملي على الإنسان دوافعه الذاتية[26].
إلا أن الفطرة لا تلعب دور توفير مقومات المشكلة الإجتماعية واسبابها، وإنما تزود الإنسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التدين، وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الذي يوفق بين المصالح الذاتية والمصالح العامة. وبهذا تؤدي الفطرة دورها في (هداية الإنسان إلى كماله)[27]. وهذا هو الجانب الثاني لدور (الفطرة) في المشروع الحضاري. ومن هنا قلنا، في مناسبة سابقة، أن الفطرة من ركائز المشروع الحضاري الإسلامي[28].
ولهذا قرر الشهيد الصدر أن الإسلام يتوجه إلى الإنسان أولاً في تحقيق مشروعه الحضاري وتطبيقه، وقد رأى أن هناك سبيلين أمام العالم لحل مشكلة الإنسان، أحدهما أن يبدل الإنسان غير الإنسان، وهذا افتراض خيالي، أو أن يطور المفهوم المادي عند الإنسان عن الحياة، وبتطويره تتطور طبيعياً أهدافها ومقاييسها، وتتحقق المعجزة حينئذٍ من أيسر الطرق[29].
إذاً، فإن المشروع الحضاري الإسلامي يسعى إلى إيجاد (الإنسان الحضاري) الذي سيكون اللبنة الأولى في إقامة صرح هذا المشروع العظيم، من جهة، وسيكون هو أداة إنجازه وإقامته، من جهة ثانية.
ويتوصل المشروع الحضاري الإسلامي إلى إيجاد الإنسان الحضاري، باتباع أسلوبين، هما:
ـ الأسلوب الأول: تركيز التفسير الواقعي للحياة، وإشاعة فهمها في لونها الصحيح، كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية.
ـ الأسلوب الثاني: التعهد بتربية أخلاقية خاصة، تعني بتغذية الإنسان روحياً، وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه[30].
ثانياً ـ المثل الأعلی:
وإذا كان الإنسان هو العنصر الأول في المشروع الحضاري، هدفاً وموضوعاً وأداة، فإن الإنسان لا يمارس دوره الحضاري إلا على أساس مثل أعلى.
إن كل حركة حضارية إنما تتم من أجل الوصول إلى غاية تتجه نحو تحقيقها، وتستمد هذه الحركة الحضارية وقودها وزخم اندفاعها من تلك الغاية التي تسير نحوها[31]. وهذه الغاية أو الهدف هي المثل الأعلى للحركة الحضارية، أي للإنسان في حركته الحضارية. وهو المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي للإنسانية[32].
وإنما تتفاوت الحركات الحضارية وتختلف البنى الحضارية، تبعاً لاختلاف مثلها العليا، والمثل العليا على ثلاثة أنواع، هي:
المثل الأعلى التكراري، الذي يستمد من الواقع نفسه، ويكون منتزعاً من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من ظروف وملابسات.
والمثل الأعلى المحدود، الذي يكون منتزعاً من تصور أو تطلع محدود للمستقبل.
وأخيراً المثل الأعلى المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى[33].
والمشروع الحضاري الإسلامي يطرح الله، سبحانه وتعالى، باعتباره المثل الأعلى للمسيرة الحضارية، والهدف الوحيد الذي يضمن للتحرك الحضاري للإنسان أن يواصل سيره وإشعاعه باستمرار، باعتباره الهدف الذي كلما اقترب منه الإنسان، كلما اكتشف آفاقاً جديدة وامتدادات غير منظورة تزيد الجذور اتقاداً والحركة نشاطاً والتطور إبداعاً[34].
إن المسيرة الحضارية للإنسان في ظل المشروع الحضاري الإسلامي ليست مرتبطة بمثل عليا تكرارية أو محدودة، تعيق نموها وتكاملها، وإنما هي مرتبطة، في المصدر وفي المصير، بالله سبحانه وتعالى، وهو مثل أعلى مطلق، لا يستطيع الإنسان المحدود أن يصل إليه، أو يحيط به، أو يتجاوزه، الأمر الذي يمد (الحركة الحضارية للإنسان بوقود لا ينفد)[35].
وهذا هو الفارق الجوهري بين المشروع الحضاري الإسلامي، وكل (المشروعات الحضارية) الأخرى. إن المشروع الحضاري الإسلامي رباني المصدر والهدف والمضمون والمصير، بينما المشروعات الأخرى أرضية وضعية، مصدراً وهدفاً ومضموناً ومصيراً.
إن المشروع الحضاري الإسلامي صيغة رباعية للعلاقات الإجتماعية، وهي رباعية لأنها مؤلفة من أربعة أطراف، هم: الإنسان، وأخوة الإنسان، والطبيعة، والله سبحانه وتعالى.
أما المشروعات الحضارية الوضعية فهي صيغة ثلاثية للعلاقات الإجتماعية. وأطرافها هم: الإنسان، وأخوة الإنسان، والطبيعة[36]. وفي غالب الأحيان تتطور هذه الصيغة لتفرض نظاماً إستكبارياً وحضارة (جاهلية)، تتركز فيها السلطة والثروة بيد أقلية (فرد، أو عائلة، أو نظام، أو حزب) في مقابل الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع[37].
ثالثاً ـ الحركة التكاملية:
الإنسان هو محور المشروع الحضاري، والمثل الأعلى هو محور حركة الإنسان الحضارية.
ويبقى أن نعرف أن الإنسان (والمجتمعات الإنسانية بصورة عامة) منخرطة في مسيرة تاريخية كبرى. فالأصل في الوجود التاريخي للإنسان أنه متحرك، أو سائر، والشذوذ فيه الجمود والسكون، وهذه فكرة أساسية يبرزها الشهيد الصدر في عرضه لفلسفته الإجتماعية والتاريخية.
وهو يستند في إثبات هذه الفكرة إلى قوله تعالى:
(يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه). [الإنشقاق/ 56].
ومن خلال هذه الآية يلقي الشهيد الصدر أضواء كاشفة على حقيقة وطبيعة هذه المسيرة الإنسانية التاريخية الحضارية. فهذه المسيرة هادفة، وليست عشوائية أو بلا غاية. والهدف هو الله سبحانه وتعالى: (فالإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله سبحانه وتعالى)[38]. وهي مسيرة تكاملية وارتقائية: (فالإنسانية حينما تكدح نحو الله فإنما هي تتسلق إلى قمم كمالها وتكاملها وتطورها إلى الأفضل باستمرار)[39]. وهذا السير التكاملي نحو الله سبحانه يفترض طريقاً إليه[40]، وهذا الطريق هو المشروع الحضاري الإسلامي نفسه. فهو الصيغة الإجتماعية والإطار الحضاري اللذان تتوفر من خلالهما كل متطلبات التكامل الإنساني وكل مستلزمات المسيرة التصاعدية نحو الله سبحانه وتعالى. وهذه فكرة مهمة، داخلة في صميم (الإستراتيجية) الحضارية للإسلام. فالإسلام ـ من خلال التوحيد ـ يحطم كل القيود المصطنعة والحواجز التاريخية التي تعوق تقدم الإنسان وكدحه إلى ربه وسيره الحثيث نحوه[41].
فالإسلام ليس منظومة تشريعات جامدة، إنما هو مشروع إلهي للتقدم والكمال الإنسانيين.
وقد قلنا من قبل أن الهدف المركزي للمشروع الحضاري الإسلامي هو التكامل[42].
رابعاً ـ المركب الحضاري:
يقيم الإسلام مشروعة الحضاري، أي تصميمه للحياة الإنسانية، على أساس (مركب حضاري). والمركب الحضاري هو العصب الرئيسي لأي مشروع حضاري، والمركب الحضاري هو الصيغة أو المعادلة التي يتم من خلالها الجمع بين العناصر الأولية الداخلة في عملية البناء الحضاري. وقد أشار الشهيد الصدر إلى أهمية المركب الحضاري في سياق حديثه عن المعركة الشاملة ضد التخلف، حيث قال: (فنحن حين نريد أن نوجد منهجاً أو إطاراً عاماً لبناء الأمة واستئصال جذور التخلف منها يجب أن نفتش عن مركب حضاري قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف)[43].
والمركب الحضاري الذي يعتمده الإسلام هو: (الخلافة)، أي استخلاف الإنسان من قبل الله على الأرض، وذلك بناء على قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها) [البقرة: 30 ـ 31].
وصيغة الإستخلاف تتألف من مستخلف (بكسر اللام) وهو الله سبحانه وتعالى، ومستخلف (بفتح اللام) وهو الإنسان، ومستخلف عليه (وهو الطبيعة أو الأرض).
ويعني مفهوم الإستخلاف أن الإنسان قد أعطي مهمة قيادة الكون وإعماره طبيعياً واجتماعياً [44]، على أساس القواعد والمبادئ التي وضعها المستخلف، أي الله سبحانه وتعالى[45]، والتي تحقق أفضل صيغ التفاعل بين البشرية والطبيعة، من جهة، وبين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة ثانية، الأمر الذي يتكفل، بالتالي، توظيف عناصر الطاقة الحضارية الخمسة (الإنسان، الطبيعة الزمن، العلم، العمل) توظيفاً إيجابياً أمثل في عملية البناء الحضاري التي كلف الإنسان القيام بها وإنجازها في الأرض على أساس المشروع الحضاري الإسلامي.
ويقوم مركب (الخلافة الربانية) على أساس أربع ركائز هي:
1ـ إنتماء الجماعة البشرية إلى محور واحد، وهو الله سبحانه وتعالى [46]، حيث تتجاوز الجماعات البشرية كل (محاور) التجمع الأخرى، وتتوحد حول الله سبحانه وتعالى، لبناء أمة جديدة موحدة، وإقامة حضارة جديدة واحدة. وبهذا الصدد يتساءل القرآن الكريم: (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟) [يوسف /39]. بما يعني أن توحيد المحور بالله أفضل بالنسبة للبناء الحضاري من المحاور المتعددة. وتبدو هذه الأفضلية، بصورتها الجلية، بحماية الجماعة البشرية من التفكك إلى مجموعات لغوية، أو إثنية، أو طبقية، أو قبلية، أو طائفية، أو حتى دينية، لا يستطيع التواصل بينها، أو التوالد، بالمعنى الإجتماعي، على إعتبار أن الإيمان بالله الواحد، يشكل القاسم المشترك الأعظم للمجموعات البشرية. إن توحيد الجماعة البشرية، على أساس هذا المركب الحضاري، من شأنه أن يحفظ الطاقة الحضارية للجماعة، ويصونها من الهدر والضياع والتشتت في عمليات حضارية مفرقة، لا تجمعها استراتيجية واحدة، بل ربما فرقت فيما بينها أوضاع تصارعية هدامة.
2ـ إقامة الحياة الإنسانية على أساس العبودية المخلصة لله وتحرير الإنسان من مختلف أنواع العبوديات لغيره[47]. فالناس كلهم أحرار في إطار هذا المركب الحضاري، بلحاظ بعضهم البعض، من خلال كونهم، جميعاً، عباد الله، بلحاظ علاقتهم مجتمعين، بالله سبحانه وتعالى. والعبودية لله هي المعادل الموضوعي، بل الشرط الموضوعي، للحرية الإنسانية، حيث لا يمكن تحرير الإنسان، تحريراً حقيقياً، خراج إطار العبودية لله، لأن خروج الإنسان من هذا الإطار يؤدي به، حتماً، وفور تجاوزه حدود العبودية لله، إلى الدخول في العبودية لغيره.
و (غير) الله هنا قد يكون إنساناً آخر، تفر عن على بين جنسه وقومه، وقد يكون أصناماً لا تعقل وقد يكون غير ذلك.
3ـ تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات الإجتماعية، بعد محو ألوان الإستغلال والتسليط، فما دام الله سبحانه وتعالى واحداً، ولا سيادة إلا له، والناس جميعاً عباده، ومتساوون بالنسبة إليه، فمن الطبيعي أن يكونوا أخوة متكافئين في الكرامة الإنسانية والحقوق[48].
4ـ المسؤولية والإحساس بالواجب ازاء المستخلف. فالخلافة الربانية استئمان على الكون والطبيعة والبشر، ولهذا وصفها القرآن الكريم في إحدى آياته بالأمانة[49]. فالإنسان الخليفة مؤتمن، وكذلك مجتمع الخلافة. وجوهر الأمانة هو رعاية تلك القيم الخيرة التي ينطوي عليها المشروع الحضاري الإسلامي. والجماعة البشرية غير مخولة بأن تحكم بهواها أو باجتهادها المنفصل عن توجيه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يتنافى مع طبيعة الإستخلاف، وإنما تحكم بالحق، وتؤدي إلى الله أمانته بتطبيق أحكامه على عباده وبلاده[50].
وقد أبرز الشهيد الصدر البعد الحضاري لمفهوم الخلافة، بقوله:
(إن الخلافة الربانية للجماعة البشرية، وفقاً لركائزها المتقدمة، تقضي بطبيعتها على كل العوائق المصطنعة والقيود التي تجمد الطاقات البشرية وتهدر إمكانات الإنسان، وبهذا تصبح فرص النمو متوفرة توفراً حقيقياً (…) فالخلافة إذن حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقوة، وهي حركة لا تتوقف، لأنها متجهة نحو المطلق، وأي هدف آخر للحركة سوى المطلق ـ سوى الله سبحانه وتعالى ـ سوف يكون هدفاً محدوداً وبالتالي سوف يجمد الحركة ويوقف عملية النمو في خلافة الإنسان)[51].
وعلى أساس هذه (المقدمات النظرية) كان الشهيد الصدر يطرح تصوره للمشروع الحضاري الإسلامي، سواء في عناوينه العامة، أم في صورته أم هيكليته التفصيلية.
فعلى مستوى العناوين العامة، كان (الشهيد) يؤكد على مسألة (النمو والتنمية والتكامل والتقدم) في ظل المشروع الحضاري الإسلامي.
كما كان يؤكد على (العدالة) و(المساواة) اللتين تضمنان الحياة اللائقة بكرامة الإنسان وتحرارنه من الوقوع في قيود وأغلال الهموم المعيشية.
وكان يؤكد على (الحرية) بإعتبارها الشرط الضروري لمسيرة الكمال، وبإعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، مبيناً كيف يتصرف المشروع الحضاري الإسلامي لتحقيق هذه الحرية والحفاظ عليها.
وسوف نتناول هذه العناوين بشيء من التفصيل في الفقرة التالية.
3ـ الحرية والتقدم والعدالة
أولاً ـ الحرية:
اهتم الشهيد الصدر بمسألة الحرية، بمعنى نفي سيطرة الغير[52]، في وفت مبكر جداً.
وقد حرص على إثبات أن كلمة الحرية بمفهومها العام تشكل مصطلحاً إسلامياً أصيلاً ورد في نصوص إسلامية أصيلة لا يمكن أن تتأثر بمفاهيم الحضارة الغربية[53]. واستشهد لذلك، بنصين، الأول للإمام علي (ع) يقول فيه: (لا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حراً)[54]، والنص الثاني للإمام جعفر الصادق (ع)، يقول فيه: (خمس خصال من لم يكن فيه شيء منها لم يكن فيه كثير مستمتع: أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق، والخامسة ـ وهي تجمع هذه الخصال ـ الحرية) [55].
وفي سياق مقارنته للحرية في الإسلام والرأسمالية، بين (الشهيد) الخصائص التالية للحرية في المفهوم الإسلامي:
1ـ إن الحرية في الحضارة الإسلامية تعبير عن يقين مركزي ثابت (الإيمان بالله) تستمد منه الحرية ثوريتها، وبقدر ارتكاز هذا اليقين وعمق مدلوله في حياة الإنسان، تتضاعف الطاقات الثورية في تلك الحرية[56].
2ـ تحتفظ الحرية في الإسلام بالجانب الثوري منها، وتعمل على تحرير الإنسان من سيطرة الأصنام، كل الأصنام التي رزحت الإنسانية في قيودها عبر التاريخ، ولكنها تقيم عملية التحرير الكبرى هذه على أساس الإيمان بالعبودية المخلصة لله، ولله وحده. فعبودية الإنسان لله في الإسلام هي الأداة التي يحطم بها الإنسان كل سيطرة وكل عبودية أخرى، لأن هذه العبودية في معناها الرفيع تشعره بأنه يقف وسائر القوى الأخرى التي يعايشها على صعيد واحد، أمام رب واحد، فليس من حق أي قوة في الكون أن تتصرف في مصيره، وتتحكم في وجوده وحياته.
3ـ وليست الحرية في الإسلام (حقاً) للإنسان يستطيع أن يتنازل عنه متى شاء، إنما هي ترتبط إرتباطاً أساسياً بالعبودية لله، فلا يسمح الإسلام للإنسان أن يستذل ويستكين ويتنازل عن حريته (لا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حراً)، فالإنسان مسؤول عن حريته في الإسلام، وليست الحرية حالة من حالات انعدام المسؤولية[57].
وقد ميز السيد الصدر بين المدلول (الإيجابي) للحرية والمدلول (السلبي) لها، حيث تتبنى الرأسمالية المدلول الإيجابي الذي يعتبر (أن كل إنسان هو الذي يملك بحق نفسه، ويستطيع أن يتصرف فيها كما يحلو له دون أن يخضع في ذلك لأي سلطة خارجية)[58] في حين يعني الإسلام بالمدلول السلبي للحرية، وهو معطاها الثوري الذي يحرر الإنسان من سيطرة الآخرين ويكسر القيود والأغلال التي تكبل يديه. ويعتبر تحقيق هذا المدلول للحرية هدفاً من الأهداف الكبرى للرسالة السماوية بالذات: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [الأعراف/ 156]، على أن يستند ذلك إلى قاعدة التوحيد والإيمان بالعبودية المخلصة لله، الذي تتحطم بين يديه كل القوى الوثنية التي هدرت كرامة الإنسان على مر التاريخ[59].
وفي التفصيل شرح الشهيد الصدر (استراتيجية) الإسلام في تحرير الإنسان، سواء في (المجال الشخصي)، أم في (المجال الإجتماعي).
ففي المجال الشخصي يحرر الإسلام الإنسان من الداخل، على أساس أن يصبح قادراً على (أن يتحكم في طريقه ويحتفظ لإنسانيته بالرأي في تحديد الطريق ورسم معالمه واتجاهاته)[60]. وهذا يتوقف، بالدرجة الأولى، على تحرير الإنسان من (عبودية الشهوات)، على أساس ما زود من قدرة على التحكم بشهواته، حيث يمكن (سر حريته) في هذه القدرة.
وسمى الصدر هذه العملية (معركة التحرير في المحتوى الداخلي للإنسان، وهي في نفس الوقت الأساس الأول والرئيس لتحرير الإنسانية في نظر الإسلام، وبدونها تصبح كل حرية زيفاً وخداعاً، وبالتالي أسراً وقيداً)[61].
على الصعيد الإجتماعي يخوض الإسلام معركة الحرية من خلال تحطيم الأصنام الإجتماعية في نطاق العلاقات المتبادلة بين الأفراد، ويحرر الإنسان من عبوديتها، ويقضي على عبادة الإنسان للإنسان: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) 3 ـ 64 فلا توجد أمة لها الحق في استعمار أمة أخرى واستعبادها، ولا فئة من المجتمع يباح لها اغتصاب فئة أخرى ولا انتهاك حريتها، ولا إنسان يحق له أن ينصب نفسه ضمناً للآخرين[62]. وينعكس هذا التحرير على المستوى السياسي، والإقتصادي، والفكري، على تفصيل آثرنا تركه إلى فرصة أخرى[63].
ثانياً ـ التقدم والنمو والكمال:
هذه من المفردات التي ترد كثيراً في كتابات الشهيد الصدر. فقد آمن (السيد) بالمسيرة التكاملية للإنسان، وبقدرته على تحقيق التقدم الفردي والإجتماعي بأقصى درجاته.
والنمو الحقيقي في مفهوم الإسلام ـ كما طرحه السيد الصدر ـ يعني (أن يحقق الإنسان الخليفة على الأرض في ذاته تلك القيم التي يؤمن بتوحيدها جميعاً في الله عز وجل)[64].
وبهذا التعريف المبدع يحول السيد الصدر (صفات الله)، وهي من مسائل العقيدة، إلى منظومة قيم حضارية ومؤشرات للسلوك الحضاري للجماعة البشرية: (فصفات الله وأخلاقه من العدل والعلم والقدرة والرحمة بالمستضعفين والإنتقام من الجبارين والجور الذي لا حد له هي مؤشرات للسلوك في مجتمع الخلافة وأهداف للإنسان الخليفة)[65].
وليست المسيرة التكاملية للإنسان افتراضاً نظرياً، أو دعوة أخلاقية بل إنها (واقع موضوعي ثابت)[66]. فالآية القرآنية الكريمة تقول: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) [الإنشقاق/6] ويتناولها السيد الصدر قائلاً: (أن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد فهو تقدم وسير نحو الله سبحانه وتعالى)[67].
غير أن السيد الصدر يميز بين نوعين من التقدم، التقدم المسؤول، والتقدم غير المسؤول.
فأما التقدم المسؤول فهو تلك الحركة المنطوية على الوعي بمثلها المطلق، وبهذا يغدو هذا النوع من التقدم (عبادة). وحين يكون التقدم منفصلاً عن الوعي فهو تقدم على أي حال[68].
ويغدو من مسؤولية المشروع الحضاري الإسلامي أن يحطم كل القيود المصطنعة والحواجز التي تعود تقدم الإنسان وسيره التكاملي نحو الله.
كما يكون من مسؤولية الجماعة التي تتحمل مسؤولية الخلافة ـ أي الحكم ـ أن توفر لهذه الحركة التقدمية نحو هدفها المطلق الكبير (كل الشروط الموضوعية وتحقق لها مناخها الملاءم)[69].
ثالثاً ـ العدالة:
حرص الشهيد الصدر على إبراز قيمة (العدل) في المشروع الحضاري الإسلامي انطلاقاً من أنه الأصل الثاني من أصول الدين، كما بينا في الفقرات السابقة، وفي حديثه عن مهام الدولة الإسلامية، المعنية أساساً بتطبيق المشروع الحضاري الإسلامي، قال أن عليها (تجسيد روح الإسلام بإقامة مبادئ الضمان الإجتماعي والتوازن الإجتماعي والقضاء على الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير حد أدنى كريم لكل مواطن وإعادة توزيع الثروة بالأساليب المشروعة وبالطريقة التي تحقق هذه المبادئ الإسلامية للعدالة الإجتماعية)[70].
واعتبر الشهيد الصدر (العدالة الإجتماعية) الركن الثالث من أركان الإقتصاد الإسلامي، موضحاً أن الإسلام حينما تبنى العدالة الإجتماعية لم يتبنها بمفهومها التجريدي العام، ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير، ولا أوكلها إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة الإجتماعية، بإختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة، وإنما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره في مخطط إجتماعي ميعن. والصورة الإسلامية للعدالة الإجتماعية تحتوي على مبدأين عامين أحدهما: مبدأ التكافل العام، والآخر: مبدأ التوازن الإجتماعي[71].
4ـ الدولة والمجتمع والإقتصاد
ليس المشروع الحضاري الإسلامي مجرد مبادئ عامة أو شعارات عريضة، بل هو إضافة إلى ذلك تصميم واضح ومحدد للحياة الإنسانية. إن المشروع الحضاري الإسلامي مخطط إلهي لبناء حضارة من طراز خاص. والحضارة تعنى (طريقة الحياة التي يتبناها الإنسان والمجتمع).
وبالتالي، فإن المشروع الحضاري الإسلامي يحدد الطريقة التي يريد من الإنسان أن يتبعها في حياته وعلاقاته ونظمه… الخ. على هذا الأساس، لم يكتف الشهيد الصدر ببيان الخطوط العامة والمبادئ الأساسية للمشروع الحضاري الإسلامي، وإنما قام، وهو الفقيه المجدد، بوضع الصورة التفصيلية للمشروع الحضاري الإسلامي، أو بتعبير أدق وضع الصورة التفصيلية للحياة الإنسانية في ظل هذا المشروع.
إن المشروع الحضاري الإسلامي عنوان عام، يتفرع منه (المشروع السياسي) و(المشروع الإجتماعي) و(المشروع الإقتصادي). وقد فصل الإمام الشهيد معالم المشروع الإسلام في هذه المجالات، التي سنتعرض لها في الفقرات التالية.
أولاً ـ البعد السياسي للمشروع الحضاري الإسلامي:
تشكل (الدولة الإسلامية) الفقرة الأساسية في العبد السياسي للمشروع الحضاري الإسلامي. والدولة الإسلامية عند السيد الصدر (ضرورة حضارية) فضلاً عن كونها (ضرورة شرعية). وتكمن الضرورة الحضارية للدولة الإسلامية، بصورة أساسية، في كونها (المنهج الوحيد الذي يمكنه تفجير طاقات الإنسان في العالم الإسلامي والإرتفاع به إلى مركز الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية وإنقاذه مما يعانيه من ألوان التشتت والتبعية والضياع)[72].
وقد شرح الشهيد الصدر الضرورة الحضارية للدولة الإسلامية من زاويتين، هما: أولاً، التركيب العقائدي للدولة الإسلامية؛ وثانياً، تركيب الفرد المسلم في واقعنا المعاصر.
بالنسبة للزاوية الأولى أورد السيد الشهيد النقاط التالية:
ـ أولاً: أن الدولة الإسلامية تطرح هدفاً أعلى للتحرك الحضاري الإنساني يضمن له أن يواصل سيره وإشعاعه وجذوته باستمرار، وهذا الهدف هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان التركيب العقائدي للدولة الإسلامية، القائم على أساس الإيمان بالله وصفاته، وهو التركيب العقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية للإنسان بوقود لا ينفد[73].
ـ ثانياً: إن أخلاقية التركيب العقائدي للدولة الإسلامية تقوم بتحرير الإنسان من الإنشداد إلى الدنيا، وهو شرط مطلوب في أي مشروع حضاري، حيث يتحرر الإنسان من مغريات الأرض ويرتفع عن الهموم الصغيرة التي تفصله عن الله ويعيش من أجل الهموم الكبيرة[74].
ـ ثالثاً: إن المدلولات السياسية في التركيب العقائدي للدولة الإسلامية بدور عظيم في تنمية كل الطاقات الخيرة لدى الإنسان توظيفها لخدمة المسيرة الحضارية للإنسانية، حيث تهيء الدولة المناخ المناسب للنمو والإبداع لكل إنسان بقطع النظر عن عرقه ونسبه ومركزه وماله[75].
أما من زاوية تركيب الفرد المسلم في واقعنا المعاصر، فقد برهن السيد الصدر على الضرورة الحضارية للدولة الإسلامية على أساس أن الدولة الإسلامية قادرة على توفير المركب الحضاري القادر على تحريك الأمة المسلمة وتعبئة كل قواها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف، وبالتالي في المعركة الحضارية الشاملة[76].
وقد وضع الشهيد الصدر صورة تفصيلية لهيكلية الدولة الإسلامية وأهدافها ومهامها، وذلك في (الأسس) الأربعة والثلاثين التي كتبها في أوائل الستينات. ويبدو أن هذه الأسس مفوقدة الآن ما عدا الأسس الإحد عشر الأول. وقد اتيح لي قراءة الأسس بكامها منذ زمن بعيد. ويقوم الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية على أساس المزج بين (ولاية الفقيه) و(شورى الأمة)، حيث وزع الإسلام في عصر الغيبة الكبرى مسؤوليات الحكم بين المرجع والأمة، بين الإجتهاد الشرعي والشورى الزمنية[77].
وحين قامت الثورة الإسلامية في إيران كتب الإمام الشهيد (لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران) بين فيه المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الإسلامية وأهدافها الحضارية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، حيث ذكر أن الهدف الأول للدولة هو (تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة)[78] ، وهي المسألة الأساسية في بيان المهمة الحضارية للدولة الإسلامية، أو بعبارة أدق لبيان العلاقة العضوية بين الدولة الإسلامية والمشروع الحضاري الإسلامي، حيث أن الدولة الإسلامية هي المسؤولة عن تطبيق هذا المشروع الحضاري، بل من المتعذر تطبيق المشروع الحضاري الإسلامي بكامل أبعاده بدون قيام دولة إسلامية، بوذا، فإن إقامة الدولة الإسلامية ليست ضرورة سياسية فحسب، وإنما (ضرورة حضارية) كما قال الشهيد الصدر.
ثانياً ـ البعد الإجتماعي للمشروع الحضاري الإسلامي:
المشروع الحضاري الإسلامي مخطط رباني لبناء مجتمع إسلامي، والمجتمع، في تصور السيد الصدر، يتألف من ثلاثة عناصر هي:
ـ أولاً: الإنسان.
ـ ثانياً: الطبيعة.
ـ ثالثاً: شبكة العلاقات التي تنظم الحياة الإجتماعية، وهذه تكون على نوعين، هما:
1ـ علاقة الإنسان بالإنسان.
2ـ علاقة الإنسان بالطبيعة[79].
وإذا كانت المجتمعات تتفق في عنصريها الأول والثاني (وهما العنصران الثابتان)، فإن هذه المجتمعات تختلف في العنصر الثالث أي (شبكة العلاقات).
وقد بين الشهيد الصدر أن هناك صيغتين للعلاقات الإجتماعية، إحداهما الصيغة الثلاثية، والأخرى الصيغة الرباعية. فأما الصيغة الثلاثية فتتألف من (الإنسان + الإنسان + الطبيعة) في حين أن الصيغة الرباعية تتألف من (الإنسان + الإنسان + الطبيعة + الله). وهذه الصيغة الرباعية، التي يسميها القرآن الكريم بالإستخلاف، هي التي ينشأ بموجبها المجتمع الإسلامي[80].
إذن، فإن المجتمع الإسلامي الذي يسعى المشروع الحضاري الإسلامي إلى إقامته هو مجتمع الخلافة الربانية، وبالتالي هو المجتمع الذي تتجسد فيه الركائز الأربعة للحلافة الربانية التي شرحناها في الصفحات المتقدمة.
وبين الشهيد الصدر أن (أرضية) المجتمع الإسلامي تتكون من ثلاثة عناصر هي[81]:
ـ أولاً: العقيدة، وهي القاعدة المركزية في التفكير الإسلامي، والتي تحدد نظرة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة.
وتتألف العقيدة من منظومة أصول الدين الخمسة، التي عرضنا تصور الشهيد الصدر لمدلولاتها الإجتماعية والحضارية في الصفحات السابقة.
ـ ثانياً: المفاهيم التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء، على ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة.
ـ ثالثاً: العواطف والأحاسيس التي يتبنى الإسلام بثها وتنميتها إلى جانب تلك المفاهيم، لأن المفهوم ـ بصفته فكرة إسلامية عن واقع معين ـ يفجر في نفس المسلم شعوراً خاصاً تجاه ذلك الواقع، ويحدد إتجاهه العاطفي نحوه. فالعواطف الإسلامية وليدة المفاهيم الإسلامية، والمفاهيم الإسلامية موضوعة بدورها في ضوء العقيدة الإسلامية الأساسية.
ونشير هنا، إلى أن السيد الصدر كان ينوي بعد أن اصدر كتاب (فلسفتنا) أن يصدر كتاباً يحمل اسم (مجتمعنا) حيث كان من المقرر أن يتناول فيه (أفكار الإسلام عن الإنسان وحياته الإجتماعية، وطريقته في تحليل المركب الإجتماعي وتفسيره، لينتهي من ذلك إلى المرحلة الثالثة، إلى النظم الإسلامية للحياة التي تتصل بأفكار الإسلام الإجتماعية وترتكز على صرحه العقائدي الثابت)، ولكنه أجل اصدار (مجتمعنا) وأصدر (اقتصادنا) نزولاً عند (رغبة القراء الملحة) [82]، ولم يصدر (مجتمعنا) أبداً، لكن السيد الشهيد، عاد في أواخر عمره الشريف إلى طرح المسألة الإجتماعية عبر محاضراته الأخيرة، التي جمعت لاحقاً تحت عنوان: (التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية).
ثالثاً ـ البعد الإقتصادي للمشروع الحضاري الإسلامي:
اهتم السيد الشهيد اهتماماً بالغاً بالمسألة الإقتصادية على صعيدها النظري الإسلامي، فألف لهذا الغرض كتابه الضخم اقتصادنا، بجزأين، ثم كتب كراستين حول الموضوع هما: (صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي) و(خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي). ولا غرابة في ذلك، فقد كان من أهم التحديات التي واجهت الفكر الإسلامي المعاصر هي مدى قدرته على تقديم نموذج اقتصادي قادر على إدارة الحياة الإقتصادية للمجتمع، وتنظيمها، وتحقيق الآمال المنشودة في القضاء على التخلف الإقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه العام.
وقد قدم الشهيد الصدر صورة واضحة المعالم محددة التفاصيل للإقتصاد الإسلامي، أي العبد الإقتصادي للمشروع الحضاري الإسلامي، على مستوى المبادئ والنظريات، وعلى مستوى الأحكام والتشريعات تضمنت، فيما تضمنت، الهيكل العام للإقتصاد الإسلامي المؤلف من ثلاثة أركان هي:
1 ـ مبدأ الملكية المزدوجة.
2 ـ مبدأ الحرية الإقتصادية في نطاق محدود.
3 ـ مبدأ العدالة الإجتماعية[83].
وعلى مستوى التشريعات الإقتصادية شرح الشهيد الصدر نظرية وأحكام التوزيع ما قبل الإنتاج، ونظرية وأحكام التوزيع ما بعد الإنتاج.
وفي سياق شرحه لنظرية الإنتاج في الإسلام، جسد الشهيد الصدر الرابطة العضوية بين أفكار المشروع الحضاري الإسلامي، وبين المسألة الإقتصادية، حين قال أن تنمية الثروة هي (هدف طريق لا هدف غاية، فليست الثروة هي الهدف الأصيل الذي تضعه السماء للإنسان الإسلامي على وجه الأرض، وإنما هي وسيلة يؤدي بها الإنسان الإسلامي دور الخلافة، ويستخدمها في سبيل تنمية جميع الطاقات البشرية والتسامي بإنسانية الإنسان في مجالاتها المعنوية والمادية)[84]
محمد عبد الجبار
[1] الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر؛ (فلسفتنا)، ص12 ـ 13. [صدر (فلسفتنا) في سنة 1379هـ]. العدد 62 ـ جمادي الثاني 1410هـ.
[2] الصدر؛ (الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية)، ص6 ـ 7. [صدر بتاريخ 1382هـ].
[3] المصدر السابق، ص 8 ـ 9.
[4] الصدر؛ (الفتاوي الواضحة)، ص706 ـ 707. [صدر بتاريخ 1396هـ].
[5] المصدر السابق، ص707. العدد 62 ـ جماد الثاني 1410هـ
[6] الصدر؛ (رسالتنا)، ص21.
[7] المصدر السابق، ص22.
[8] المصدر السابق، ص24.
[9] الصدر؛ (الإسلام يقود الحياة) ص215.
[10] رسالتنا، ص23.
[11] الإسلام يقود الحياة، ص20.العدد 62 ـ جماد الثاني 1410هـ
[12] الشهيد الصدر؛ (اقتصادنا)، ص9 [صدر بتاريخ 1381هـ].
[13] (الإسلام يقود الحياة)، ص13.
[14] المصدر السابق، ص75 ـ 76.
[15] المصدر السابق، ص78.
[16] السيد الصدر، (أسس الدولة الإسلامية)، الأساس الأول، منشور ضمن كتاب (مقالات إسلامية)، ص130.
[17] الإسلام يقود الحياة، ص52
[18] المصدر السابق، ص40.
[19] السيد الصدر؛ (التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية)، ص157 (وهو عبارة عن محاضرات القاها الشهيد سنة 1399هـ. وقام بتحقيقها وضبطها الشيخ جلال الدين على الصغير، ونشرها تحت العنوان أعلاه، عام 1989).
[20] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص157 ـ 158
[21] الإسلام يقود الحياة، ص160.
[22] اقتصادنا، ص7 ـ 8.
[23] الشهيد الصدر؛ (بحث حول المهدي)، ص86.
[24] الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية، ص67.
[25]اقتصادنا، ص324..
[26] المصدر السابق، ص327.
[27] المصدر السابق، ص327.
[28] راجع مقالنا: (موقع المرأة ودورها في المشروع الحضاري الإسلامي)، مجلة المنطلق، العدد60، ص19 ـ 45
[29] الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية، ص72.
[30] للتفصيل أقرأ: (الإنسان المعاصر)، ص79 ـ 82، والإسلام يقود الحياة، ص199 ـ 206.
[31] الإسلام يقود الحياة، ص199.
[32] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص119.
[33] للتفصيل، اقرأ المصدر السابق، ص121 ـ 140.
[34] الإسلام يقود الحياة، ص200.
[35] المصدر السابق، ص202.
[36] اقرأ: التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص106 وما بعدها.
[37] اقرأ كتابنا: (المجتمع)، ص26 ـ 27.
[38] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص142.
[39] المصدر السابق، ص142.
[40] المصدر السابق، ص143.
[41] الإسلام يوقد الحياة، ص40 ـ 41.
[42] راجع: المنطلق، العدد 60، ص24
[43] الإسلام يقود الحياة ص214، وإقتصادنا، ص13 ـ 14.
[44] الإسلام يقود الحياة، ص152.
[45] . المصدر السابق، ص154
[46] المصدر السابق، ص153
[47] المصدر السابق، ص153
[48] المصدر السابق، 153.
[49] كما في قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، واشفقن منها، وحملها الإنسان) [الأحزاب / 72].
[50] الإسلام يقود الحياة، ص154.
[51] المصدر السابق، ص159 ـ 160.
[52] الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية، ص88.
[53] المصدر السابق.
[54] الحديث في ميزان الحكمة، ج2، ص351، نقلاً عن بحار الأنوار، ونهج البلاغة.
[55] الحديث في ميزان الحكمة، ج2، ص350، نقلاً عن البحار
[56] الإنسان المعاصر، ص59.
[57] المصدر السابق، ص60.
[58] المصدر السابق، ص89.
[59] المصدر السابق، ص96.
[60] المصدر السابق، ص101
[61] المصدر السابق، ص103.
[62] المصدر السابق، ص106
[63] اقرأ: المصدر السابق، ص109 ـ 115، واقتصادنا: ص270 ـ 292.
[64] الإسلام يقود الحياة، ص159.
[65] الإسلام يقود الحياة، ص159.
[66] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص143
[67] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص143
[68] المصدر السابق، ص144، وأقرأ مقالنا: (نظرة إسلامية إلى مصطلح التقدم)، مجلة الوحدة الإسلامية، العدد 107، 9/ 12/ 1988، ص50 ـ 51.
[69] الإسلام يقود الحياة، ص160.
[70] المصدر السابق، ص26 ـ 27.
[71] اقتصادنا، ص303، وللتفصيل راجع الصفحات 697 ـ 720.
[72] الإسلام يقود الحياة، ص197.
[73] المصدر السابق، ص199 ـ 202.
[74] المصدر السابق، ص202 ـ 206
[75] المصدر السابق، ص207 ـ 212.
[76] للتفصيل أقرأ المصدر السابق، ص215 ـ 224.
[77] المصدر السابق، ص189
[78] المصدر السابق 26.
[79] التفسير الموضوعي والفلسفة الإجتماعية، ص105
[80] المصدر السابق، ص106 ـ 109.
[81] اقتصادنا، ص 309 ـ 310.
[82] اقتصادنا، ص27 (مقدمة الطبعة الأولى). اقتصادنا، ص27 (مقدمة الطبعة الأولى).
[83] اقتصادنا، ص290 ـ 307.
[84] اقتصادنا، ص671.