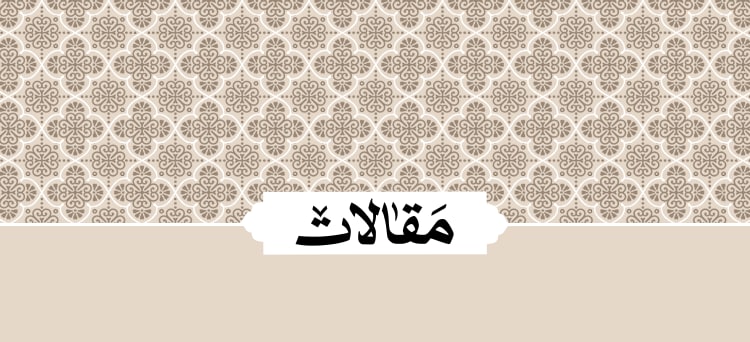بين يَدَي الآن الحلقة الاُولى من كتاب (دروس في علم الاُصول) تأليف الشهيد السعيد آية اللّه العظمى السيّد محمّد باقر الصدر قدّس سرّه، وقد أصدرها مجمع الفكر الإسلامي في قم، بتحقيق وتعليق العلاّمة الحجّة السيّد علي أكبر الحائري عام 1412 هـ ـ 1991 م. وهي تتألّف من 279 صفحة، وقد قدّم المحقّق الفاضل للكتاب ببحث نفيس ومستوعب شغل 84 صفحة من حجم الكتاب، وزّعه على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: وقد خصّصه للكلام على الحياة الشخصيّة للشهيد الصدر، فتحدّث عن ولادته ونشأته وهجرته إلى النجف الأشرف، وفاقته وزهده، وأخلاقه وعبادته، وزواجه وأولاده، واعتقالاته، واستشهاده.
القسم الثاني: تعرّض فيه لحياة الشهيد الصدر العلميّة، وتكلّم على دراسته، وخصائصه العلميّة، وعدّد منها: الشمول والعمق والنزعة العرفية والموضوعيّة في التفكير، ثمّ انتقل للكلام على إبداعاته الفكريّة في مجال الفلسفة وعلم الاُصول وعلم الفقه والفكر الإقتصادي، قبل أن يعرّج على بيان مؤلّفاته.
القسم الثالث : أفرده المحقّق للكلام على كتاب الحلقات (دروس في علم الاُصول) وتطرّق فيه لأسباب وضعه، ومنهجه الجديد، وبعض العقبات التي تحول دون فتح الطريق أمامه ليحلّ محلّ الكتب الاُصوليّة السابقة، والمصطلحات الحديثة فيه، وختمه ببيان عمله في تحقيق الكتاب، وأ نّه تضمّن تصحيح الأخطاء التي وقعت في طبعاته السابقة، وتخريج مصادر الأحاديث والأقوال الواردة فيه، وتعديل العناوين، وإضافة كلمات أو جمل بين عضادتين عند اقتضاء الضرورة، والإهتمام بالنواحي الفنيّة (وضع علامات الترقيم، وتقطيع النصّ، وتطبيق قواعد الإملاء الحديثة) وكتابة هوامش توضيحيّة على المتن.
والحقّ، أنّه جهدٌ مشكور تمخّض عن أفضل طبعة ظهرت لهذا الكتاب حتّى الآن، من ناحية ضبطها علميّاً، وجودة طباعتها، وسلامتها من السقط، وندرة الأخطاء الطباعيّة فيها، ولكن لي بعض الملاحظات أودّ تسجيلها على بعض ما أورده المحقّق في مقدّمته، قبل أن أنتقل إلى الكلام على متن الكتاب نفسه، وهي:
أولا ـ قوله: إنّ (نظريّة القرن الأكيد) هي من إبداعات السيّد الشهيد التي فسّر بها عملية الوضع في بحث الدلالة، مع أنّ المعروف أنّ هذه النظريّة من إبداع بافلوف، وقد قام هو نفسه بتطبيقها في مجال اللغة، كما ذكر ذلك السيّد الشهيد في كتاب إقتصادنا(1 / 54)، وإن كان السيّد قدسّ سرّه قد اعترض على الاستفادات الفلسفيّة منها لصالح الماديّة.
ثانياً ـ قال: إنّ (مسلك حقّ الطاعة) من إبداع السيّد الشهيد، وكان ينبغي الإشارة إلى أنّ لهذا المسلك جذراً في كلام الشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي، كما صرّح بذلك السيّد الشهيد نفسه على ما هو مسجّل في كتاب بحوث في علم الاُصول (5 / 25). نعم، قام السيّد الشهيد بتبنّي هذا المسلك وبلورته.
ثالثاً ـ ذكر أنّ للسيّد الشهيد اصطلاحاً خاصّاً في تنوين التنكير وتنوين التمكين يخالف به اصطلاح النحاة; فإنّ تنوين التنكير في اصطلاحهم هو «اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقاً بين معرفتها ونكرتها، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كصه ومه وإيه، وفي العلم المختوم بـ (ويهِ) بقياس، نحو: جاءني سيبويهِ وسيبويه آخر». وأمّا في اصطلاح الشهيد فهو التنوين الذي يلحق النكرة لإفادة قيد الوحدة. وأمّا تنوين التمكين فهو في اصطلاحهم «اللاحق للإسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله، وأ نّه لم يشبه الحرف فيُبنى ولا الفعل فيُمنع من الصرف كزيد ورجل»، وأمّا السيّد الشهيد فيقصد به التنوين اللاحق للإسم المتمكّن لا لإفادة قيد الوحدة، بل لمجرّد الإعلام ببقائه على التمكين، نحو : رجل خيرٌ من امرأة، قاصداً بذلك جنس الرجل.
هذا ما ذكره المحقّق. والواقع أ نّه ليس للسيّد الشهيد اصطلاح خاصّ مقابل النحاة، فلا بدّ من الوقوف عند هذه الدعوى وبيان الحقّ فيها، خاصّة وأنّ المحقّق لم يكتفِ بإيرادها في مقدّمة الحلقة الاُولى، بل أثبتها في حاشية الحلقة الثانية، ممّا يؤدّي إلى شيوعها بين الطلبة، فنقول:
إنّ تنوين التمكين في اصطلاحهم هو تنوين لفظي يؤتى به للدلالة على كون الإسم مُعرّباً، وليس مبنيّاً ولا ممنوعاً من الصرف، ولأجل ذلك فهو لا يفيد شيئاً آخر كقيد الوحدة مثلا، وهذا المعنى نفسه هو الذي صرّح به السيّد الشهيد بقوله : إنّ تنوين التمكين يؤتى به لإشباعِ حاجة الكلمة المعربة; لأنّها تستند إلى اللام في أوّلها أو إلى التنوين في آخرها، ولا تستقرّ مجرّدةً عن ذلك (بحوث في شرح العروة الوثقى 1 / 24). وعليه فدخول هذا التنوين على إسم الجنس لا يفيده معنى الوحدة، فيبقى دالاّ على الطبيعة، ويمكن أن يستفاد منه الشمول، كقوله تعالى: (قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يتبعها أذىً) (سورة البقرة ـ الآية: 263).
وأمّا تنوين التنكير، فهو تنوينٌ معنوي يفيد الكلمة الشيوع وعدم التعيين، ودخوله على الأسماء المذكورة (اسم الفعل والعلم المختوم بويه) فرقاً بين معرفتها ونكرتها، يكون من أفراد هذا التنوين وتطبيقاته، ولا يمنع من دخوله على غيرها; بدليل تصريحهم بدخوله على الممنوع من الصرف، تقول: رأيتُ أحمداً، بشرط أن تقصد واحداً غير معيّن ممّن اسمهم أحمد (مفصّل الزمخشري 9 / 29)، ودخوله أيضاً على الإسم المنصرف عَلَماً أو غير عَلَم لنكتة بلاغيّة تقتضي تنكيره، نحو: رأيتُ محمّداً من المحمّدين (النحو الوافي 1 / 264).
ولعلّ تمثيل السيّد الشهيد لتنوين التنكير بكلمة (رجل) و (عالم) وهما من الأسماء المعربة، هو الذي أدّى إلى ذهاب المحقّق إلى أنّ للسيّد الشهيد اصطلاحاً خاصّاً هنا; لأنّه يرى أنّ تنوين (رجل) وأمثاله هو تنوين تمكين ليس إلاّ، فتسميته بتنوين التنكير لا بدّ أن تكون باصطلاح جديد. ولكن بعض متقدّمي النحاة صرّح بأنّ تنوين (رجل) هو تنوين تنكير، وقد خالف في ذلك ابن الحاجب (شرح الكافية 1 / 13) وابن هشام (مغني اللبيب 2 / 340) محتجَّين بانّنا لو سميّنا بكلمة (رجل) شخصاً، بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير.
إلاّ أنّ رضيّ الدين الاسترآبادي قال في شرحه لكافية ابن الحاجب (1 / 13): «وأنا لا أرى منعاً في أن يكون تنوين واحدٌ للتمكن والتنكير معاً، فربّ حرف يفيد فائدتين، كالألف والواو في مسلمان ومسلمون، فنقول: التنوين في (رجل) يفيد التنكير أيضاً، فإذا سميّت بالاسم تمحض للتمكن».
أقول : وكذلك يتمحّض للتمكن في مثل قولنا : اكرم رجلا زارك بالأمس. ويبقى التنوين في مثل (جئني برجل، واكرم فقيراً) دالاّ على التمكين والتنكير معاً، قال الصبّان في حاشيته على شرح الأشموني (1 / 34): «وجوّز بعضهم كون تنوين المنكر للتمكين; لكون الاسم منصرفاً، وللتنكير; لكونه موضوعاً لشيء لا بعينه».
وقال السيّد علي خان بعد أن أورد رأي الرضي الاسترآبادي المتقدّم: وعلى هذا يكون تنوين التنكير المختصّ بالصوت واسم الفعل (والمختوم بويه) هو المتمحض للدلالة على التنكير كما قاله بعضهم (الحدائق النديّة في شرح الصمديّة ص 27).
وقد عبّر السيوطي عن تنوين التنكير بأنه الفارق بين النكرة وغيرها. (همع الهوامع1/ 10).
وعرّفه بعض المحدثين بأنه «الذي يلحق ـ في الأغلب ـ بعض الأسماء المبنيّة ليكون وجوده دليلا على أنها نكرة، وحذفه دليلا على أنها معرفة. (النحو الوافي 1 / 36)، ثمّ ذكر في حاشية الصفحة نفسها أنه قيّد (بالأغلب) لكون تنوين التنكير قد يلحق بعض الاسماء المعربة المنصرفة وغير المنصرفة، وأن تقييد الاسماء هنا بأنها (مبنيّة) غير صحيح.
ومن كل ما ذكرناه يتضح أن اصطلاح النحاة على أن تنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء للدلالة على الشيوع وإرادة فرد غير معيّن، أو على حدّ تعبير السيّد الشهيد هو التنوين الذي يجعل اسم الجنس مقيداً بقيد الوحدة، فلا يمكن أن ينطبق على اكثر من واحد، أيّ واحد. (الحلقة الثانية ص 106، بحوث في علم الاُصول 3 / 433)، فلا مخالفة في الاصطلاح.
وأمّا متن الكتاب، فقد تميّز بمنهجيّة مبتكرة للسيد الشهيد قدّس سرّه، إذ قسّم مادة الاُصول على النحو التالي:
1ـ بحوث تمهيدية، عرف فيها علم الاُصول، وأثبت جواز عملية الاستنباط، وعرّف الحكم الشرعيّ، وبيّن أقسامه.
2ـ الأدلة المحرزة، أي الكاشفة عن الحكم الشرعي، وقد نوّعها إلى شرعية وعقلية، وقسّم الشرعيّة منها إلى لفظيّة وغير لفظيّة.
3ـ الاُصول العملية، وهي لديه ثلاثة : البراءة والاحتياط والاستصحاب، بارجاعه ما يسمّى بأصالة التخيير إلى أصالة البراءة.
4ـ تعارض الأدلّة، وهو ثلاثة اقسام : التعارض بين الأدلة المحرزة، والتعارض بين الاُصول العملية، والتعارض بين الأدلة والاُصول.
ويُلاحظ عليه أنه لا يعقل وجود التعارض الأخير بين الأدلة والاُصول، ما دامت الاُصول في طول الأدلة المحرزة; إذ لا تصل النوبة إليها إلاّ بعد فقد الدليل المحرز قطعيّاً كان أو ظنيّاً.
كما أنه لا تعارض بين الاُصول العملية أيضاً، ما دام لكلّ منها مجاله الخاص الذي يجري فيه; فالبراءة تجري عند عدم العلم مطلقاً، والاحتياط يجري في مجال العلم الإجمالي، والاستصحاب يجري عند الشك المسبوق بالعلم. فكان الأولى قصر هذا البحث على تعارض الأدلة، وإيراده بعدها قبل الكلام على الاُصول العمليّة.
هذا مُضافاً إلى أ نّه من الأنسب تسمية هذا البحث بـ (علاقات الأدلة) وتقسيمها إلى: التخصيص والتقييد والورود والحكومة والتعارض; ذلك لأن التعارض واحد من العلاقات القائمة بين الأدلة، فلا مسوّغ لجعله عنواناً للبحث دونها.
هذا وقد بقي في متن الكتاب ما يزيد على ثلاثين خطأً لغوياً بحذف المتكرر منها، نرجو أن تتاح الفرصة للمحقّق لإصلاحها في الطبعة القادمة، ونسأل اللّه له التوفيق.
السيّد علي حسن مطر